من أوكرانيا إلى تايوان.. هل تنشب الحرب العالمية القادمة بسبب التجارة؟
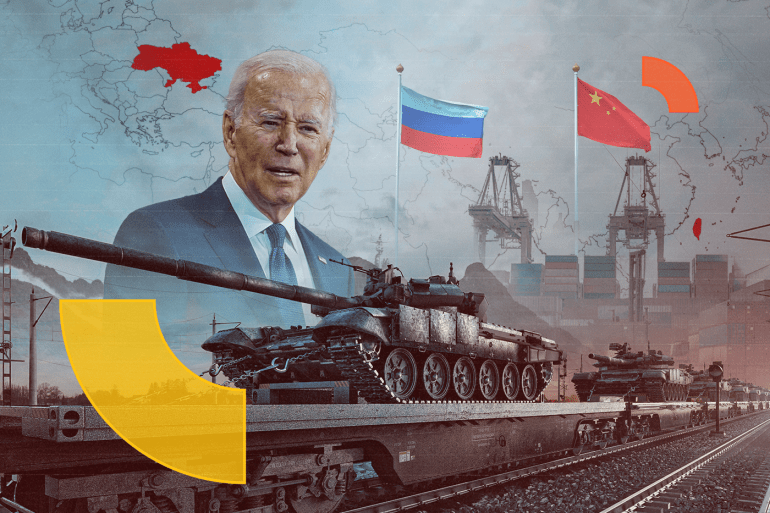
مقدمة الترجمة
لا يمكن إقامة علاقات تجارية على المستوى الدولي دون استبعاد خيار شن أعمال عدائية، لحماية هذه العلاقات التجارية أو تأمين الوصول إلى المواد الخام. هذا الاستنتاج كان محور تحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز"، وأعدَّه "ديل كوبلاند"، أستاذ العلاقات الدولية في قسم العلوم السياسية بجامعة فرجينيا.
نص الترجمة
خلال السنة الماضية، أُجبِرَت الولايات المتحدة على النظر في احتمالية اعتبرها الكثيرون غير واردة منذ الحرب الباردة: صراع عسكري كبير ضد قوة عظمى أخرى. وللمرة الأولى منذ عقود، استعرضت موسكو قوة صواريخها لتُحذِّر واشنطن من دعمها لأوكرانيا. وفي مطلع أغسطس/آب، وبعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي "نانسي بيلوسي" إلى تايوان، صعَّدت بكين بشدة من تهديداتها بتنفيذ عمل عسكري على الجزيرة. وبقدر ما تُعَدُّ هذه التهديدات مُروِّعة، فإن تأثيرها على الترابط الاقتصادي العالمي والسلام الناجم عنه مُروِّعة بالقدر ذاته.
تعتمد كلٌّ من الصين وروسيا، لدرجة استثنائية، على التجارة من أجل النمو الاقتصادي والحفاظ على وضعيهما على الساحة الدولية. وقد استطاعت الصين مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي خمسة أضعاف خلال العقدين الماضيين، من خلال تصدير المنتجات المصنعة إلى حدٍّ كبير، أما روسيا فتُشكِّل صادرات النفط والغاز أكثر من 50% من عائداتها الحكومية. وبحسب إحدى الأفكار المؤثرة في نظرية العلاقات الدولية، فبسبب هذه العلاقات الاقتصادية ستكون تكلفة الصراع العسكري أكبر بالنسبة لكلا البلدين. ولكن ظاهريا على الأقل، لا يبدو أن احتمالية خسارة مثل هذه التجارة تكبح أيًّا من القوتين عن التصعيد العسكري.

مع ذلك، فإن الصورة ليست بهذه البساطة كما يبدو. والسبب هو أنه في ظل ظروف معينة، قد تكون العلاقات التجارية بمنزلة محفز للحرب وليس رادعا لها. علاوة على ذلك، لا يرتبط دائما إثبات القوة العسكرية أو حتى التهديد بالمواجهة العدائية بانهيار العلاقات الاقتصادية. ومع تجلي الحالتين المتباينتين للصين وروسيا خلال السنة الماضية، فغالبا ما تتكشف العلاقات الاقتصادية بطرق تتحدى التوقعات. وبالنسبة لأولئك الذين يفترضون أن التجارة يمكنها المساعدة في كبح صراعٍ بين القوى العظمى؛ يُعَدُّ من الضروري دراسة الطرق المعقدة التي شكَّلت بها القوى الاقتصادية الفكر الإستراتيجي بالفعل في كلٍّ من بكين وموسكو.
لفهم كيف قد تزيد التجارة من فرص الصراع العسكري -لا أن تُقلِّلها- فمن الضروري الاستناد إلى رؤى النظرية الواقعية. تركز الواقعية عموما على كفاح القوى العظمى من أجل تفوق عسكري نسبي وخلق وضع لها في عالم يفتقر إلى سلطة مركزية. لكنَّ الواقعيين يفهمون أن القوة الاقتصادية هي أساس القوة العسكرية طويلة الأجل، وأن التجارة الدولية جوهرية لبناء قاعدة للقوة الاقتصادية. وبالنسبة للواقعيين، قد يكون للتجارة تأثيران أساسيان: أولهما توفير صلاحية الوصول إلى المواد الخام الرخيصة والأسواق المربحة، إذ إن التجارة يمكنها تعزيز الأداء الاقتصادي العام للدولة والتقدم التكنولوجي، ومن ثمَّ تحسين قدرتها على دعم القوة العسكرية على المدى الطويل. ويُعَدُّ ذلك من إيجابيات تبني سياسة تجارية منفتحة نسبيا، ما يفسر لماذا تخلصت كلٌّ من اليابان بعد فترة "إصلاح ميجي" (1868-1912) والصين بعد وفاة "ماو زيدونغ" من سياسات الماضي الفاشلة القائمة على الاكتفاء الذاتي، ثم سعتا إلى الانضمام إلى الاقتصاد العالمي.
بيد أن النمو التجاري له أيضا تأثير آخر، إذ إنه يرفع فرص تعرض القوة العظمى إلى العقوبات والحظر التجاري بعد أن أصبحت معتمدة على استيراد الموارد وتصدير السلع للبيع في الخارج، ما قد يدفع القادة لبناء الجيوش البحرية لحماية طرق التجارة وحتى الدخول في حرب لتأمين الوصول إلى السلع والسوق الحيوية. وما دام قادة الدولة يتوقعون أن تظل علاقاتهم التجارية قوية في المستقبل، فغالبا ما يسمحون للدولة بأن تصبح أكثر اعتمادا على الخارج فيما يخص الموارد والسوق التي تدفع النمو في البلاد. كان ذلك هو وضع اليابان بين عامي 1880-1930، وكذلك الصين منذ عام 1980 وحتى يومنا هذا، فقد أيقن القادة في البلدين أن دون علاقات تجارية وطيدة بقوى عظمى أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، لن تصبح أيٌّ منهما عضوا مهما في نادي القوى العظمى.
ومع ذلك، إذا ساءت توقعات مستقبل التجارة واتجه القادة للاعتقاد بأن القيود التجارية المفروضة من الدول الأخرى ستبدأ في الحد من وصولهم إلى الموارد والأسواق الرئيسية، فعندها يتوقعون انهيارا في القوة التجارية ومن ثم القوة العسكرية على المدى الطويل، وربما يعتقدون في أهمية المزيد من السياسات الحازمة والعدائية لحماية الطرق التجارية، وتأمين إمدادات المواد الخام، وإمكانية الوصول إلى الأسواق. كانت هذه هي الورطة التي وقعت فيها اليابان في ثلاثينيات القرن الماضي، حينما شهدت تراجع فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة نحو مجالات اقتصادية أكثر انغلاقا وتمييزا. ونتيجة ذلك، وجد القادة اليابانيون أنهم مضطرون لتوسيع سيطرة اليابان على علاقاتها التجارية مع جيرانها.
اليوم، يدرك القادة الصينيون أنهم يواجهون معضلة مشابهة، وهو ما أدركه قادة كل الدول الصاعدة تقريبا في التاريخ الحديث، فهم يعلمون أن سياستهم الخارجية يجب أن تكون معتدلة بما يكفي للحفاظ على الثقة الأساسية التي تسمح للعلاقات التجارية بالاستمرار، لكنهم يحتاجون أيضا إلى تكوين قوة عسكرية كافية لردع الآخرين عن الإضرار بهذه العلاقات. تتجلى النظرة الواقعية لكيفية تأثير التجارة في السياسة الخارجية في شرح السبب الذي جعل القادة الصينيين عدائيين إلى هذا الحد خلال العام الماضي ضد تطورات معينة في منطقة شرق آسيا، لا سيما فيما يخص تايوان. وعلى نطاق أضيق، قد تساعد هذه النظرة الواقعية في تفسير هوس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأوكرانيا.
التجارة.. بين غاز روسيا وإلكترونيات الصين

كان بوتين في حربه على أوكرانيا مدفوعا بمخاوفه بشأن الأمن الروسي، لكن اتخاذ القرار بالغزو استند إلى أمرين أساسيين: أولهما صادرات الطاقة الروسية لأوروبا. فقد أدرك بوتين بالتأكيد أن أوروبا تعتمد على روسيا أكثر بكثير من اعتماد روسيا على أوروبا، رغم اعتماد الاقتصاد الروسي على بيع الغاز. لكن بالنظر إلى طبيعة السلعة، فقد توقع بوتين أن أي خفض كبير في الغاز الطبيعي المتدفق سيتسبب في رفع سعره، ما يضر بالاتحاد الأوروبي بطريقتين -من خلال انخفاض الإمداد وارتفاع التكلفة- بينما ستتأثر العائدات الروسية الكلية تأثرا طفيفا.
أما ثانيهما، فقد كان لدى بوتين سبب للخوف من انخفاض النفوذ الاقتصادي الروسي على أوكرانيا وأوروبا في المستقبل. ففي عام 2010، اكتُشف مخزون ضخم من الغاز الطبيعي في جنوب مدينة خاركيف الواقعة شرقي أوكرانيا، وينتشر هذا المخزون حتى مقاطعتي دونِتسك ولوغانسك. وقُدِّر المخزون في ذلك الحقل بنحو تريليونَيْ متر مكعب من الغاز. وسرعان ما غيرت الحكومة الأوكرانية قوانين البلاد لتشجيع الاستثمار الأجنبي، ووقعت اتفاقا مع شركة "شِل" لتطوير الحقل عام 2013.

رغم أن غزو بوتين للقرم ودونباس عام 2014 غالبا ما حرَّكته مخاوف أخرى، ظهر بجلاء آنذاك في موسكو أنه إذا تم تطوير مخزونات الغاز الطبيعي المكتشفة في شرقي أوكرانيا بواسطة شركات غربية، فلن تكون أوكرانيا قادرة على إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي فحسب، بل أيضا ستبدأ في تصدير غازها إلى الاتحاد الأوروبي. باختصار، كانت تحركات الرئيس الأوكراني فولوديمير زلنسكي في أواخر عام 2021 لتوطيد علاقات بلاده السياسية والاقتصادية مع الغرب سببا في إثارة قلق بوتين على مصير روسيا، لكن هذه التحركات كانت تعني أيضا خسارة كبيرة لروسيا من حيث قدرتها على استخدام ورقة الطاقة في المستقبل. ساهمت التوقعات في موسكو، بأن روسيا ربما تفقد نفوذها الاقتصادي في أوكرانيا، في تفاقم إحساس بوتين بأن "هذا هو الوقت المناسب وإلا فلا" لابتلاع معظم الأراضي الأوكرانية شرقي نهر الدنيبر، المنطقة التي تحوي أكثر من 90% من احتياطي الغاز الطبيعي الأوكراني.
في المقابل، يُعَدُّ الارتباط الاقتصادي الصيني المتبادل مع بقية دول العالم أكثر تناسقا بكثير من مثيله الروسي، إذ يتحرك الاقتصاد الصيني مدفوعا بتصدير السلع الجاهزة، وعلى غرار ما كان عليه الاقتصاد الياباني في فترة ما بين الحربين العالميتين، فإن الصين مفرطة في اعتمادها على استيراد المواد الخام للحفاظ على دوران عجلة اقتصادها. إن وضع الصين باعتبارها مصنع العالم، ومسؤوليتها عن إمدادات نسبة كبيرة من احتياجات العالم من الحواسيب والهواتف الذكية وأنظمة اتصالات الجيل الخامس، يعطيها بعض النفوذ أمام شركائها التجاريين. لكن على غرار اعتماد اليابان على الواردات في فترة ما بين الحربين العالميتين، فإن تبعية الصين تتسبب لها في أوجه ضعف على المدى القصير ليست موجودة في روسيا، إذ يمكن أن تتضرر روسيا بالتأكيد بسبب العقوبات الاقتصادية، لكن قدرتها على بيع النفط والغاز -بأسعار مرتفعة نتيجة تحركاتها في أوكرانيا- يخفف كثيرا من قوة الصدمة.
إذا واجهت الصين أي موقف مشابه للعقوبات الشاملة المفروضة الآن على روسيا، فإن اقتصادها سيتدمر بالكامل. واقعيا، يُعَدُّ وعي بكين بنقطة الضعف هذه، بالفعل، بمنزلة رادع قوي لرغباتها التوسعية، بما في ذلك خططها لغزو تايوان. انظر مثلا إلى تفاصيل رد الفعل الصيني على زيارة بيلوسي لتايوان، رغم التهديدات التي أطلقتها سلفا. ومع أن بكين استعرضت غضبها عبر تدريبات عسكرية صارمة وإطلاق صواريخ دخلت إلى المجال الجوي التايواني، فإنها جعلت ردها الاقتصادي محصورا إلى حدٍّ كبير في فرض عقوبات على الصادرات الزراعية التايوانية. ومن اللافت أن المسؤولين الصينيين حرصوا على تجنب فرض أي قيود على صادرات تايوان من أشباه الموصلات، إذ إن الصين تعتمد على تايوان في الحصول على أكثر من 90% من الرقائق عالية التقنية، بالإضافة إلى جزء كبير من رقائقها منخفضة المستوى.
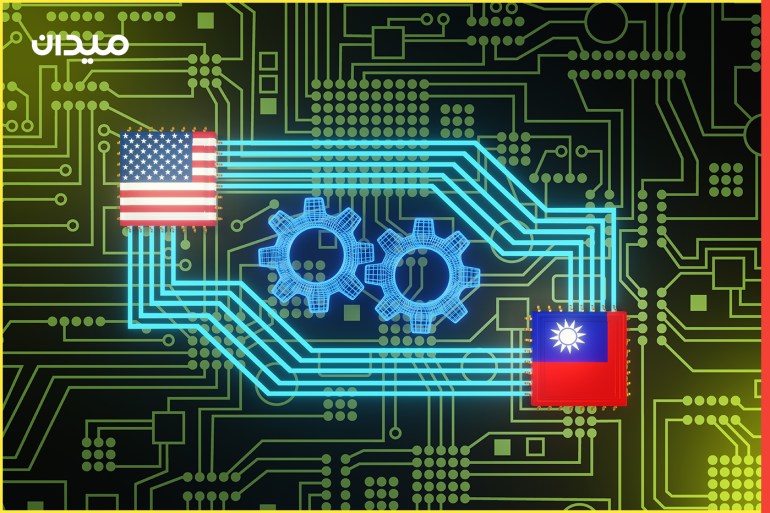
قد تؤدي تبعية الصين الاقتصادية إلى شنها عملا عدائيا في حال تراجعت التوقعات الصينية بشأن مستقبل التجارة. خذ على سبيل المثال موضوع أشباه الموصلات التايوانية فائقة التكنولوجيا. لدى الصين الآن بعض الإمكانات لإنتاج رقاقات بترانزستور يبلغ حجمه أقل من 15 نانومترا، بل حتى أقل من 10 نانومترات. لكن للبقاء على قمة التطورات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، والسيارات ذاتية القيادة، وإنتاج الهواتف الذكية، فإنها تحتاج إلى رقاقات يبلغ حجمها أقل من 7 أو 5 نانومترات، التي لا يمكن إلا لتايوان إنتاجها بكميات كبيرة وعلى مستوى عالٍ من الجودة. إن أحدث جهاز هاتف محمول لشركة "أبل"، على سبيل المثال، ورغم أنه يُجمَع في الصين، فإنه يحتوي على رقاقة من تصميم "أبل" تبلغ 5 نانومترات من إنتاج الشركة التايوانية لتصنيع أشباه الموصلات، ومقرها مدينة هسينشو.
لن يكون من الغريب القول إن مستقبل الصين من حيث قدرتها على اللحاق بالولايات المتحدة يعتمد على استمرار حصولها على الرقاقات التايوانية، تماما مثل وضع اليابان في ثلاثينيات القرن الماضي حينما كانت تعتمد على الحصول على النفط الذي يسيطر عليه الأميركيون والبريطانيون. وتماما كما كان الحال عام 1941 إبَّان صدور قرار حظر النفط الأميركي، إذا شك المسؤولون الصينيون في احتمالية اتخاذ الولايات المتحدة خطوات لمنع الصين من الحصول على الرقاقات التايوانية، فإنهم ربما يقررون ضرورة الاستيلاء على الجزيرة فورا لتجنُّب الانهيار الاقتصادي على المدى الطويل. ولا يُعَدُّ هذا السيناريو ضربا من الخيال. ففي يونيو/حزيران 2022، أعلن خبير اقتصادي صيني بارز أنه إذا فرضت واشنطن عقوبات على الصين تشبه تلك التي فُرضت في ذلك العام على روسيا، فإنه سيتعيَّن على الصين غزو تايوان لتأمين الاستيلاء على المنشآت التي تُنتج الرقاقات.
التجارة والدبلوماسية.. دروس الماضي
لكن ها هو النبأ السار. إن التوقعات الصينية لمستقبل التجارة، على غرار التوقعات اليابانية عام 1941، هي نتيجة لقرارات السياسة الأميركية. وإذا أدرك المسؤولون الأميركيون أن سياساتهم تُشكِّل مباشرة الطريقة التي تنظر بها بكين إلى بيئة التجارة مستقبلا، فإن بإمكانهم تجنب دفع قادة الحزب الشيوعي الصيني للتفكير بأن اقتصادهم سينهار في حال لم يستخدموا القوة. فمن خلال طمأنة بكين بأن الصين ستظل تتلقى أشباه الموصلات من تايوان، فإن إدارة بايدن يمكنها التخفيف من مخاوف بكين بشأن مستقبل التجارة، كما تخفض من احتمالية تفاقم الأزمة ونشوب حرب.

بالطبع سيعترض الرئيس الصيني "شي جين بينغ" وحاشيته حتى على هذا الموقف الأميركي، إذ إنه يجعل الصين معتمدة على الخارج في حاجتها من الرقاقات التي تُعَدُّ أساسية لكلٍّ من الاقتصاد عالي التقنية والقوة العسكرية. ومع ذلك، وبما أن أي هجوم على تايوان لن يستدعي عقوبات اقتصادية فحسب بل ما هو أسوأ، مثل تدمير غير مُتعمَّد لمصانع إنتاج الرقاقات في تايوان نفسها (وهو وضع يخسر فيه الجميع)*، فإن الصين لديها كل المبررات لتخفيف حدة سلوكها، إن لم يكن خطابها أيضا، حينما يتعلق الأمر بوضع الجزيرة.
لعل بوتين قد فكر في أن الغرب سينقلب على أوكرانيا بالنظر إلى اعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسي. لكنَّ القادة الصينيين يعلمون الآن أن الأميركيين والأوروبيين وشركاءهم الدوليين عازمون على "معاقبة الغزاة"، وأنهم بغزو تايوان ربما يدمرون كل ما استطاع الحزب الشيوعي الصيني تحقيقه طيلة العقود الأربعة الماضية. ويُثبت التاريخ أن القوى العظمى التابعة تكون حذرة في سياساتها الخارجية حينما يكون لدى قادتها توقعات إيجابية حول مستقبل التجارة، حيث إنهم يعلمون أن التجارة ستساعد في بناء قاعدة النفوذ للدولة على المدى الطويل، وسترفع ثروة المواطن العادي. ويحتاج "شي" إلى تحقيق الأمرين إذا ما أراد الحفاظ على شرعية حكم الحزب الواحد في الصين واستقرار الدولة نفسها.
عندما تسعى القوى العظمى إلى استخدام التبعية الاقتصادية المتبادلة للمساعدة في استدامة السلام، فإنها تواجه صعوبة في موازنة الأمر. ليس من الكافي إقامة علاقات تجارية عالية المستوى، إذ إن الدول التابعة، مثل اليابان في الثلاثينيات والصين اليوم، يمكن دفعها نحو سياسات أكثر عدائية حال إدراكها أنها لا تملك ما يكفي من المواد الخام والأسواق التي تحتاج إليها للحفاظ على موقعها بوصفها قوة عظمى. ويتعين على قادة الدول الأقل تبعية، مثل الولايات المتحدة، الحرص على ألا يتخذوا خطوات توحي بأنهم يسعون للإبقاء على انخفاض مستوى الدول التابعة، أو ما هو أسوأ، دفعها إلى الانهيار، مثلما فعل قرار الرئيس "فرانكلين روزفلت" بحظر النفط الأميركي لليابان عام 1941. ومع ذلك، فإن سياسة التجارة المفتوحة يمكنها أيضا أن تكون إشكالية، بما أنها يمكن أن تساعد الدولة التابعة على اللحاق بالركب من خلال تكوين قوة نسبية، ومن ثمَّ تصبح تهديدا على المدى الطويل.

هناك نهج أفضل يتمثل في دفع القوى الصاعدة مثل الصين إلى تغيير طريقة اللعب من خلال إنهاء ممارسات مثل التلاعب بالعملة، والدعم، والاستيلاء غير القانوني على التكنولوجيا الأجنبية، مع طمأنة هذه الدول بأنها إذا اعتدلت في سياساتها الخارجية، فإنها ستستمر في التمتع بسهولة الوصول إلى الموارد والسوق التي تحتاج إليها للنمو الاقتصادي والاستقرار الداخلي. ويتعين على قادة القوى العظمى أن يسعوا جاهدين لإنشاء علاقات تجارية تسمح للدول بالنمو على نحو مطلق، مع التأكد من أن كلا الجانبين ليس لديهما مخاوف من انهيار كبير مستقبلا في القوة الاقتصادية النسبية.
بينما تعود مياه دبلوماسية القوى العظمى لمجاريها، فإن واشنطن يمكنها العمل على تذكير بكين بحاجتها إلى الولايات المتحدة والشركاء الغربيين من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية، وأن واشنطن لن تستغل تبعية الصين لتقويض هذه الأهداف. ويستطيع بايدن طمأنة "شي" بأن درس عام 1941 -أي تدمير توقعات دولة بشأن مستقبلها التجاري بما يدفعها إلى الحرب- قد تم استيعابه جيدا من جانب الأميركيين. لكنه يمكن أن يقترح أيضا أن تتعلم بكين من أخطاء اليابان في فترة الثلاثينيات، وتجنُّب مثل هذا النوع من السياسات العدائية التي دمرت الثقة العالمية الضرورية لإقامة علاقات تجارية صحية. وإذا كان القادة في واشنطن وبكين قادرين على تحسين توقعات بعضهم بعضا بشأن كلٍّ من التجارة وسلوكهما في المستقبل، فإن ذلك يعني إمكانية تحقيق السلام في شرق آسيا لعقود طويلة مقبلة.
ترجمة: هدير عبد العظيم
هذا المقال مترجم عن Foreign Affairs ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.

