لغير المتخصصين.. لمصلحة مَن يعمل علم الاقتصاد؟

لعلّك تساءلت يوما عن سبب صعوبة إيجاد فرصة عمل مناسبة، أو من الوارد أن السؤال قد أتاك بصيغة أخرى بعد مقابلة عمل أجريتها في إحدى الشركات اضطررت فيها لقبول راتب غير مناسب؛ لماذا لا تملك موقعا تفاوضيا أفضل يجعل مفاوضاتك مع أصحاب الشركات عملية عادلة يحصل كل طرف فيها على ما يستحقه؟ أو ربما بعد قبولك في الوظيفة كان سؤالك لماذا رغم كل المجهودات التي تبذلها في العمل فإنك بالكاد تُناضل للحفاظ على مستوى حياتك، بينما أصحاب العمل ورأس المال يُراكمون ثروات هائلة جرّاء مجهوداتك، ولا تنال أنت حتى حقك في الإحساس بالأمان المادي؟
بحسب عالم الاجتماع البولندي زيجمونت باومان فإن إحدى سمات العقود الأخيرة عدم قدرة الأفراد على وضع مشكلاتهم ومعاناتهم الخاصة داخل سياقات أوسع، حسب رأي باومان ربما تكون تلك السياقات هي التي أنتجت تلك المشكلات والمعاناة، فصعوبة الحصول على وظيفة مناسبة أو التفاوت المتزايد بين الأجور وبين الأرباح، أو حتى انخفاض قدرتك الشرائية بشكل متكرر، هي أشياء لا تحدث مصادفة، بل خلف كل تلك الظواهر، وغيرها من الظواهر التي تمس صلب حياتك اليومية والمعيشية كالحصول على تعليم وعلاج في مستوى جيد وحقك في شوارع آمنة وحتى أماكن للتنزه والتريض، تخضع ترتيبات سياسية واقتصادية، ونظريات وصراعات أيديولوجية وثقافية حول ماهية ومفهوم الاقتصاد الحديث ومعايير نجاحه ودوره في حياتنا وعلاقتنا به أفرادا ومجتمعات.
هنا يكون السؤال الأكثر جدوى حول طبيعة الترتيبات الاقتصادية التي تتحكّم في حياتنا وتُخرجها بتلك الصورة؛ ما الأفكار والنظريات والمصالح التي شكَّلت تلك الترتيبات الاقتصادية، كيف تطوّر الاقتصاد خلالها كعلم وكسياسات وصولا إلى لحظتنا الراهنة، هل الاقتصاد علم رقمي رياضي محايد يخضع الناس لقوانينه الباردة الكئيبة، أم هو علم سياسي واجتماعي من الممكن الاشتباك معه وتطويعه وإخضاعه لمصلحة الغالبية من الناس؟


في كتابه "تاريخ التحليل الاقتصادي"(1)، يؤكد المؤرخ والاقتصادي جوزيف شومبيتر أن ثمة اتفاقا عاما بين غالبية مؤرخي الفكر الاقتصادي أن الاقتصاد الحديث يبدأ مع انتقال المجتمعات من عالم العصور الوسطى الإقطاعي ونمط الإنتاج الفيودالي القائم على اعتبار الأرض هي المصدر الوحيد للقيمة إلى الاقتصاد الصناعي والتجاري القائم على تضافر قوة العمل ورأس المال والموارد الطبيعية كعناصر ثلاثة تتكامل بغرض إنتاج السلع من أجل تحقيق الربح ومراكمة الثروة، بعبارة أخرى بدأ الاقتصاد الحديث حين أصبح الهدف الأساسي من النشاط الاقتصادي هو تراكم الثروة والأرباح عوضا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي كما في العصور الوسطى الإقطاعية الزراعية.
هذه الفكرة البسيطة جدا والبديهية جدا في الجوهر والمضمون "تعظيم الربح كهدف أسمى للنشاط الاقتصادي" كانت ثورية للغاية في مآلاتها، بحيث أصبحت هي والقوى الاجتماعية التي آمنت بها تُشكِّلان الجذر الأساسي الذي شَكَّل العالم كما نحياه اليوم، فتحت شعار "تعظيم الربح" انبرى فلاسفة واقتصاديون إلى صياغة شكل للعالم والإنسان وطبيعة الاقتصاد في خدمة هذا الشعار، يشرح الأكاديمي والاقتصادي جلال أمين (2) كيف رسم الاقتصاديون الأوائل منذ بواكير نشأة الرأسمالية صورة الإنسان الاقتصادي على هيئة حيوان اقتصادي "يتحرك فقط من أجل منفعته الخاصة، مجردا من أي دافع عدا دافع تعظيم الفارق بين ما يُنفقه وما يعود إليه، فهو إنسان بلا عواطف ولا تاريخ ولا ذكريات ولا وطن ولا أسرة، إنه حيوان اقتصادي فحسب".
ويُضيف أمين أنه بالكيفية ذاتها يتحرك هذا الحيوان الاقتصادي في عالم هو عبارة عن سوق كبير، عالم من السلع كل شيء داخله قابل للشراء والبيع وإعادة التدوير والاستثمار، يتحرك الإنسان داخل هذا العالم بشكل أناني وفرداني تماما لتعظيم منفعته الخاصة، وتلك المنفعة تُقاس بقيمة النقود ورأس المال الذي يمتلكه. تحت هذه التصورات الفلسفية ظهر علم الاقتصاد كعلم رقمي رياضي محايد، مجرد أرقام تصطف بجانب أرقام أخرى ويحكمها قانون وحيد قائم على العرض والطلب وهدف وحيد هو تعظيم الأرباح.

ظلَّ الاقتصادُ كعلم وسياسات أسيرَ تلك الرؤية للإنسان والعالم لفترة طويلة، مع التمسك بالمنطق الرأسمالي نفسه الهادف إلى تحويل العالم إلى سوق كبير لا يحكمه إلا قانون العرض والطلب والمنفعة وتراكم الأرباح، في ضوء هذا تعزّزت النزعة الاحتكارية وابتلعت المشاريع الكبرى المشاريع الصغيرة والناشئة، وأصبحت الطبقات الوسطى والدنيا مكشوفة تماما أمام أصحاب رؤوس الأموال والشركات والمؤسسات المالية الكبرى، يقومون في حرية تامة بتحديد قوانين ولوائح العمل وحجم الأجور ونوعية التأمين الصحي والاجتماعي، ويفرضون على العمال في المصانع والموظفين في الشركات والمؤسسات المالية كل الشروط التي من شأنها استخراج فائض القيمة من قوة عملهم دون مراعاة لأي جوانب صحية أو شخصية، أتى هذا مصحوبا بانتشار الهيمنة الاستعمارية التي شكَّلت طبيعة العلاقات الإنتاجية والاستهلاكية في غالبية البلدان حول العالم، وحرمت أبناء المستعمرات من تحقيق موقع مقبول داخل منظومة التجارة الدولية (3).
أتى علم الاقتصاد الكئيب، كما يُسمِّيه الاقتصادي الكبير أوسكار لانغ (4)، من قلب تصور قاتم للعالم والإنسان، اقتصاد تقني وأداتي بشكل جذري، خالٍ من أي أبعاد اجتماعية وسياسية، اقتصاد هو في مجمله عبارة عن أرقام مجردة وسوق تنبع قوانينه وآلياته من داخله وعلى الإنسان أن يخضع لتلك القوانين والآليات إذا أراد حياة كريمة في هذا العالم الرأسمالي الكلاسيكي، يقودنا هذا كله إلى سؤال مهم؛ إذا كان الاقتصاد بهذه الصورة الشمولية، فهل علينا الاستسلام للعالم الوحشي الذي رسمه الاقتصاديون الكلاسيكيون الأوائل، بهذه النظرة للاقتصاد إذا لم تكن صاحب رأس مال ولديك استثمار فأنت ليس لك مكان فيه، لا يوجد في آلياته وقوانينه وأهدافه أي شيء يُشير إلى الإنسان العادي، الذي لا يملك إلا قوة عمله ومهاراته كمصدر للدخل، فكيف يمكن لك التفاوض مع مدير مؤسستك إذا كانت قوانين السوق صُمِّمت خصيصا لتفضيل مصالحه على مصالحك؟

استمر هذا الوضع المأساوي منذ نهايات القرن الثامن عشر حتى استيقظ العالم على وقع أعنف أزمة اقتصادية في تاريخه في ثلاثينيات القرن الماضي، ما عُرِف تحديدا بأزمة الكساد الكبير، يروي جوزيف شومبيتر جذور تلك الأزمة موضحا أن معدل التضخم في الاقتصاديات المتقدمة أخذ يرتفع مُسبِّبا ارتفاعا متزايدا في الأسعار أخذ يستنزف مدخرات العديد من الشرائح الاجتماعية الوسطى التي استطاعت تحقيق موقع ما داخل النظام الرأسمالي، فضلا عن تقلُّص القدرة الشرائية للطبقات الدنيا تماما، بينما استمر أصحاب المصانع والشركات والمنتجين الكبار حول العالم في التحكُّم الكامل في المحيط السعري العالمي دون حتى مقارنة أسعار منتجاتهم الآخذة في الارتفاع مع تقلُّص القوة الشرائية للمستهلكين المنتظر منهم شراء تلك المنتجات، يُضيف شومبيتر: "أصبحت الفجوة المتنامية بين جهاز الأسعار والقوة الشرائية تُنذر بأزمة كساد كبيرة على المدى القريب، وأصبح الجميع ينتظر كارثة، ولكن بدا ألّا أحد لديه ما يفعله حيال الأمر"، كانت تلك حسب جوزيف مقدمة دخول أميركا وأوروبا والعالم من ورائهم في أزمة كساد امتدّت لعقد كامل.

بدأت الأزمة بانهيار سوق السلع الأكبر حجما، أولا العقارات يليها سوق السيارات والتأمينات، ومع كل انهيار لقطاع داخل السوق تُغلَق شركات ومصانع وتزداد نسبة البطالة، فيزداد الذعر، فيتوقّف الناس عن الشراء، فتنهار سلع أخرى، حتى وصل الأمر إلى شلل كامل للسوق والاقتصاد في غالبية الدول الأوروبية والأميركية ثم باقي مناطق العالم المرتبط عضويا بالمركز الأوروبي-الأميركي. توقّف الاستثمار، وتقلّص الاستهلاك والشراء إلى أقصى مستوى ممكن، وتعطّلت التجارة، ما أدّى في نهاية المطاف إلى البطالة لأكثر من عشرات الملايين حول العالم مع الاستمرار في غلق غالبية المصانع والشركات حول العالم، ما أدّى إلى وصول معدل الفقر إلى معدلات قياسية (5).
أصبحت السلع بداية من العقارات والسيارات والملابس والتأمينات وحتى أبسط السلع كأدوات النظافة الشخصية مكدسة في المخازن والمصانع وعلى صفحات الدعاية بلا طلب عليها، كانت النتيجة التي وصلت إليها سياسات السوق الحر ومراكمة الأرباح أن قتل السوق نفسه بنفسه، إذ أصبح سوقا بلا مستهلكين، سوقا بلا طلب، سوقا للعرض فقط (6). هنا بدأت العديد من النخب السياسية والمالية في إدراك مدى قتامة العالم الذي خلقته، وساد شعور وسط النخب السياسية تحديدا بضرورة إنقاذ الرأسمالية من نفسها، وأصبح هناك حاجة مُلِحّة إلى اقتصاد جديد، اقتصاد بوجه إنساني.

أعلنت أزمة الكساد الكبير عن فشل النظرة الرأسمالية الكلاسيكية للاقتصاد، وفشل فكرة اليد الخفية والانتظام الذاتي للسوق. منذ هيمنة الرأسمالية ودائما هناك انتقادات للنظام الرأسمالي لما فيه من إعلاء لقيمة الربح فوق كل الاعتبارات السياسية والاجتماعية، كانت الانتقادات إما ذات طابع أدبي أخلاقي كما في رواية تشارلز ديكنز "أوقات عصيبة" (Hard Times) أو رواية دوستويفسكي "الأبله" (The Idiot)، أو ذات طابع ثوري راديكالي تطمح في تشييد عالم مختلف تماما عن عالم الرأسمالية كما في أطروحات كارل ماركس وفريدريك إنجلز وفلاديمير لينين، وأطروحات نقدية من داخل الرأسمالية تهدف إلى إكساب الاقتصاد الرأسمالي أهدافا اجتماعية وسياسية لإنقاذ علم الاقتصاد وإعادة صياغته على مساحات أرحب وأهداف أكثر غنى وتنوعا.
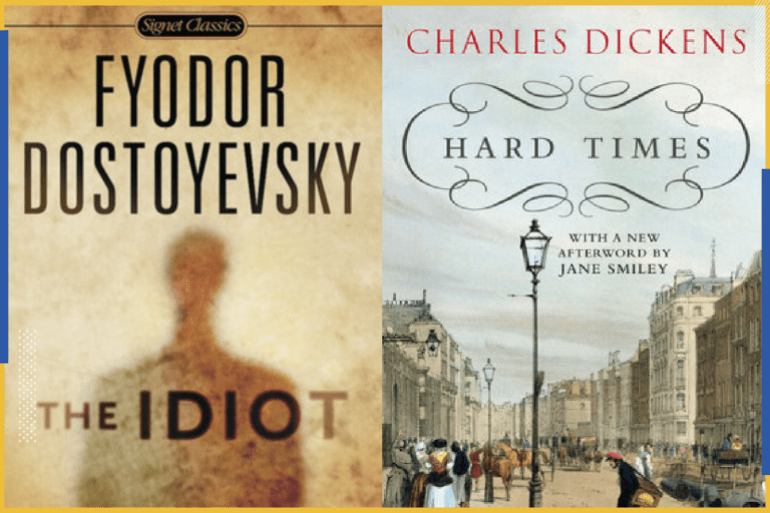
النظرية الأساسية في هذا المضمار هي ما سُمّيت بـ "النظرية الكينزية" نسبة للاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز، نقل كينز علم الاقتصاد الحديث من ملعب المشروع الخاص وتحقيق الربح على أرضية السوق الحر المفتوح إلى ملعب أكبر، حيث أصبح تماسك الاقتصاد مسؤولية الدولة والمجتمع المدني بالإضافة إلى أصحاب المصانع والشركات والبنوك، ومع دخول تلك القوى الجديدة في إدارة السياسات الاقتصادية ظهرت بالتالي أهداف جديدة للعملية الاقتصادية، فأصبحت أهداف مثل تحقيق التشغيل الكامل، والقضاء على البطالة، وتحفيز الطلب عبر خفض ساعات العمل وأيامه، ودعم بعض السلع الأساسية، وتقديم تأمين اجتماعي ضد الشيخوخة والبطالة والإعاقة، ودعم إنشاء اتحادات عمالية، والتوسع في خلق النقود، هي عناوين نجاح الاقتصاد، بالإضافة إلى تدخل الدولة لضبط الأسواق والأسعار والاحتكارات وزيادة الأشغال العامة والإنفاق العام الحكومي الموسع لضخ السيولة في أيدي الشرائح الوسطى والدنيا (7).
ساهمت تلك السياسيات الطموحة التي نادى بها جون ماينارد كينز في كتابه "النظرية العامة في التوظيف والفائدة والنقود" وعملت بها النخب السياسية والمالية ليس فقط في القضاء على الكساد الكبير وتعزيز سياسات الرفاه الاجتماعي، بل في تحويل طبيعة المجتمعات الرأسمالية نفسها، حيث اتسعت الطبقة الوسطى، وانخفضت معدلات البطالة والفقر إلى أقل درجة لها منذ قيام الصناعة، وارتفعت الثقة في الاقتصاد بسبب وجود الدولة كضامن لتقلبات السوق، فأقبل الناس على الشراء والاستهلاك ووضع مدخراتهم في البنوك، وزادت ثقة المستثمرين في السوق وبدؤوا في الاستثمار والإنفاق بشجاعة على مشاريع عملاقة جديدة بتوظيفات واسعة وبشروط تعاقد جيدة في ضوء قوانين وآليات تنص عليها الحكومات والاتحادات العمالية المهنية، تشمل نظم تأمين وأجورا وحصصا من الأرباح وقوانين لساعات العمل والإجازات، ونظم حماية قانونية لحقوق العمال والموظفين والمستهلكين عبر هيئات قضائية أُنشئت خصوصا لهذا الغرض (8).
بدا للجميع أن العالم قد وصل إلى نهاية سعيدة بالفعل، وأُخْضِع الاقتصاد -ولو بنسبة ما- لمصلحة الإنسان، والرأسمالية المتوحشة هُذِّبت، وحُرِّر الاقتصاد من كونه أداة في أيدي الأثرياء لتعظيم الأرباح إلى اعتباره مجالا لتحقيق مصالح قومية ووطنية أوسع تخدم كل شرائح المجتمع. سُمّيت تلك الفترة بالعقود الثلاثة المجيدة، حيث دولة الرفاه الاجتماعية التي أسّست عقدا اجتماعيا بين الطبقات المتصارعة بالحفاظ على حدٍّ معين من التفاوت الاجتماعي، لكن يبدو أن العالم لا يُطيق فكرة النهايات السعيدة أبدا.

منذ منتصف الحرب العالمية الثانية حتى السبعينيات، حقّقت سياسات دولة الرفاه وتحفيز الطلب معدلات نمو اقتصادي عالية في غالبية الدول حول العالم (9)، إلا أنه مع قيام حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 والحظر النفطي الذي فرضته الدول الخليجية على أوروبا وأميركا، توقّفت حركة الاقتصاد بالكامل وارتفعت معدلات البطالة والتضخم بشكل ملحوظ في كل الدول، مما أدخل الاقتصاد العالمي في أزمة ركود تضخمي، وبحسب الاقتصادي والأنثروبولوجي ديفيد هارفي (10) فإن تلك الأزمة كانت بمنزلة طوق النجاة للطبقات العليا في الغرب للهجوم على دولة الرفاه النظرية الكينزية واستعادة سُلطتها السياسية والاقتصادية التي فقدتها قبل ثلاثين عاما.
منذ هيمنة النظرية الكينزية مطلع الأربعينيات وأصبحت النظرية الاقتصادية الأولى في الأكاديميات الغربية، ورأت النخب الحاكمة على مستوى العالم في الكينزية ومبدأ تدخُّل الدولة لتشجيع الطلب والدعم وتوسيع الإنفاق العام دليلا إرشاديا للحفاظ على أسواق فعالة واقتصاد مستقر، خلال الفترة نفسها تجمّع بعض الأكاديميين المناوئين للنظرية الكينزية في أحد المنتجعات السويسرية ليؤسِّسوا جمعية علمية اقتصادية عُرفت لاحقا بجمعية مونت بيليران، نسبة لاسم المنتجع حيث يتجمعون بشكل سنوي لتبادل الأبحاث والأفكار في الاقتصاد والسياسية، واعتبر أعضاء الجمعية أنفسهم ليبراليين بالمفهوم الأوروبي الكلاسيكي، بسبب التزامهم بالفردانية والحرية الشخصية، إلا أن الاسم الذي شاع عنهم كان الليبراليين الجدد، بسبب حنينهم الجارف للرأسمالية الكلاسيكية قبل كينز وتمسُّكهم بالإيمان القديم باقتصاد فرداني يقوده الأفراد وروّاد الأعمال لا تتدخل فيه الدولة أو المجتمع المدني بأي شكل.
اتِّكاءً مرة أخرى على ديفيد هارفي، ظلّت أطروحات الليبراليين الجدد على "هامش التأثيرين السياسي والأكاديمي كترياق محتمل للتهديدات التي يواجهها النظام الاجتماعي-الاقتصادي لما بعد الحرب إلى حين قدوم سنوات القلق والاضطراب في السبعينيات. حينها بدأت الحركة تنتقل إلى المركز برعاية مراكز أبحاث متعددة وجيدة التمويل (معظمها فروع لجمعية مونت بيليران)، وبالفعل بدأت النظرية الليبرالية الجديدة تُمارِس تأثيرا عمليا في العديد من ميادين السياسة والتعاون الدولي"(11).
برز أعضاء مونت بيليران في سماء الأكاديمية الغربية بسرعة بعد الدعم السخي الذي تلقّوه، وأعلنوا بكل وضوح تمسُّكهم برأي آدم سميث والاقتصاديين الكلاسيكيين "بأن السوق الحر المفتوح هو الأداة المثلى لحشد أخس غرائز الإنسان كالطمع والشره وشهوة المال والثروة والأنانية، وتسخيرها لخدمة الجميع"(12) عملا بالمبدأ الرأسمالي الكلاسيكي أن عمل الفرد من أجل مصلحته الخاصة هو في نهاية المطاف يصب في مصلحة المجموع، وبدأ اقتصاديو مونت بيليران وعلى رأسهم فريدريك فون هايك وميلتون فريدمان مدعومين بحملة دعاية ضخمة بالهجوم على دولة الرفاه الاجتماعي "التي -حسب زعمهم- استسهلت إنفاق المال على الأغراض الاجتماعية لمساعدة الفقراء ومتوسطي الحال من خلال أنظمة دعم الرعاية الصحية والغذائية وأنظمة التأمين والضمان المتعددة. والحل كما اقترح ميلتون هو العود على بدء، أي انسحاب الدولة من حلبة الاقتصاد الاجتماعي والسياسي، ويتحقّق ذلك من خلال تقليص برامج الرفاه الاجتماعي إلى أقصى حد، وخصخصة المشاريع العامة، وإفساح المجال للقطاع الخاص الكبير للإنتاج والشراء والبيع في الأسواق الخارجية والمحلية بأقل قدر ممكن من القيود"(13).
انعكست توجيهات ميلتون فريدمان -الذي حصل على جائزة نوبل للاقتصاد منتصف السبعينيات- على سياسات العديد من الدول حول العالم ومنها مصر، فهوجمت أشكال التكافل الاجتماعي كافة التي تعوق حرية السوق والروح التنافسية وحركة رواد الأعمال الكبار، وأُلغيت الضرائب التصاعدية على الثروة والدخل، وتدريجيا شُلَّت الفعالية السياسية للنقابات المهنية والعمالية وأُخرِجت من منظومة صنع القرار، وأُلغِي الإنفاق العام الحكومي بشكل كامل تقريبا، وغاب تدخل الدولة القانوني في رعاية شروط عادلة للتعاقد بين الشركات والمصانع وبين الموظفين والعمال، وتُرِكت الأسعار تماما تحت تصرُّف السوق وكبار المنتجين لجميع السلع، مما ترك الشرائح الوسطى والدنيا من جديد تحت رحمة قوانين السوق والعرض والطلب.
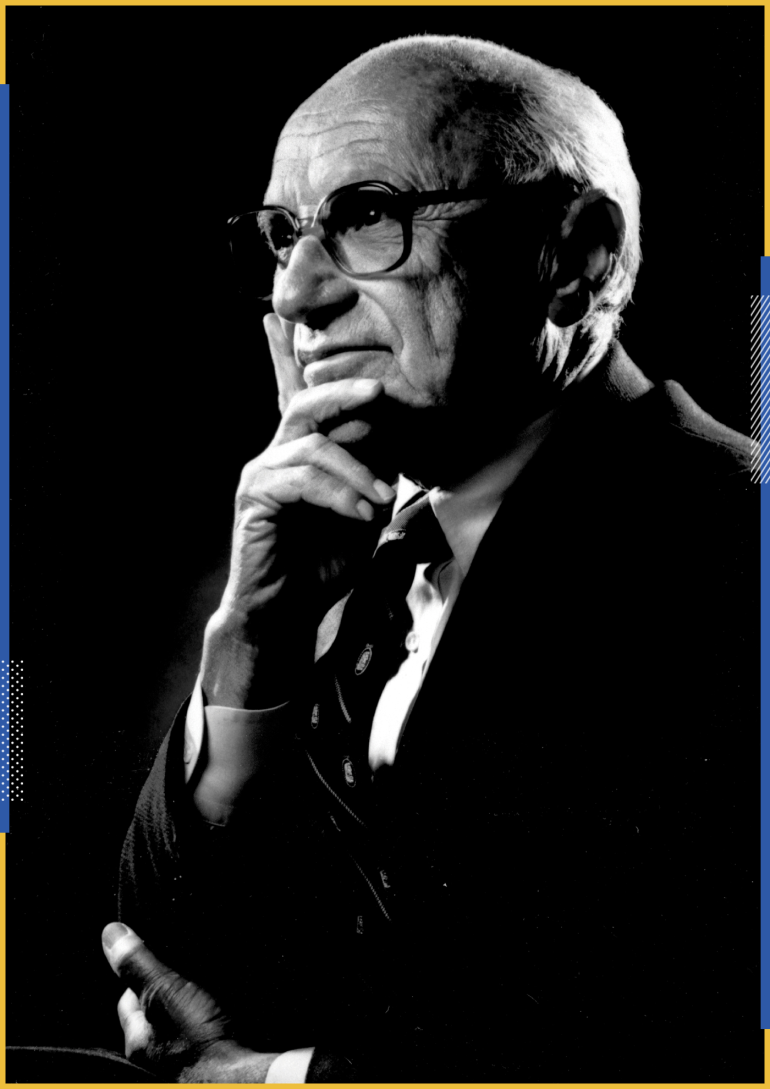
ويلاحظ د. محمود عبد الفضيل (14) أن منذ نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي كانت هناك نزعة متزايدة لعدم التصدي للقضايا الأساسية في مجال إعادة التوزيع، والتوظيف، وأزمة تراكم الثروة في شريحة واحدة، الذي ألحّ عليه العديد من المدارس الاقتصادية الحديثة كالمدرسة الكينزية والماركسية الكلاسيكية وما بعد الماركسية، إذ تراجع نفوذ تلك الاتجاهات في داخل دوائر صنع القرار لصالح اتجاه وحيد وهو الليبرالية الجديدة، هنا بدأ علم الاقتصاد بمعناه الواسع يمر بأزمة اجتماعية باعتباره علما اجتماعيا، بعد أن طغت عليه الأساليب الكمية الرياضية المتمركزة حول تحقيق الأرباح وتراكم الربح فقط، ولا تهتم بكيفية توزيع تلك الأرباح والثروات داخل المجتمع، فضلا عن اهتمامها بمفهوم التنمية بشكل شامل، مما يعني تصفية علم الاقتصاد كعلم اجتماعي، وتحويله إلى فرع من فروع علم الشركات وإدارة الأعمال.
طوال تاريخ علم الاقتصاد، كان الصراع على طبيعة هذا العلم وأهدافه ومعايير نجاحه وفشله أكبر من مجرد نقاش نظري في أروقة الجامعات ومراكز الأبحاث، هو في الحقيقة، كما يؤكد جلال أمين في كتابه المهم "فلسفة علم الاقتصاد"، صراع سياسي واجتماعي تاريخي، صراع على مصالح الناس وحقوقهم الأساسية وطرائق معيشتهم ونصيبهم من العالم الذي يساهمون فيه بعملهم ومهاراتهم، فحين تكون في مقابلة عمل، أو في نقاش سنوي داخل مؤسسة عملك حول زيادة في الرواتب، أو عن حقك في تأمين صحي ومعاش يحفظ لك حياة كريمة، ويُعزِّز إحساسك بالأمان المادي لك ولأسرتك، نظير مساهمتك الإنتاجية في الثروة التي يُحقِّقها ربّ عملك، كل هذه النقاشات هي موضوع الصراع الرئيسي على الاقتصاد الحديث، تم في سبيلها ثورات واحتجاجات ونضالات سياسية، وحدثت ضدها كذلك ثورات مضادة وانقلابات عسكرية وحملات قمعية، هدفها الإجابة عن سؤال واحد أساسي: لمصلحة مَن يعمل علم الاقتصاد؟
_____________________________________________________
المصادر
- تاريخ التحليل الاقتصادي، جوزيف شومبيتر، ترجمة حسن عبد الله بدر، المجلس الأعلى للثقافة
- فلسفة علم الاقتصاد، جلال أمين، دار الشروق
- الرأسمالية، جويس أبلبي، ترجمة رحاب صلاح الدين، مؤسسة هنداوي بالتعاون مع مؤسسة كلمات
- أوسكار لانغ، الاقتصاد السياسي، ترجمة راشد البراوي، دار المعارف
- الكساد الكبير والصفقة الجديدة، إريك راشوي، ترجمة ضياء وراد، مؤسسة هنداوي
- المصدر السابق
- المصدر السابق
- المصدر السابق
- الليبرالية الجديدة: موجز تاريخي، ديفيد هارفي، ترجمة مجاب الإمام، دار العبيكان
- المصدر السابق
- المصدر السابق
- المصدر السابق
- أضواء على جدلية المعرفي والأيديولوجي في الفكر الاقتصادي، محمد عبد الشفيع عيسى، مركز دراسات الوحدة العربية
- الأزمة الراهنة لعلم الاقتصاد وانعكاساتها على الفكر الاقتصادي العربي، د. محمود عبد الفضيل، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية – القاهرة

