المقاهي الفلسفية.. هل نشهد ثورة على الفلسفة الأكاديمية؟

لمّا سُئل الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز مرة عن موقفه ممّا يقال عن موت الفلسفة، كان جوابه: "ليس هناك موت وإنما هي محاولات اغتيال"(1)، وتأسيسا على جواب جيل دولوز؛ فقد مرّت الفلسفة بعدّة محاولات اغتيال: كانت أولى محاولات الاغتيال تلك -كما يرى مؤرخ الفلسفة الأميركيّ كوبلستون(2)- آتية من إعادة كُل محاولة تفلسف إلى حظيرة الأسطورة وحدودها المُسيّجة بالخيالات والأوهام، مرورا بحنق رجالات الحُكم وتأفُّفِ السلطة والمستبدّين من الحراك الفلسفي(3)، وصولا إلى الضربات العنيفة التي تلقتها الفلسفة من طرف أهمّ منافسين لها: الدين من جهة، والعلم من جهة أخرى(4).
وعطفا على محاولات الاغتيال الأربع الكبرى آنفة الذكر (الأساطير، السلطة، الأديان، العلم)، فإنه لا يمكننا إغفال محاولة الاغتيال الخامسة، والتي تختلف في جوهرها عن محاولات الاغتيال السابقة، إذ إنّها آتية من رحم الفلسفة نفسها، لا من خارجها، وهي ما يمكن وصفه اصطلاحا بأزمة "تمدرس الفلسفة"، أي النظر إلى الفلسفة باعتبارها مذهبا، نسقا، مدرسة، نظرية، إلخ.(5)
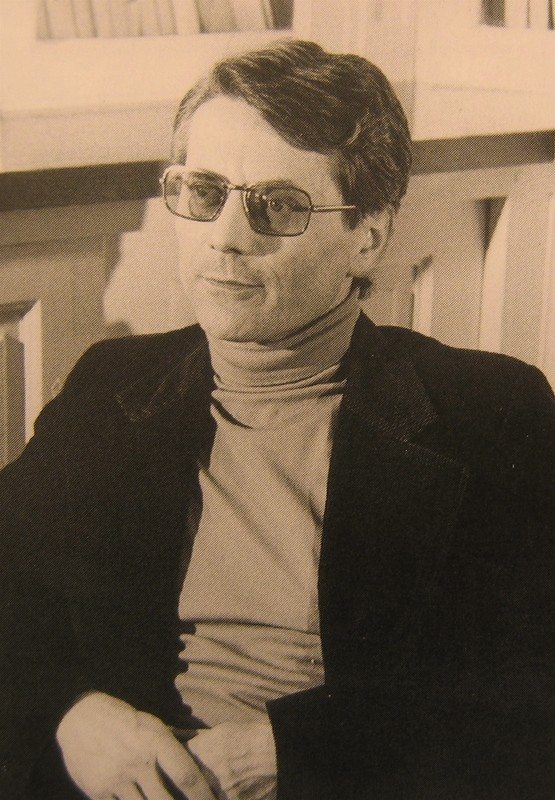
وإلى هذا المعنى أشار الفيلسوف الفرنسي ميرلوبونوتي في إحدى محاضرته في الكوليج دي فرانس، يقول ميرلوبونوتي: "الفيلسوف الحديث هو في الغالب موظف، هو دائما مؤلف، والحرية المتروكة له في كتبه لها ما يقابلها من الالتزام. إن ما يقوله ويكتبه فورا يدخل في عالم أكاديمي تقل فيه مطالب العمل، وتضعف فيه فرص التفكير".(6)
وكذا فقد تنبّه الفيلسوف الفرنسي ميشال دو سارتو إلى الشيء ذاته، حيث رأى أنّ "الالتزام الأكاديمي المحض ليس معرفة وإنّما سلطة".(7) وعودا على جيل دولوز، فقد رأى ما رآه زميلاه -ميرلوبونوتي ودو سارتو-، وفي ذلك يقول:
"إنّ الانغلاق والنزعة الشمولية الكلية اللذين طبعا تاريخ الفلسفة منذ ميلادها، جعلا الفلسفة تسعى لأن تغدو لغة رسمية لدولة خالصة، فصار الفكر يستمدّ شكله الفلسفيّ من الدولة كجوهر متقوقع على ذاته، لتبتدع الفلسفة دولة روحية، دولة تعمل ذهنيا، دولة توقف وتلغي وتعاقب وتحدّ وتراقب. من هنا تكمن الأهمية التي اتخذتها بعض المفهومات في تاريخ الفلسفة، والتي اتخذت في جوهرها منطق الدولة السلطوي، وهو ما تم التعبير عنه، كالشمولية، و"جمهورية العقلاء"، و"موظّفي الفكر"، و"تعالي المعاني"، و"محكمة العقل"، و"تقصّي الحقائق" والحكم والاعتراف، و"الدفاع" عن الحقيقة، و"اتّهام" الفلاسفة، والسؤال والجواب، والأخذ والردّ، والأفكار الصائبة، والحرص على أن نكون دوما جهة الأفكار المحقّة، والإنسان المشرّع، و"الحقّ" في التفكير".(8)
وفي هذا يقول الفيلسوف الأرجنتيني إنريكه دوسيل في كتابه "فلسفة التحرير": "إن فعل التفلسف لكي ينتج فلسفة لا يجب أن يكون تقليديا، لأن التقليد في الفلسفة يقدم تاريخا للفلسفة، وليس فلسفة!
وعليه فإن فعل التفلسف، لكي يبدع فلسفة، يجب أن يحاكي واقعا، لا أن يحاكي فلسفة".(11) وهكذا تغدو مسألة الواقع من المسائل التي تميز الفيلسوف عن غيره -كما يرى دوسيل-، وبقدر ارتباطه بالواقع واشتباكه مع الأسئلة التي تتولد منه، يتحقق بذلك المعنى الفلسفي المنتج، وبغير ذلك يتحول الفيلسوف إلى مهرج من مهرجي إضحاك الأمراء -كما يقول دوسيل-.(11)
وكذلك عمد الفلاسفة إلى اجتراح ما سمّاه "ميشيل فوكو" بــ "فلسفة اللافلسفة"(12)، أي انفتاح الفكر على ما ليس بفلسفة، بل ما كان العقل الفلسفي يستبعده أو يرذله من الممارسات والمجالات. وهكذا انفتح الفكر الفلسفي على وقائع الخطاب وأنساق العبارة، وانفتح على الجنون والسجن والعلاقات الجنسية والتكنولوجيا وكرة القدم، وانفتح أيضا على فوضى الأنظمة وكثافة التجارب وعتمة الممارسات. وهذا الانفتاح على اللامعقول والجسد والمصادفة واللافلسفة، وكل ما كان منفيا من قبل أو مهمشا، أدى إلى قلب الرؤية إلى العالم(13)، ومساهما في خلخلة الحالة الأكاديميّة الفلسفية الصلبة!
وبذلك بات لفلسفة اليوميّ أو الواقعيّ أو "فلسفة اللافسفة" أنصار كثر ومؤيدون، من ميشيل دو سارتو إلى فتحي التريكي، ومن ريجيس دوبريه إلى عبد السلام بنعبد العالي.
وهم بذلك يرون الفلسفة والفعل الفلسفي "تفكيرا عميقا" لا "تفكيرا في العميق"، أي إنّه "إستراتيجية" قبل أن يكون "موضوعا".(14) وللتدليل على ذلك فإنهم يرون أنّ نهوض الفلسفة في العصر الحديث جاء من مكان يُعدّ من هوامش المواضيع الفلسفية، لا من المتون التي شكلت مواضيع الفلسفة بصورتها التقليدية، وتمثل ذلك عبر فرويد وفرانكل في علم النفس، ليفي-شتراوس ومور في علم الإناسة، بورديو وماكس فيبر وعلم الاجتماع، رولان بارت ودريدا واللسانيات الحديثة، إلخ.(14)
ومن الأمثلة العالميّة على محاولات الخروج والانفلات من قبضة الفلسفة الأكاديميّة التي عرضنا شيئا من آفاتها؛ تجربة المقاهي الفلسفيّة التي باتت تنتشر الآن في العديد من دول العالم.
ويضيف برونوفييه بأنّ "المظهر الأكثر إدهاشا في هذه الظاهرة يتمثل في عفويتها. وقد استندت في نشأتها وتطورها إلى المصادفة والاستقلال أكثر من استنادها إلى أي قرار مدبر أو منظم في عام 1992".(15)
روى مارك سوتيه (Marc Sautet) -وهو أستاذ في فلسفة العلوم السياسية- "في مقابلة إذاعية، ومن باب الدعابة، أنه يلتقي مع بعض الأصدقاء صباح كل يوم أحد في أحد المقاهي، في ساحة الباستيل في باريس، لكي يتفلسفوا. وكم كانت دهشته كبيرة عندما رأى يوم الأحد التالي عددا كبيرا من الأشخاص يقصدون ذلك المكان لكي يشاركوا في تلك النقاشات العفوية. وبما أن العدد أخذ يتزايد أسبوعا بعد أسبوع، فقد صار من الضروري إيجاد بعض قواعد العمل لئلا تغدو تلك التجمعات مجرد هذر فارغ".(15)
وهكذا ولد المقهى الفلسفي، وبدءا من عام 1995، رأت النور في باريس تجربتان أو ثلاث، وقد حفزتها مبادرات شخصية منقولة نوعا ما عن التجربة الأولى التي سمّاها مارك سوتيه؛ أي المقهى: "قهوة لسقراط". (16)
"فمعظم مدبري هذه النقاشات والقائمين على إدارتها هم أشخاص يشعرون بأنهم يمتلكون في آن واحد هوية فكرية وميلا اجتماعيا معينا. كما أن بعض المبادرات الأكثر تنظيما، والقائمة بصورة خاصة في المدن أو البلدات المتوسطة أو الصغيرة، قد عمدت إلى تنظيم هذا النشاط، وذلك باعتماد مدير له يقوم بتحكيم النقاش، وهو بصورة عامة مدرس فلسفة".(17)
منذ بداية هذه المسألة، وفي المنطقة الباريسية بصورة رئيسة حيث نظمت أوائل المقاهي الفلسفية، اتخذ معظم أساتذة الفلسفة موقفا رافضا إطلاق صفة "فلسفي" على هذه الأماكن. ويتلخص الرأي الشائع في هذه الأوساط بالتالي: "ثمة أماكن للتفلسف، والمقهى ليس أحدها، أو لن تطأ قدمي أبدا أرض المقهى الفلسفي".(17) في الواقع، لم يكن لدى معظم مديري النقاشات الأوائل إعداد فلسفي، الأمر الذي سوغ أكثر المظهر اللافلسفي لهذه المقاهي من الناحية الشكلية.(17)
إن أي محاولة لادعاء امتلاك الحقيقة تسيء إلى هذا المدير وتسقط مصداقيته تماما. من المؤكد أن له الحق في إبداء بعض الآراء الذاتية، لكن دوره هو قبل كل شيء دور الحكم، ويجب أن يبدي باستمرار قدرته على الاستماع وعلى التحليل. وعلى الرغم من أن هذه القواعد أساسية جدا، فإنها تشكل تحديا حقيقيا بالنسبة إلى الطريقة الاعتيادية للنقاش كما نمارسها في حياتنا. لكنها تمرين ممتاز من ناحية احترام الآخر والطبيعة المتسامحة للتبادل المعرفي، التي تتجاوز منطق المناظرة والاحتراب الفكري الذي يهدف إلى ظفر أحد المحاورين.(18)
لا ريب أن هناك مسلمات سابقة في هذه العملية، تعود بنا إلى سقراط وإلى تصرفه ومفهومه، حيث الفرضية الأساسية هي أن العقل البشري خلاق بصورة جوهرية وأن روحه -شرارة إلهية- مليئة بالأفكار، وأن المقصود بكل بساطة هو توليد هذه الأفكار وصياغتها، وهذه الأفكار، الواحدة بعد الأخرى، إما أن تكون مجهضة مشوهة، وإما أن تكون طفلا حيا جميلا.(18)
والمدير الأنشط والأكثر حضورا يمكنه أن يحدد بنفسه اختيار الموضوع بمقتضى ما يراه أكثر فائدة، وعلى وجه الخصوص، يتدخل بطرق مختلفة في الحديث لكي يرفع من قيمة رهاناته.
يتطلب مجموع هذه المداخلات بعض المواصفات لمدير الجلسة. فمن ناحية، هذا يتطلب انفتاحا عقليا كبيرا، ومن ناحية أخرى، يتطلب ثقافة فلسفية جيّدة، وأخيرا قدرة على التنقل سواء من أجل قراءة الإشكاليات كما يعبر عنها أو من أجل تجسيدها أو جعلها ذات شكل تربوي، رابطا بين المفهوم المجرد وما هو واقع معاش. وعلى هذا الصعيد، من غير المؤكد أن التأهيل التقليدي لأساتذة الفلسفة يكفي لتلبية هذه الشروط، ومن ينجحون في هذا التمرين إنما يفعلون ذلك لأسباب خاصة بهم.(20)
وختاما، فإنّ الأسباب التي تفسر ظهور الرغبة في التفلسف عند الإنسان متعددة، ويمكن مباشرة تحديد عاملين اثنين أكثر رجحانا من غيرهما:
1- فقدان الثقة بالمُثل الكبرى أو الأيديولوجيات الكبرى، سواء أكانت سياسية أو دينية.
2- الأزمة الاقتصادية مع نتائجها الاجتماعية. (20)
لكن من المؤكد أن "طريقة" براقة قد ظهرت، ولا يمكن إنكارها، كما يؤكد العدد الكبير والجدي من المشاركين أن شيئا ما جوهريا وواقعيا تبين أثره. والسؤال هنا: كم من الوقت ستدوم هذه الظاهرة؟ وماذا سيحل بها؟(20) وهل يمكن أن تصل عالمنا العربي؟!
من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، ولكن هل تكمن هنا مشكلة الفيلسوف؟ يبدو بالأحرى أن مسؤوليته إذا آمن أن مهمته تتطلب مسؤولية معينة في إنشاء المقهى الفلسفي هي في الإجابة عن قدرة وصول المقاهي الفلسفية إلى عالمنا العربي دون الاهتمام بشرعيته أو بافتعاليته. على أي حال، لا يمكن للفيلسوف أن يكتفي بتجاهل عصره، ما دام هذا العصر يضع عملية التفلسف على المحك بصورة جدية.

