بالرغم من حسن نوايانا.. هكذا يؤدي التعاطف مع الآخرين لنتائج غير أخلاقية

"أكبر عجز لدينا في مجتمعنا وفي العالم الآن هو عجز في التعاطف. نحن في حاجة ماسة إلى أن يكون الناس قادرين على وضع أنفسهم في مكان شخص آخر ورؤية العالم من منظوره".
(باراك أوباما)
لا يتعيّن عليك البحث عن اقتباسات توضح الحاجة إلى مزيد من التعاطف في المجتمع فهي كثيرة. وكما هو الحال مع اقتباس باراك أوباما أعلاه، نُشَجَّع على التعاطف مع الآخرين خاصة أولئك الذين يختلفون عنا. تكمن الرسالة الضمنية في هذه المناشدات بأن التعاطف سيجعلنا نتعامل مع بعضنا بعضا باحترام وسيساعد على تقليل العنف. لكن هل هذا صحيح؟ هل يجعلنا التعاطف نقدّر الآخرين أو يساعدنا على التصرف بطرق أخلاقية أو على اتخاذ قرارات أفضل؟
هذه هي الأسئلة التي يطرحها بول بلوم في كتابه "ضد التعاطف: مسألة التعاطف العقلاني" (Against Empathy: The Case for Rational Compassion). وكما يوحي العنوان، فإن كتاب بلوم يُرافع ضد التعاطف كقوة متأصلة للخير ويأخذ نظرة أقرب إلى ماهية التعاطف تحديدا وكيفية عمله في أدمغتنا، وكيف يمكن له أن يؤدي إلى نتائج غير أخلاقية على الرغم من نيّاتنا الحسنة، وكيف يمكننا تحسين قدرتنا على أن يكون لنا تأثير إيجابي من خلال تعزيز ذكائنا وتعاطفنا وضبط أنفسنا وتفكيرنا المنطقي. لاستكشاف هذه الأسئلة، نحتاج أولا إلى تحديد ما نتحدث عنه.
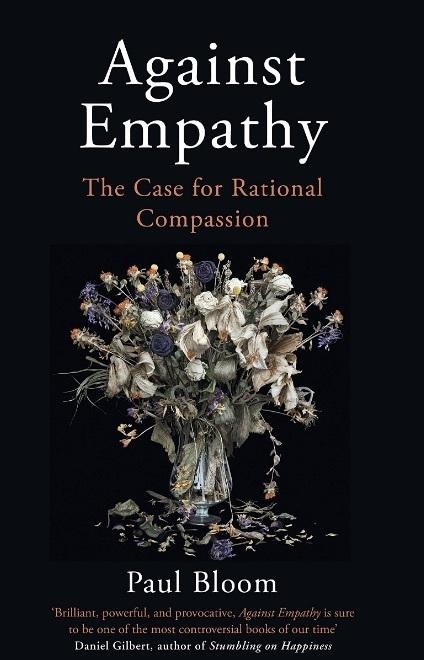
التعاطف هي كلمة متعددة الاستخدامات التي يمكن أن تعني أشياء مختلفة. يقتبس بلوم قول أحد الباحثين في التعاطف مازحا: "ربما عدد تعريفات التعاطف يماثل عدد الأشخاص العاملين على هذا الموضوع". يعرّف بلوم التعاطف بأنه "فعل الإقدام على تجربة العالم كما سيقوم بها شخص آخر حسب ظنك". وقد تم استكشاف هذا النوع من التعاطف من قِبل فلاسفة التنوير الاسكتلندي. كما قال آدم سميث، لدينا القدرة على التفكير في شخص آخر؛ "نضع أنفسنا في حالته ونصبح الشخص ذاته معه إلى حد ما، ومن ثم نشكّل فكرة عن أحاسيسه، وحتى نشعر بشيء ليس مختلفا عنه رغم ضعف هذا الشعور".
هذا هو نوع التعاطف الذي "تضع فيه نفسك في مكان شخص آخر" الظاهر في قول باراك أوباما أعلاه، والذي يصفه بلوم بالتقمّص العاطفي (التقامُص). تختبر في التقمّص العاطفي درجة أضعف مما يشعر به شخص آخر في الواقع. استطاع الباحثون في السنوات الأخيرة أن يثبتوا أن الاستجابات المتعاطفة مع الألم تحدث في المنطقة نفسها من الدماغ حيث يتم الشعور بالألم الحقيقي. لذلك فإنَّ عبارة "أشعر بألمك" ليست مجرد استعارة كلامية؛ إذ يمكن لها أن تحدث من الناحية العصبية في الجسم حرفيا: آلام الناس الأخرى تقوم بالفعل بتفعيل منطقة الدماغ نفسها مثلها مثل ألمك، وبشكل أعم، هناك أدلة عصبية لمراسلات بين الذات والآخرين.
ولجعل استعارة "ضع نفسك مكان الآخرين" حرفية، تخيّل أنك ترى شخصا ما يُسقِط شيئا ثقيلا على قدمه، فإنك تجفل لأنك تعرف ماهية الشعور بذلك، وتستجيب أجزاء الدماغ التي تعاني من الألم (القشرة الجزيرية والقشرة الحزامية). لا تشعر بدرجة الألم نفسها بالطبع إذ لم تُسقط أي شيء على قدمك في تلك اللحظة في نهاية المطاف، ولكن من المحتمل أن يكون لديك رد فعل جسدي غير طوعي كأن تجفل أو تُكشِّر أو تصيبك نوبة غضب مسموعة؛ هذا هو التقمّص العاطفي.
ولكن هناك نوع آخر من التعاطف الذي يريد بلوم أن نكون على دراية به وأخذه في الاعتبار بشكل مختلف؛ إنه يتعلق بقدرتنا على فهم ما يجري في عقول الآخرين. يشير بلوم إلى هذا الشكل بالتعاطف المعرفي. إذا كنت أفهم أنك تتألم من دون أن أكون أنا المصاب، فهذا ما يصفه علماء النفس بالإدراك الاجتماعي أو الذكاء الاجتماعي أو قراءة العقل أو نظرية العقل أو التفكير الذهني. كما يُوصف أحيانا بأنه شكل من أشكال التعاطف؛ "التعاطف المعرفي" في مقابل "التقمّص العاطفي".
وبهذا المعنى، فإن التعاطف المعرفي يعبّر عن قدرتنا على فهم ما يجري في عقول الآخرين. في حالة الألم -حيث يتم إجراء الكثير من الأبحاث حول التعاطف- فإننا لا نتحدث عن الشعور بأي درجة من الألم كما قد يحدث في التقمّص العاطفي، ولكننا بدلا من ذلك، نفهم ببساطة أن الشخص الآخر يشعر بالألم دون الشعور به بأنفسنا. يتجاوز التعاطف المعرفي الألم، إن قدرتنا على فهم ما يحدث في عقل شخص آخر هو جزء مهم من إنسانيتنا وحاجتنا إلى الارتباط ببعضنا البعض.
التعاطف والتراحم هما مرادفان في العديد من القواميس ويُستخدَمان كثيرا بالمعنى نفسه، ولكن لهما خصائص مختلفة. الدماغ بطبيعة الحال معقد للغاية، لذلك فمن المعقول أن هذين النوعين من التعاطف يمكن أن يحدثا في الجزء نفسه من الدماغ. تشير الأبحاث حتى الآن إلى أنهما منفصلان إلى حد كبير.
ذكر كلٌّ من جميل زكي وكيفن أوشسنر في أحد مقالات المراجعات الأدبية أن المئات من الدراسات تدعم الآن وجهة نظر معينة حول العقل، والتي يسمونها "حكاية نظامين". نظام ينطوي على مشاركة تجارب الآخرين والذي أطلقنا عليه التعاطف، أما النظام الآخر ينطوي على استنتاجات حول الحالات العقلية للآخرين والذي نسميه قراءة العقول. في حين يمكن أن يكونا نشطيْن في آنٍ واحد، وغالبا ما يكونان كذلك، فإنهما يشغلان أجزاء مختلفة من الدماغ. على سبيل المثال، القشرة الأمامية الجبهية الوسطى -خلف الجبين مباشرة- تشارك في قراءة العقول، في حين أن القشرة الحزامية الأمامية الواقعة خلفها مباشرة تشارك في التعاطف.
يعتبر الفرق بين التعاطف المعرفي والتقمّص العاطفي مهما لفهم حجج بلوم؛ من وجهة نظر بلوم، فإن التعاطف المعرفي هو أداة مفيدة وضرورية لأي شخص يرغب في أن يكون شخصا جيدا، ولكنها محايدة من الناحية الأخلاقية. من ناحية أخرى يرى أن التقمّص العاطفي عبارة عن تآكل أخلاقي، ويهدف الجزء الأكبر من هجوم بلوم إلى تسليط الضوء على مخاطر الاعتماد على التقمّص العاطفي بينما يبرز أهمية صقل التعاطف العقلاني وممارسته بدلا من ذلك.
أعتقد أن القدرة على التقمّص العاطفي التي وصفها فلاسفة مثل آدم سميث وديفيد هيوم بالتعاطف والتي دافع عنها الكثير من العلماء واللاهوتيين والمعلمين والسياسيين هي عبارة عن تآكل أخلاقي في الواقع. إذا كنت تعاني من قرار أخلاقي وتجد نفسك تحاول أن تشعر بألم أو متعة شخص آخر، فعليك التوقف. قد يُشعِرك هذا التقمّص العاطفي ببعض الارتياح، ولكن لن يحسِّن الأمور، كما يمكن أن يؤدي إلى قرارات سيئة ونتائج سيئة. من الأفضل استخدام المنطق وتحليل جدوى التكاليف بالاعتماد بنسبة أقل على التعاطف واللطف.
من المهم هنا أيضا تعريف الشفقة والتعاطف وهما مصطلحان مترادفان في العديد من القواميس، ويُستخدمان بالتبادل، ولكن لهما خصائص مختلفة. الشفقة والقلق أكثر انتشارا من التعاطف، من الغريب أن نتحدث عن التعاطف عند حديثنا عن ملايين ضحايا الملاريا مثلا، ولكن من الطبيعي أن تقول إنك تشعر بالقلق أو الرحمة إزاءهم. كذلك لا تتطلب الرحمة والقلق انعكاسا لمشاعر الآخرين، إذا كان أحد ما يعمل لمساعدة ضحايا التعذيب ويفعل ذلك من خلال دعمهم وتشجيعهم، فليس من الصواب القول إنه يشعر بالشفقة أو الرحمة تجاههم، إذ إنهم يتعاطفون مع الأفراد الذين يساعدونهم، لذا من الأفضل القول إنه يشعر بالتعاطف تجاههم.
يشير بلوم إلى ورقة مراجعة أدبية كتبتها تانيا سينغر وأولغا كليمكي للمساعدة في توضيح هذا التمييز. حيث تريان إن التراحم لا يعني تقاسم معاناة الآخر، على النقيض من التعاطف، بل يتّصف بمشاعر الدفء والاهتمام ورعاية الآخر، وكذلك هو دافع قوي لتحسين رفاه الآخر. الشفقة هي شعور تجاه الآخرين وليس الشعور بالآخرين.
يمكن وصف التقمص العاطفي ببساطة بأنه "الشعور بما يشعر به الآخرون"، أما التعاطف المعرفي فهو "فهم ما يشعر به الآخرون"، أما التراحم "الاهتمام بما يشعره الآخرون".
يعتقد الكثير من الناس أن قدرتنا على التعاطف هي أساس الأخلاق لأنها تجعلنا ننظر في أعمالنا من وجهة نظر الآخرين. "تعامل الآخرين كما تحب أن تُعامَل" هو الدرس الأخلاقي الأساسي الذي يُلقى آلاف المرات على مسامع الأطفال في جميع أنحاء العالم.
بهذه الطريقة، يمكن أن يقودنا التعاطف إلى الاعتماد على طبيعتنا الأنانية. يوجّهنا التعاطف إلى التعامل مع الآخرين أثناء تعاملنا مع أنفسنا، وبالتالي توسيع اهتماماتنا الأنانية لتشمل الآخرين. وبهذه الطريقة، يمكن لممارسة التعاطف المتعمَّدة أن تحفِّز العطف الذي لم يكن ليحدث على الإطلاق لولا التعاطف. كما يمكن له أن يجعلنا نهتم بعبد أو شخص بلا مأوى أو شخص في الحبس الانفرادي، يمكن أن يضعنا في عقل ضحية اغتصاب، يمكننا أن نتعاطف مع عضو من أقلية محتقَرة أو شخص يعاني من الاضطهاد الديني في أرض بعيدة عنا. كل هذه التجارب غريبة عنا، لكن من خلال ممارسة التعاطف نستطيع بطريقة محدودة تجربتهم بأنفسنا، ويجعلنا ذلك أشخاصا أفضل.
عندما ننظر إلى محنة الآخرين من خلال تخيّل أنفسنا في وضعهم، فإننا نعاني من رد فعل تعاطفي قد يؤدي بنا إلى تقييم أخلاقيات أفعالنا.

في مقابلة، افترض ستيفن بينكر أن الزيادة في التعاطف بفضل تكنولوجيا الطباعة والزيادة الناتجة في محو الأمية هي التي أدّت إلى الثورة الإنسانية أثناء عصر التنوير. الزيادة في التعاطف الناجمة عن قدرتنا على قراءة الروايات عن العقوبات العنيفة مثل نزع الأحشاء والبتر، دفعتنا لإعادة النظر في أخلاقيات معاملة الآخرين بهذه الطريقة. لذلك في حالات معينة، يمكن أن يلعب التعاطف دورا في تحفيزنا على اتخاذ إجراءات أخلاقية. ولكن هل استجابة التعاطف لازمة للقيام بذلك؟
لاستخدام مثال كلاسيكي من الفلسفة -الذي طرحه الفيلسوف الصيني منسيوس- تخيل أنك تسير بجوار بحيرة وترى طفلا صغيرا يكافح في المياه الضحلة. إذا استطعت أن تدخل في الماء بسهولة، فعليك أن تفعل ذلك، سيكون من الخطأ المضي بطريقك.
ما الذي يحفّز هذا العمل الجيد؟ من الممكن أن تتخيل الشعور بالغرق أو تتوقع ما سيشعر به والدا الطفل عند السماع بغرقه. يمكن لمثل هذه المشاعر التعاطفية تحفيزك على التصرف. لكن هذا يكاد لا يكون ضروريا، لست بحاجة إلى التعاطف لإدراك أنه من الخطأ ترك طفل يغرق. أي شخص عادي سوف يقفز في المياه لينقذ الطفل دون أن يكلف نفسه عناء أي من هذه المتغيرات العاطفية.
ولذا يجب أن يكون هناك أخلاق أكثر من التعاطف: قراراتنا حول ما هو صحيح وما هو خطأ، ودوافعنا للعمل، لديها العديد من المصادر. يمكن أن تكمن جذور الأخلاق في نظرة دينية للعالم أو نظرة فلسفية. يمكن أن يكون الدافع وراء ذلك هو الاهتمام الأكثر انتشارا بمصير الآخرين، وهو أمر غالبا ما يُوصف بأنه قلق أو شفقة.
آمل أن يوافق معظم الناس الذين يقرؤون هذا على أن الفشل في محاولة إنقاذ طفل غارق أو دعم أو ارتكاب عقوبات عنيفة مثل نزع الأحشاء سيكون على الأقل شأنا يستحق الاستنكار أخلاقيا، إن لم يتم اعتباره الشر بعينه. لكن ما الذي يحفّز الناس على أن يكونوا "أشرارا"؟ بالنسبة للباحثين من أمثال سايمون بارون كوهين، يُعرَّف الشر بأنه "تآكل التعاطف"، فالناس السيئون حقا يفتقرون إلى القدرة على التعاطف، وهذا الافتقار هو الذي يجعلهم يتصرفون بطرق شريرة. ينظر بلوم إلى الأمر من زاوية مختلفة قليلا.
في الواقع، يجادل البعض بأن الجُناة ليسوا أشرارا بوعي منهم وعن قصد، بل لأنهم يعتقدون أنهم يفعلون الخير؛ إذ يتغذّون على إحساس أخلاقي قوي. عندما يعتقد مرتكبو العنف أو الوحشية أن أفعالهم مبررة أخلاقيا، ما الذي يحفزهم؟ يقترح بلوم أنه يمكن أن يكون التعاطف. التعاطف غالبا ما يجعلنا نختار الجوانب، لاختيار من يتعاطف معه؛[1] يظهر ذلك جليا في السياسة طوال الوقت.
يعتقد السياسيون الذين يُمثّلون أحد الأطراف أنهم ينقذون العالم، في حين يعتقد ممثلو الطرف الآخر أن خصومهم هم من يدمرون الحضارة كما نعرفها. إذا كنت أعتقد أنني أقوم بحماية شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين اخترت التعاطف معهم، فقد يكون لدي الدافع للتصرف بطريقة أعتقد أنها مبررة من الناحية الأخلاقية على الرغم من أن الآخرين قد يعتقدون أنني آذيتهم.
تناول ستيفن بينكر هذا الأمر عندما كتب ما يلي في كتاب "أفضل جوانب طبيعتنا": إذا أضفت جميع جرائم القتل التي ارتُكِبت في سعيها لتحقيق العدالة الذاتية وخسائر الحروب الدينية والثورية والأشخاص الذين أُعدموا لجرائم لا يحاسب عليها القانون ومستهدَفي الإبادة الجماعية الأيديولوجية، فإنهم سيفوقون بالتأكيد عدد الوفيات الناجمة عن الافتراس غير الأخلاقي والغزو.
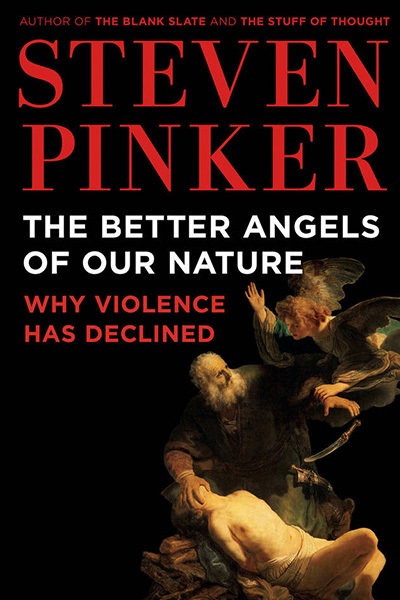
وضع هنري آدامز هذا بعبارات أقوى: "الرجال الطيبون هم الذين يلحقون الأذى الأكبر في العالم دائما". قد يبدو قول ذلك منحرفا: كيف يمكن أن يؤدي الخير إلى الشر؟ هناك شيء واحد يجب أخذه في الاعتبار هنا وهو أننا مهتمون بالمعتقدات والدوافع، وليس ما هو جيد بمعنى وبآخر. إذن، الفكرة ليست أن الشر جيد، بل أن الشر هو ما يقوم به أولئك الذين يعتقدون أنهم يفعلون الخير.
لذلك من منظور أخلاقي، يمكن أن يقودنا التعاطف إلى الضلال. قد نعتقد أننا نقوم بعمل جيد أو أن أفعالنا مبررة ولكن ذلك قد لا يكون صحيحا بالضرورة لجميع المعنيين. هذا أمر مزعج بشكل خاص عندما ننظر في كيفية تأثّرنا بقائمة متنامية من التحيّزات المعرفية.
في حين قد لا يكون التعاطف ضروريا لتحفيزنا لإنقاذ طفل يغرق، فإنه لا يزال يمكن أن يساعدنا في النظر في تجارب مختلفة أو معاناة شخص آخر، مما يحفّزنا على النظر في الأمور من وجهة نظرهم أو بالتالي العمل على التخفيف من معاناتهم: أرى المراهق الذي يتعرّض للتنمّر وقد أميل في البداية إلى الانضمام إلى المتنمّرين عليه من منطلق السادية أو الملل أو الرغبة في الهيمنة أو الشهرة، لكنني أتعاطف معه -أشعر بألمه، أشعر بما يكون عليه حين أتعرّض للتنمّر- لذلك لا أضيف إلى معاناته. ربما أقف حتى للدفاع عنه. التعاطف مثل ضوء كشاف مسلَّط على الاهتمام والمساعدة حيث هناك حاجة إليه.

ظاهريا، يبدو هذا كحالة ممتازة للقوة الإيجابية للتعاطف. يُسلَّط "الضوء الكشاف" على الشخص المحتاج ويحفزنا على مساعدته. ولكن ماذا يحدث عندما نحفر أعمق قليلا في هذه الاستعارة؟ الأضواء لديها تركيز ضيق، وهذه إحدى مشاكل التعاطف، إنه ضعيف في عالم حيث يوجد العديد من الأشخاص المحتاجين وحيث تكون تأثيرات أفعال المرء منتشرة وغالبا متأخرة ويصعب حسابها، عالم يمكن أن يؤدي فيه عمل يساعد شخصا ما هنا وفي الحاضر إلى معاناة في المستقبل.
علاوة على ذلك، ينير الضوء الكشاف ما يشير إليه فقط، لذا فإن التعاطف يعكس انحيازنا. على الرغم من أننا قد نعتقد من الناحية الفكرية أن معاناة جارنا هي نفس معاناة شخص ما يعيش في بلد آخر، فإنه من الأسهل بكثير أن نتعاطف مع من هم قريبون منا، ومن هم أشبه بنا، وأولئك الذين نراهم أكثر جاذبية أو ضعفا وأقل إخافة. في هذا الصدد، يشوّه التعاطف أحكامنا الأخلاقية إلى حد كبير بالطريقة نفسها التي يعمل بها التحيّز.
جميعنا مهيأون للاهتمام بشكل أكثر عمقا لمن نحن قريبون منه. من منظور بيولوجي محض، سنهتم بحماية أطفالنا وعائلاتنا مقابل أطفال أو عائلات الغرباء. غالبا ما يقع اتخاذ قرارنا ضحية لتأطير ضيق، وتتأثر تصرفاتنا بالتحيزات مثل الإعجاب والمحبة والكراهية والميل إلى التخفيف من ألم الأشخاص الذين لا نحبهم[2].
نُفضّل بطبيعتنا أصدقاءنا وعائلاتنا على الغرباء، والاهتمام أكثر بأعضاء مجموعتنا الخاصة أكثر من الناس من مجموعات مختلفة. هذه الحقيقة عن الطبيعة البشرية أمر لا مفر منه بالنظر إلى تاريخنا التطوري. أي مخلوق لم يكن لديه مشاعر خاصة تجاه أولئك الذين يشاركون جيناته ويساعدهم في الماضي سوف يُقضى عليه. هذا التحيز لتفضيل المقربين منا هو أمر عام، فهو يؤثر على من نتعاطف معه، كما يؤثر أيضا على من نحب ومن نميل إلى الاهتمام به ومن سننضم إليه ومن سنعاقبه وما إلى ذلك.
هناك العديد من الأسباب للتحيزات البشرية، ولكن مع العودة إلى الوراء، يمكننا أن نرى كيف يمكن للاستجابات الحدسية الفطرية التي يحفزها التقمص العاطفي أن تؤثر سلبا على قدرتنا على اتخاذ قرارات عقلانية. يعني تركيز التعاطف الضيق وخصوصيته أنه سيتأثّر دائما بما يجذب انتباهنا، عن طريق التفضيلات العنصرية وما إلى ذلك. فقط عندما نهرب من التعاطف ونعتمد بدلا من ذلك على تطبيق القواعد والمبادئ أو حساب الجدوى يمكننا إلى حد ما على الأقل أن نصبح عادلين ومحايدين.
في حين أن الكثير منا متحمسون ليكونوا جيدين ويتخذون قرارات جيدة، فإنها ليست نهائية وغير قابلة للتغيير. تتأثر تفضيلاتنا في تقديم المساعدة أو دعم المنظمات بتحيّزات لدينا. إذا لم نكن حذرين، يمكن أن يؤثر التعاطف على قدرتنا على رؤية التأثيرات المحتملة لأفعالنا. ومع ذلك، فإن أخذ هذه الآثار بعين الاعتبار يتطلّب أكثر من التعاطف والرغبة في فعل الخير، يستلزم إدراك تحيزاتنا وجهدا ذهنيا لمكافحة آثارها. الاستنتاج ليس أن المرء لا ينبغي أن يكون معطاء، بل بالأحرى يجب على المرء أن يكون معطاء بذكاء مع الحرص على أخذ العواقب بعين الاعتبار لتجنب الوقوع في فخ التعاطف.
جزء من التحدي الموجود في التعاطف أنه من المستحيل بالنسبة لنا أن نشكّل روابط تعاطف حقيقية مع التجريدات. وعلى العكس من ذلك، إذا رأينا معاناة شخص ما من أمر مجرّد، فإن التعاطف يمكن أن يحفزنا على المساعدة في وقفه. كما قالت الأم تيريزا: "إذا نظرت إلى الجموع لن أتصرف أبدا. إذا نظرت إلى ذلك الفرد، سأفعل". هذا ما يسميه علماء النفس "تأثير الضحية التي يمكن التعرف عليها".
قد تساعدك القصة التالية على فهم ذلك، في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول عام 1987، سقطت جيسيكا مكلور البالغة من العمر 18 شهرا في قعر بئر بعمق 270 سم في الفناء الخلفي لمنزلها في ميدلاند، تكساس. على مدار اليومين ونصف التاليين، عملت فرق الإنقاذ والشرطة على مدار الساعة لإنقاذها. تم بث التغطية الإعلامية لحالة الطوارئ هذه في جميع أنحاء العالم لتصبح جيسيكا مكلور معروفة دوليا باسم "بيبي جيسيكا"، ودفعت الرئيس رونالد ريجان إلى إعلان أن "أصبح الجميع في أميركا عرّابي وعرّابات جيسيكا". أدت التغطية المكثفة والوعي العالمي إلى تدفق التبرعات، مما أدى إلى تأسيس ائتمان بقيمة 800،000 دولار باسم جيسيكا.
ما الذي دفع هذا التدفق الهائل للقلق والدعم؟ هناك ملايين الأطفال المحتاجين كل يوم في جميع أنحاء العالم. كم من الأشخاص الذين أرسلوا تبرعات لبيبي جيسيكا حاولوا مساعدة هؤلاء الأطفال مجهولي الهوية؟ في حالة بيبي جيسيكا، كان لديهم ضحية يمكن التعرف عليها، وكان التعاطف يدفع الكثير منهم لمساعدة جيسيكا وعائلتها. يمكن أن يتخيلوا ما قد يشعر به هؤلاء الآباء الفقراء وأنهم يشعرون بقلق حقيقي على مستقبل الطفل. جميع الأطفال المحتاجين الآخرين في جميع أنحاء العالم كانوا عبارة عن إحصاءات مجردة. هذه القدرة على تحديد وجه الطفل المعذب وأسرته تُمكّننا من تجربة استجابة متعاطفة معهم، ولكنّ الأطفال العشوائيين وعائلاتهم لا يزالون بعيدا عن تعاطفنا.
لا شيء من هذا يعني أن عمال الإنقاذ لا يجب أن يعملوا على إنقاذ جيسيكا مكلور، فقد كانت مثالا واقعيا على مثال منسيوس عن الطفل الغارق. لكن هناك حالات كل يوم نختار فيها مساعدة الأفراد على حساب استمرار معاناة الآخرين، أعمالنا غالبا ما يكون لها آثار منتشرة وغير معلومة.
إذا كان قلقنا مدفوعا بأفكار معاناة أفراد معينين، فإنه يُنشِئ وضعا معاكسا حيث يمكن لمعاناة المرء أن تكون أكثر أهمية من معاناة ألف شخص. علاوة على ذلك، ليس من المرجح فقط أن نتعاطف مع الضحية المعروفة، بل إن تعاطفنا له حدود في نطاقه أيضا. إذا سمعنا أن شخصا في أرض بعيدة يعاني، قد يكون لدينا استجابة تعاطفية، ولكن هل سيتم زيادة هذا الرد بشكل تناسبي إذا علمنا أن الآلاف أو الملايين من الناس عانوا ذات الأمر؟

كتب تشارلي منغر وتكلم عن "ميل العدالة الكانطي" نسبة إلى إيمانويل كانط، الذي يقترح فيه أن بعض الأنظمة تكون أخلاقية للكثير، يجب أن تكون غير عادلة للقلة.[3]
نحن مخلوقات عاطفية، لكننا أيضا كائنات عقلانية، ولدينا القدرة على اتخاذ قرار عقلاني. يمكننا تجاوز عواطفنا وتغييرها وكثيرا ما ينبغي لنا أن نفعل ذلك. ليس من الصعب رؤية هذا من أجل مشاعر مثل الغضب والكراهية، إذ من الواضح أن هذه الأمور يمكن أن تقودنا إلى الضلال، وأننا نفعل ما هو أفضل عندما لا تتحكم بنا وعندما نكون قادرين على التحايل عليها.
بينما نحتاج إلى العطف والتعاطف، علينا أن نسعى جاهدين لنكون أناسا صالحين يتخذون قرارات جيدة، ولكننا لا نخدم بالضرورة التعاطف في هذا الصدد، غالبا ما تفوق سلبيات التقمّص العاطفي إيجابياتها. بدلا من ذلك، يجب أن نعتمد على قدرتنا على التفكير والتحكم في عواطفنا. التعاطف ليس شيئا يمكن إزالته أو تجاهله، إنه وظيفة طبيعية لأدمغتنا على كل حال، لكننا نستطيع أن نجمع العقل مع غرائزنا الطبيعية وحدسنا.
إن الفكرة القائلة بأن الطبيعة البشرية لها وجهان متعارضان: العاطفة مقابل العقل، والحدس مقابل المداولات الحكيمة العقلانية، وهي النظرية النفسية الأقدم والأكثر مرونة على الإطلاق، كانت موجودة في زمن أفلاطون، وهي الآن جوهر الحساب المدرسي للعمليات المعرفية، التي تفترض الثنائية بين العمليات العقلية "الساخنة" و"الباردة" وبين النظام الحدسي (النظام الأول) والتداولي (النظام الثاني).
نعلم من تفكير دانيل كانيمان أن هذين النظامين ليسا منفصلين بشكل أساسي في الممارسة، يعمل كلاهما في أدمغتنا في الوقت نفسه. يتم اتخاذ بعض القرارات بشكل أسرع بسبب الاستدلال والحدس من التجارب أو طبيعتنا البيولوجية، في حين يتم اتخاذ القرارات الأخرى بطريقة أكثر تداولا وبطئا باستخدام المنطق.
نمر بعملية عقلية تسمى "الاختيار"، حيث نفكر في عواقب أفعالنا. لا يوجد شيء سحري حول هذا، إذ يتوافق الأساس العصبي للحياة العقلية بشكل كامل مع وجود مداولات واعية وعقلانية مع الأنظمة العصبية التي تقوم بتحليل الخيارات المختلفة وبناء سلاسل منطقية من الحجة والمنطق من خلال الأمثلة والمقارنات والاستجابة للعواقب المتوقعة لأفعالنا.
لدينا نظام اتخاذ القرار المتسرع والعاطفي والبديهي في النظام الأول، ونظام اتخاذ القرار المنطقي والتداولي (وأحيانا) العقلاني في النظام الثاني.
سوف تكون لدينا دائما ردود فعل عاطفية، لكن في المتوسط سيتم تحسين عملية صنع القرار لدينا من خلال تحسين قدرتنا على التفكير بدلا من تعزيز قدرتنا على التعاطف. إحدى طرق زيادة قدرتنا على التفكير هي التركيز على تحسين ضبط أنفسنا.
يمكن النظر إلى ضبط النفس على أنه أنقى تجسيد للعقلانية من حيث إنه يعكس عمل نظام دماغي (مضمن في الفص الجبهي الواقع خلف الجبين) يقيّد رغباتنا المتهورة أو غير العقلانية أو العاطفية.
في حين أن بلوم لا يعارض التقمص العاطفي كقوة متأصلة للخير في العالم، فهو أيضا مؤيد قوي للوجود والقيام بعمل جيد. وهو يعتقد أن طبيعة الشعور "بالآخرين" ضمن التعاطف تقودنا إلى اتخاذ قرارات متحيزة وسيئة على الرغم من نيّاتنا الحسنة، وأنه ينبغي لنا بدلا من ذلك أن نشجع وندعم طبيعة "الاهتمام" المتأصلة في التراحم بينما نجمعها مع ذكائنا وضبطنا لذاتنا والقدرة على التفكير منطقيا.
لا شيء من هذا يشكّل إنكارا لأهمية صفات مثل التراحم والطيبة، نريد أن نعزز هذه الصفات في أطفالنا ونعمل على إرساء ثقافة تكرّم وتكافئ هذه الصفات. ولكنها ليست كافية لجعل العالم مكانا أفضل، نود أيضا أن يتبارك الناس بمزيد من الذكاء والمزيد من ضبط النفس، فهذه الأمور أساسية في قيادة حياة ناجحة وسعيدة وحياة جيدة وأخلاقية.
_________________________________________
ترجمة آلاء أبو رميلة
هذا التقرير مترجم عن Farnam Street ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.

