طقوس انتحارية وتوبة جماعية.. كيف واجهت الأديان الأوبئة؟

اضغط للاستماع
"يُثبت الكتاب المقدس بوضوح أن الرب ربما يُشهر سيفه، بقدرته ومشيئته، أو يسدد القوس، أو يطلق سهام الموت.. وفي هذه العدوى التي أمامنا تتجلى آثار القدير بوضوح".
(الطبيب نتانيال هودجز متحدثا عن طاعون لندن الكبير) (1)
بدا المشهد غريبا واستثنائيا وأقرب للخيال، نيويورك المدينة التي لا تنام تغط اليوم في سبات عميق وتخضع مجبرة للحجر صحي بعد أن نخرها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وجعل منها بؤرة جديدة لتفشي الوباء. كل شيء توقف تقريبا، إلا ذلك الصمت الذي يصرخ في كل مكان، مُنذرا بقرب عاصفة الموت "المؤلمة جدا جدا" كما وصفها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وسط هذا المشهد خرج شاب أميركي وسط نيويورك ليُذكِّر الناس بقرب خروج المسيح وقرب ساعة القيامة، داعيا إياهم إلى التوبة من الخطيئة، خطايا نيويورك التي ملأت كأس الرب غضبا -على حد وصفه-، وصرخ مُحذِّرا: "هل سمعتِ صوت الرب اليوم يا نيويورك؟ هو وحده الذي يمكنه شفاء هذه الأرض من الأوبئة، من الفيروسات والبكتيريا".
رغم أن بلاده تتقدّم دول العالم في بحثها المضني عن لقاح لفيروس كورونا، وأن رئيسه أكّد أن أميركا لن تهدأ حتى تجد مخرجا للعالم من هذا الوضع الصعب، فإن هذا الشاب الأميركي المسيحي لا يرى حلا حقيقيا سوى التدخُّل من السماء، تماما كغيره من الكثيرين الذين يرون في الدين والإيمان السلاح الأول والأبرز لمواجهة الوباء، خاصة حينما يقف العلم حائرا.
على الجانب الآخر، وكما ظهر من خلال النقاشات المشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت شريحة أخرى ترى أنه في وقت أزمة كهذه يجدر بالدين العودة إلى الصوامع والأديرة وترك المجال للعلم التجريبي القادر وحده على مواجهة الطبيعة بشرورها وكوارثها وبطشها، وذلك على اعتبار أن الدين ليس فقط عاجزا عن الانتصار في معركة كهذه، بل قد يزيد الطين بلة بسبب اعتماد عدد من أتباعه على التفكير غير العقلاني -على حد وصف هذا الفريق- ما قد يعقد الأمور أكثر فأكثر.
خلال هذا التقرير سنحاول التعرف على الدور الذي لعبه ويلعبه الدين في مواجهة الكوارث الطبيعية كالأوبئة مثلا، كيف ومتى قد يكون تدخُّله كارثيا؟ وكيف يمكنه بالمقابل أن يلعب دورا فعالا يساعد البشر على تجاوز طوفان الكوارث الطبيعية بأقل خسائر ممكنة؟

العنصرية كلقاح لإطفاء "غضب الرب"
عاشت البشرية عبر التاريخ تحديات جمّة، انقراضات وزلازل ومجاعات وجفاف وأوبئة مختلفة وغيرها مما ضرب مناطق بأسرها في هذا العالم، لتقتل الملايين، ولتُنهيَ مسيرةَ دول وحضارات، ولتُساهم أيضا في ظهور أخرى، وغيّرت الجغرافيا إلى الأبد، وكتبت بحبر من دم تاريخا بقي محفورا في ذهن الإنسان وجسده من أدنى الأرض إلى أقصاها.
أحد أهم هذه الامتحانات كان وباء الطاعون، الوباء الأشهر الذي فتك بأرواح ملايين من الناس، من الصين حتى أوروبا. نعم، الطاعون أمر جلل، إذ لم يكن محل اهتمام الطب والعلم التجريبي فقط، بل نزل فيه وحي من السماء عبر الأحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت عن هذا الوباء الفتاك.
وبالتعريج سريعا على الوصف العلمي للطاعون، فهو مرض تُسبِّبه باكتيريا حيوانية تسمى "اليرسنية الطاعونية"، وتوجد عادة لدى صغار الثديات والبراغيث المعتمدة عليها. تنتقل عدوى الطاعون عبر لدغة من البراغيث المصابة بعدوى المرض أو بالملامسة المباشرة للأنسجة الملوثة بعدواه أو باستنتشاق الرذاذ المنبعث من الجهاز التنفسي للشخص المريض، وينقسم إلى نوعين؛ الطاعون الرئوي، والطاعون الدبلي، وهذا الأخير هو الأكثر شيوعا، ومن أعراضه ظهور تورمات مختلفة بالجسم.

شهد العالم مجموعة من الطواعين التي كانت تظهر لشهور أو سنوات وأحيانا لقرون ثم تختفي، منها المحلية كطاعون عمواس الذي ظهر أثناء فترة خلافة عمر بن خطاب -رضي الله عنه-، والذي سمي بهذا الاسم (عمواس) بسبب ظهوره أول الأمر بقرية عمواس الفلسطينية، ومنها العالمية كطاعون جستنيان الذي ظهر ما بين سنتَيْ 541-750 ميلادية وقتل ما بين 30-50 مليون إنسان، أو طاعون الموت الأسود الذي انطلق من الصين بداية القرن 14 الميلادي وتفشى في أوروبا التي قتل فيها نحو 50 مليون شخص، أي ما يعادل ثلث سكان القارة آنذاك، لكنه لم يقف عند هذا الحد، بل جال الكرة الأرضية حتى وصل إلى المشرق الإسلامي، وحصد نحو 150 مليون شخص خارج القارة العجوز.
في الغرب، شكَّل الطاعون تحديا كبيرا للكنيسة وأوروبا المسيحية التي عاد إليها في منتصف القرن الرابع عشر بعد زيارتين سابقتين خلال القرنين السادس والسابع الميلادي، ولم يكن هذا الوباء الذي وصل من الشرق الأقصى سهلا، بل كان موتا حقيقيا، يحصد حياة المئات بل والآلاف يوميا، الأعراض لم تكن تتأخر والموت كان أسرع وأقرب للمريض من كل شيء. وعلى عكس فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي قد لا تبدأ أعراضه في الظهور إلا بعد أسبوع أو أكثر من احتضان المريض للفيروس، كان الطاعون يظهر بسرعة ويقتل صاحبه بسرعة أكبر، خلال أيام وأحيانا ساعات فقط.
وكان المُعطى الأهم في محاربة أي عدو هو بالطبع جمع أكبر عدد من المعلومات عنه، لكن الوضع العلمي والديني والفكري في أوروبا كان أبعد ما يكون عن التوصل للسبب الذي يقف وراء ظهور الطاعون، حيث كان الفكر المسيحي/اليهودي يعتبر أن البشر نوع خاص من المخلوقات، هم وحدهم الذين يملكون روحا، ولأن كل الأشياء الحية ترتبط بسلسلة عظمى حسب ما تدّعيه الفلسفة الأفلاطونية المحدثة، فإن البشر موجودون في المركز الرابع بعد الصحبة السماوية ورؤساء الملائكة ثم الملائكة، فالنوع البشري في علاقة فريدة مع الله ويبتعد بمراكز عديدة بطبيعة الحال عن الفئران الموجودة في آخر الترتيب، وهذه النظرية الدينية ساهمت بشكل كبير في عرقلة الاعتراف برابطة محتملة بين الإنسان والفئران، وبالتالي كانت المخيلة الأوروبية عاجزة عن التوصل إلى الطريقة التي ينتشر بها الطاعون(2).

في تلك اللحظات الصعبة، ومع انتشار الموت وامتلاء الطرقات بالجثث، توجّه الناس -طوال تاريخهم- إلى الإله لطلب الحماية والجوار من قوى الشر وقوى الطبيعة، وعلى الطريق ذاته سار الغرب الذي حاول التقرب من "الرب" لدفع الطاعون وإبعاد هذا البلاء الذي يفتك بالناس،هكذا بحثت الكنائس الأوروبية عن سبب غضب الرب الذي جعله "يُنزل اللعنة على عباده"، وتحت تأثير رجال الدين اتفق الجميع على أن الوباء لن يرتفع إلا عندما يُستأصل غير المؤمنين بالمسيح المخلص، فانطلقت حملة إبادة عِرقية عنيفة في حق اليهود خلال هذه الفترة، وكان استهداف اليهود مبررا في نظر الأوروبيين، فهم من نسل الأشخاص الذين يُعتقد أنهم صلبوا المسيح، كما أنهم مميزون بلباسهم الذي فُرض عليهم ابتداء من سنة 1215م.
ورغم معارضة البابا كلمنت السادس صاحب الحظوة والجاه آنذاك لهذه التصفيات العِرقية التي تتم في حق اليهود الذين يتعرّضون كذلك للإصابة بالطاعون والموت، فإن المتحمسين من المسيحيين المدفوعين من طرف رجال الدين الكاثوليك واصلوا حملة الإبادة لإطفاء غضب الرب، ففي مدينة ستراسبورغ مثلا دُفن نحو 900 يهودي أحياء في يوم القديس فالنتين، ولم يكن الطاعون قد وصل بعد إلى ستراسبورغ آنذاك(3).
وبجانب دورهم المهم في التحريض ضد اليهود، واصل الكهنة ورجال الدين المسيحيون تنظيم المواكب التكفيرية لإطفاء غضب الرب، رغم معارضة العلمانيين وبعض رجال الدين داخل الصف المسيحي بسبب خطورة انتشار العدوى بين المشاركين في هذه المواكب، وهو ما حدث بالفعل سنة 1366 ميلادية بباريس، تجمع الآلاف من المشاركين حاملين الذخائر المقدسة الخاصة للطواف أمام كاتدرائية نوتردام دو باري في طقس ديني مهيب، لكن النتيجة كانت تضاعف عدد المصابين والقتلى وانتشار المرض في الضواحي، وقد تكرّر هذا الأمر لأكثر من مرة لتوفر الأسباب نفسها واتخاذ ردود الفعل نفسها من طرف رجال الدين المسيحيين لدفع بلاء الطاعون.
واستمر الطاعون الأسود في الانتشار من بلد أوروبي إلى آخر، وفي تلك الأوقات الصعبة، حاولت القيادات المسيحية الكاثوليكية والبروتستانية إيجاد تفاسير أخرى للمرض بشكل عام وللطواعين بشكل خاص، فكتب مارتن لوثر عالم اللاهوت في كتابه "أحاديث المائدة" يقول إن الشيطان هو السبب في انتشار الأمراض الخطيرة لأنه هو منشأ الموت، ولأن بطرس في أعمال الرسل يقول إن يسوع يشفي جميع مَن يتسلط عليهم إبليس، وبذلك تكون جميع الأمراض الخطيرة من عمل الشيطان، لكنه يستغل أدوات الطبيعة لتوجيهه الضربات القاتلة للإنسان، الفكرة نفسها تبنّاها الطبيب والمستشار الملكي الفرنسي أنطوان دافان الذي قال إن الطاعون جلبته "كويكبات شيطانية واقترانات سماوية وخسوف القمر"(4).
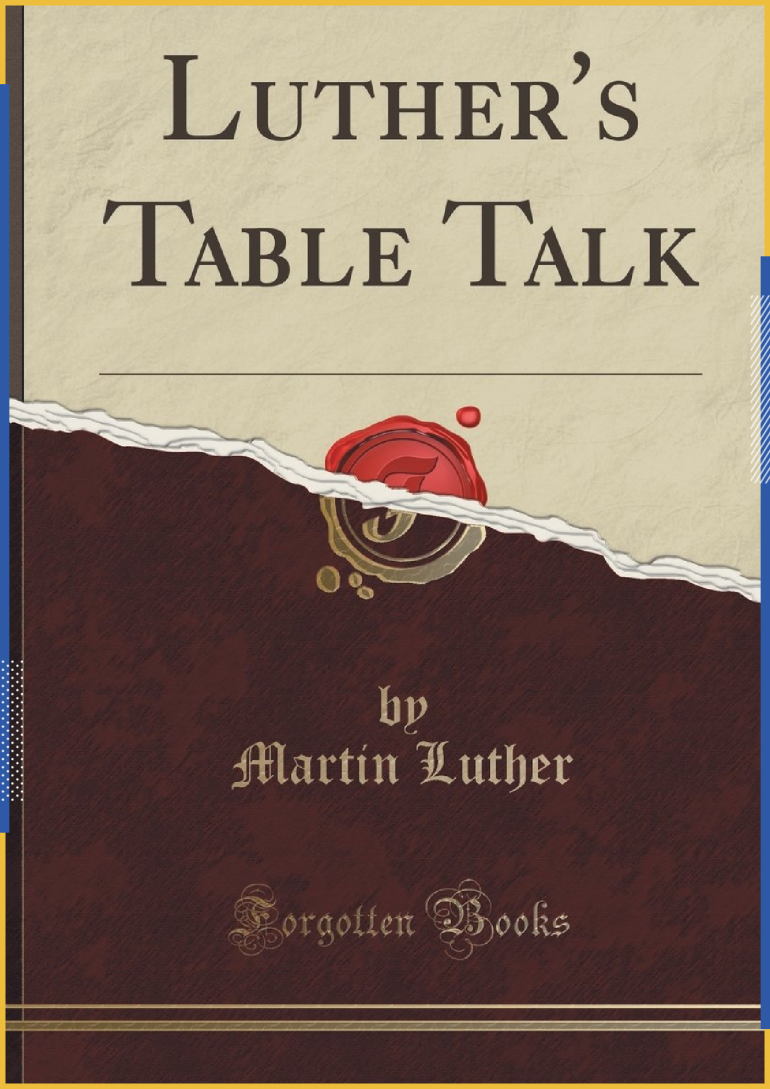
إلا أن الطاعون لم يكن رحيما بأجساد الناس، ولا بعلاقاتهم الاجتماعية وطقوسهم الدينية، خصوصا أثناء مراسيم الاحتضار ذات القدسية العالية. يقول جوزيف بيرن في كتابه "يوميات الطاعون الأسود" إن اللاهوتيين ورجال الدين طوّروا نوعا من الأدلة الأخلاقية يُدعى "فن الاحتضار"، صدر باللاتينية لكنه تُرجم بعد ذلك إلى اللغات المحلية حتى يسهل تداوله، ويُذكَّر الموتى خلال هذا الطقس بأهوال الموت والعقاب الأبدي، مع التنبيه من نفاد الصبر وعدم الإيمان، ثم التذكير بقدرة المسيح على الخلاص، ثم يُختتم هذا الطقس بأداء الصلوات، من جهة البروتستانت ورغم خلافهم الديني مع الكاثوليك، حافظ البروتستانت أيضا على هذا الطقس مع إدخال بعض التعديلات عليه وتبسيطه قدر المستطاع(5).
عاث الطاعون فسادا بكل هذه الطقوس المقدسة، وبعد أن كانت الأسر تتجمع مع الكهنة ورجال الدين لتوديع المحتضر وفق الطقوس الأخيرة، أصبحت الأُسر تُلقي بجثث المتوفين من نوافذ الطوابق، حيث تستقر الجثة بعدها داخل العربة المليئة بالجثث، ولم يعد مَن بقي على قيد الحياة يتأثر تأثرا شديدا بوفاة أحد أفراد الأسرة أيًّا كانت العلاقة التي تربطه به، كان الناس مشغولين بفكرة أن جثثهم لا محالة ستمر عبر النافذة نفسها لتستقر في العربة نفسها، ولم تكن الكنيسة في هذا الظرف العصيب قادرة على لعب أي دور لتخفيف هذه الأزمة، فلم تعد "أراضيها المقدسة" قادرة على استقبال ذلك الكم الكبير من الجثث يوميا، ورفضت دفن جثث صرعى الطاعون في باحاتها بسبب سوء رائحتها وأهوالها، لذلك قررت شراء حقول واسعة أقامت فيها مقابر عمومية سمّتها "حقول الرب" كانت تمتلئ هي الأخرى بسرعة بالجثث الوافدة(6).
كانشبح الطاعون الأسود يجول أوروبا كلها من جنوبها لشمالها ومن شرقها لغربها، حاملا في جعبته الموت الذي يُمزِّق جسدها، في حين أن الطرح الديني مُتمثِّلا في المعتقد المسيحي لم يستطع تقديم مواساة لذاك الفزع الرهيب والموت المهيب، فضلا عن تفسير لانتشار وباء الطاعون، وكذلك عجز الطب الأوروبي القديم عن تقديم تفسير علمي أو علاج فعال، وبدا أن الأوروبيين لا يرون أملا في التغلب على ذلك الوباء. ظهر هذا من خلال مجموعة تجليات:
- أولها على المستوى الفني:
حيث ظهرت مجموعة من الأعمال الفنية ذات الطابع الديني التي جاءت لتؤكد هذه الفكرة، فكرة انتصار الموت على الإنسان، بتمثيل الموت عبر عدة "موضوعات"، فتارة على شكل هياكل تُبارِز مجموعة كبيرة من الناس الذين يقاتلون في محاولة غير مجدية للفرار، وتارة على شكل ثلاثة راكبين نبلاء شبان يواجهون ثلاث جثث متعفنة داخل توابيت، تنطق الجثث بجملة مشؤومة تقول فيها: "كنا ذات يوم ما أنتم عليه الآن، وستصبحون عما قريب ما نحن عليه الآن"(7)، ولأن الطاعون هو "سهم الرب القادم من السماء"، رُسِمت لوحات يظهر فيها "الرب الأب" حسب المعتقد المسيحي محاطا برُماة من الملائكة الذين يرمون السهام على الناس، فيما يظهر المسيح شفيعا يطلب الرحمة من الإله الذي يعتقد المسيحيون بأنه والد المسيح للبشر.
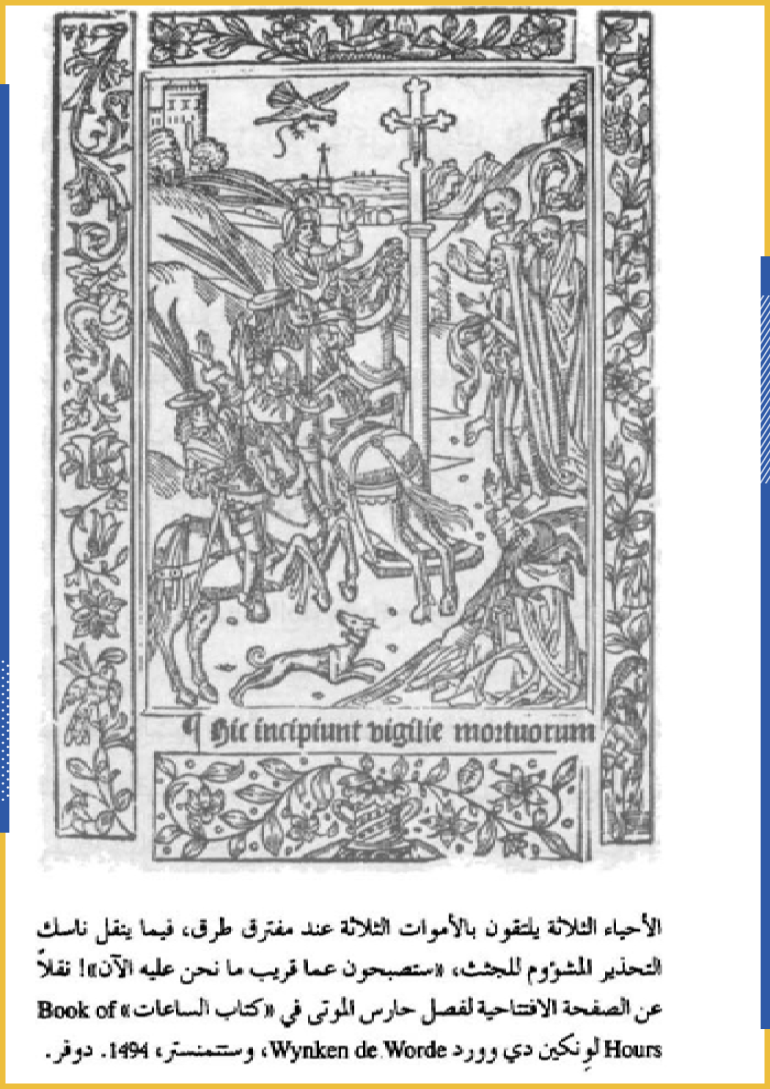
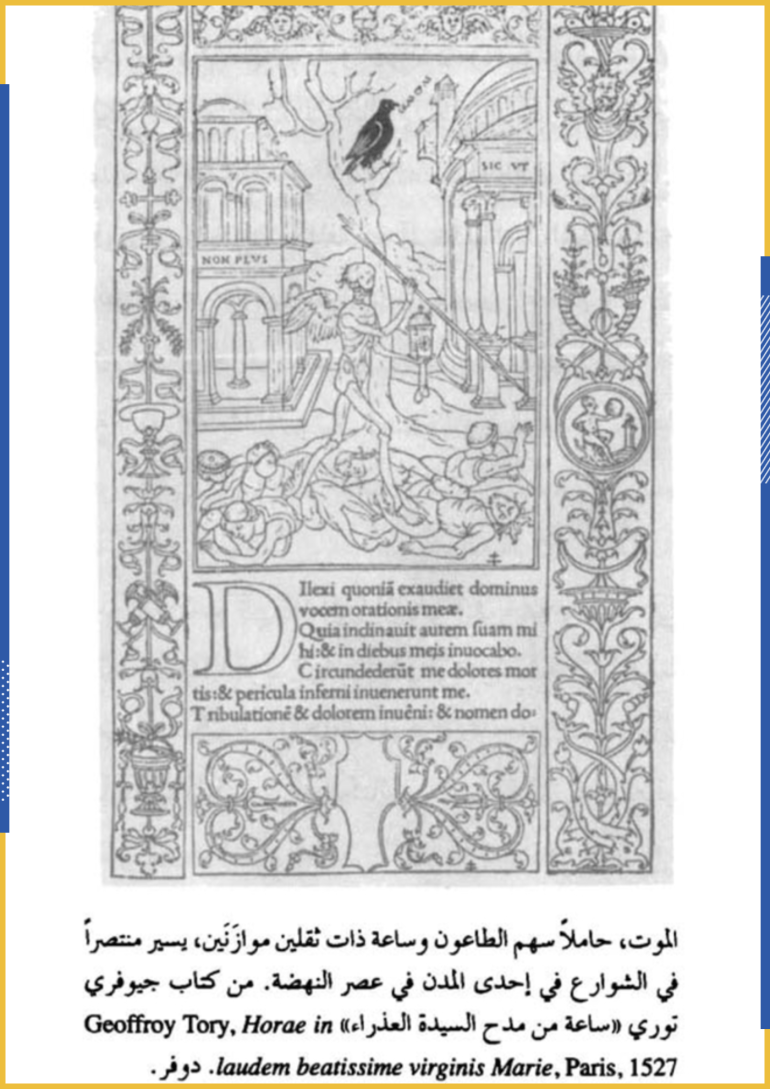
- وثانيا على المستوى الهيكلة الدينية:
حيث كانت خسائر الكنيسة في أوروبا كبيرة جدا بسبب الطاعون، خسائر مادية وبشرية، إذ وقعت الكثير من الوفيات في أوساط القساوسة والكهنة الأسقفين الذين يستمعون لاعترافات الناس ويناولونهم الأسرار المقدسة. حتى حاول بعض رجال الدين حسب ما يذكر جوزيف بيرن في "يوميات الطاعون الأسود" تقليل أوقات الطقوس والاستماع للاعترافات من خارج النافذة حتى يقوا أنفسهم من المرض، لكن هذا الأمر لم يكن ذا فعالية كبيرة(8).
كذلك فقدت الكنيسة بعض قياداتها، حيث هلك القائد الكنسي الأهم في إنجلترا ورئيس أساقفة "كانتربري" جون ستراتفورد سنة 1348م، وبعدها بسنة واحدة فقط مات خليفته قبل أن يُثبّته البابا أسقفا رسميا، كانت هذه المناصب تُشترى من البابا بمبالغ كبيرة تضطر الأسقف للاستدانة، وبموته يُفلس العديد من دائنيه. لكن هذه الأزمة، وكأي أزمة أخرى، خلّفت عددا من المنتفعين، كان من بينهم بعض الكهنة الذين تركوا مناصبهم وانتقلوا إلى حيث يحصلون على رواتب أكبر، ولم يكن للأحبار والأساقفة إمكانية إيقافهم، كان الكهنة يرفضون علاج الأرواح وتحمُّل تبعات علاجها، واكتفوا بالاحتفال بالقداس التذكاري والمهام الأخرى مطالبين برواتب كبيرة، حسب ما سجّلت بعض القيادات الكنسية آنذاك(9).
فأجبر هرب رجال الدين المسيحيين من مهامهم، إما بدافع الخوف من الموت أو بحثا عن مكاسب مادية أكبر، أجبر الكنيسة على قبول مرشحين جدد لا يستجيبون للشروط الطبيعية، فعُيِّن رجال دين ممن وُلدوا ولادة غير شرعية أو ممن ليس لديهم السن القانونية، كل هذه المتغيرات ساهمت في انحسار الثقة برجال الدين، وتوجَّه الناس إلى البروتستانية لأنها كانت تطرح صيغا دينية مقبولة بشكل أكبر(10)، حيث كان الطاعون وما تبعه من كوارث طبيعية مثل زلزال لشبونة من أهم العوامل التاريخية التي ساهمت في انهيار الكنيسة المسيحية في أوروبا وبداية عصر العلمانية والتفكير العلمي ومخاصمة الدين بالكلية.
المشرق الإسلامي: الوحي خلفه والطاعون أمامه

عاش المشرق الإسلامي، كما هو حال أوروبا القديمة، موجات قوية من الطاعون ضربت البلاد العربية والإسلامية وخلّفت عشرات الآلاف من القتلى وسط جهود مضنية من أطباء المسلمين وفقهائهم للتعامل مع واقع مُربك يمكن وصفه بالامتحان والابتلاء الرباني، بداية بطاعون عمواس في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في السنة 18 للهجرة، والطاعون الجارف في القرن 7 للهجرة، وطاعون الفتيات والأشراف في القرن 9 للهجرة، ثم الطواعين التي أوجعت المسلمين خلال العصر العباسي والأيوبي والمملوكي في المشرق الإسلامي التي كان من أبرزها الطاعون الأسود الذي ضرب العالم كله في القرن الرابع عشر الميلادي.
بعد انقضاء طاعون عمواس الذي مات فيه بعض كبار الصحابة، واصلت الطواعين ضرب المشرق الإسلامي، وهو بالمناسبة أحد الأسباب التي أنهكت الدولة الأموية وسرّعت وتيرة انهيارها لصالح بني العباس، وخلال القرون الأولى للخلافة العباسية تراجعت وتيرة وقوع الطواعين، لكنها عادت في العهد المملوكي بوتيرة سريعة جدا جعلت من مدينتَيْ الإسكندرية وحلب بؤرتين لهذا الوباء القاتل.
كانت بلاد المسلمين تتنفس الموت في كل يوم، يصف ابن حجر العسقلاني الذي عاش هذه الفترة وعاصر عددا من الطواعين في كتابه "السلوك لمعرفة دول الملوك" الوضع آنذاك، وكيف أن الموت أصبح الواقع اليومي الذي تدور حوله الحياة، يقول في كتابه: "وعجز الناس عن دفن أمواتهم، فصاروا يبيتون بها في المقابر، والحفارون طول ليلتهم يحفرون، وعملوا حفائر كثيرة تُلقى في الحفرة منها العديد من الأموات، وأكلت الكلاب كثيرا من أطراف الأموات، وصار الناس ليلتهم كلها يسعون في طلب الغسال والحمالين والأكفان، وترى نعوش الأموات في الشوارع كأنها قطارات الجمال، لكثرتها والمرور بها متواصلة بعضها في إثر بعض، فكان ذلك من الأهوال التي أدركناها"، ويقول في موضع آخر من الكتاب: "وبطلت الأفراح والأعراس من بين الناس، فلم يُعرف أن أحدا عمل فرحا في مدة الوباء، ولا سمع صوت غناء، وتعطل الأذان من عدة مواضع وبقي في الموضع المشهور بأذان واحد، وغلقت المساجد والزوايا، واستقر أنه ما ولد أحد في هذا الوباء إلا ومات بعد يوم أو يومين ولحقته أمه".

على ضوء عقيدتهم الدينية، تعامل المسلمون مع الطاعون على أساس أنه ابتلاء من الله، فكانت ردة الفعل الاجتماعية تماما كما في الغرب، دعوة الناس بعضهم بعضا للتوبة والرجوع إلى الله، لأن القدرة الإلهية وحدها القادرة على القضاء على الطاعون، فتاب عدد من الخلق وانتشرت قراءة القرآن الكريم وصحيح البخاري كما جرت العادة إبان الكوارث والنكبات والغزوات، وخرجوا إلى الصحراء ليصلوا صلاة الاستسقاء، ولازم الناس المساجد وأكثروا من الصيام وإطعام الفقراء، وبدأ الناس يتركون مظاهر الترف في الملبس والمناسبات الاجتماعية، وأعرضت نساء مصر عن لبس الحرير والذهب والفضة والجواهر(11).
وبجانب الجهود الاجتماعية في إعادة إحياء الدين داخل المجتمع طلبا لرفع البلاء، كانت السلطات السياسية تسير في الاتجاه نفسه، وكانت الصلوات والدعاء والصوم في دمشق والقاهرة وغيرهما تتم بقرار سياسي، وبطلب من العلماء والفقهاء والقضاة الذين كانوا يجمعون بين دورهم الديني ودورهم السياسي والاجتماعي، حيث يذكر ابن بطوطة في رحلته أن أرغون شاه، نائب السلطنة في دمشق، هو الذي أمر الناس بالصوم 3 أيام على اختلاف طبقاتهم وأجناسهم بل ودياناتهم، وتكاثف الناس في التضرع إلى الله حتى خفّف عنهم البلاء وقلّت أعداد الموتى في دمشق ثم القاهرة.
لكن هذا الإجماع الديني على ضرورة التضرع إلى الله لم يلازمه إجماع في الطريقة العملية والإدارية والسياسية التي يجب بها مواجهة الوباء، وعليه ظهر الاختلاف قويا وعنيفا بين أطباء المسلمين وفقهائهم.
قبل الدخول في تفاصيل هذا الخلاف بين الفقهاء وعلماء الشريعة من جهة والأطباء من جهة أخرى، تجب الإشارة إلى أن مستوى الطب في العالم الإسلامي، سواء في المشرق العربي أو في الأندلس، كان متقدما بشكل واضح حينها عن الطب لدى الغرب، كما أن المسلمين ورغم عدم تمكُّنهم من إيجاد حل طبي للحد من انتشار الطاعون فإنهم كانوا أقرب لاكتشاف أسباب انتشاره بهدف الحد منه، ولو بشكل جزئي.
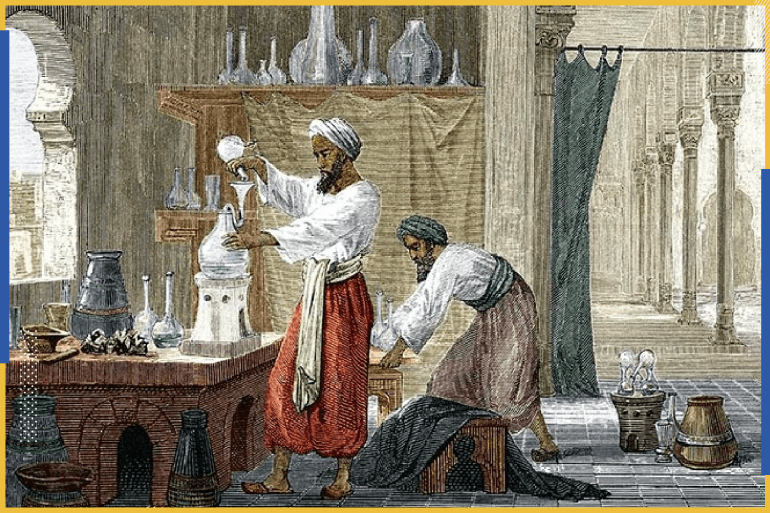
يعود هذا التقدُّم الطبي إلى بعض الكتابات التأسيسية في مجال الأوبئة مثل كتاب "الحاوي" لأبي بكر زكرياء الرازي (ت311هـ) الذي يحتوي على أجزاء خصّصها الرازي للأمراض المعدية مثل الجرب والسل والجذام، وهو ما جعل كتابات الرازي تُطبع نحو أربعين مرة مترجمة بين عامي 1498-1866 للميلاد بعدة لغات، هذا إلى جانب كتابات ابن سينا (ت 427هـ) وأهمها كتاب "القانون" الذي يعد بمنزلة موسوعة طبية من 5 أجزاء، ظلّت هذه الكتب حاضرة في المقررات الدراسية في أوروبا حتى القرن التاسع عشر الميلادي. وخلال الفترة التي انتشر فيها الطاعون الأسود ستظهر أسماء أخرى لأطباء مسلمين خصوصا في الأندلس كابن الخطيب (ت 776هـ) الذي استخدم مفهوم "الوباء بوصفه نتيجة للعدوى المتلاحقة"، وهو ما كان غائبا عن الكتابات الطبية الغربية في القرون الوسطى رغم عيش أوروبا على وقع الطاعون والكوليرا لسنوات طويلة.
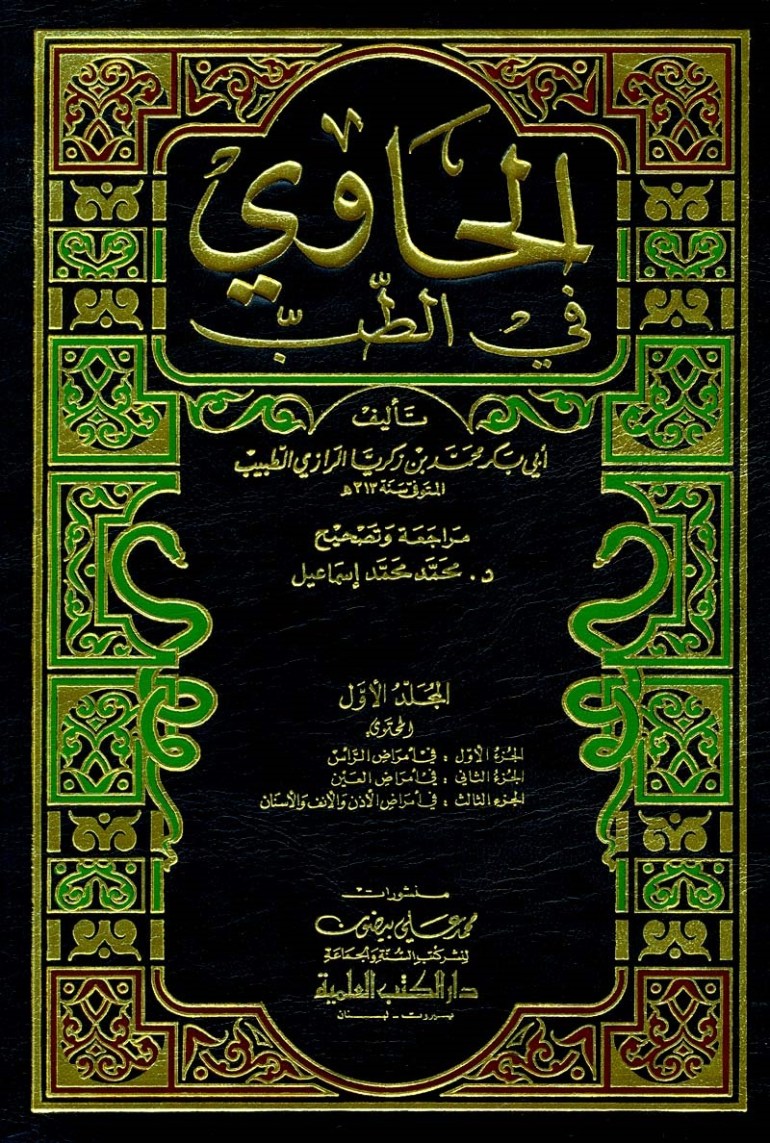
اختلف الأطباء المسلمون حتى قبل الطاعون الأسود حول سبب أسباب انتشار الأوبئة، الفيلسوف المسلم أبو معشر البلخي (ت271 هـ) استخدم علم الفلك القديم، حيث ربط انتشار الوباء باقتران المريخ والمشتري، الشيء الذي يُثير وباء عظيما في الهواء لا سيما عندما يحدث ذلك في برج فلكي دافئ وآخر رطب في دائرة البروج، أما ابن سينا فكان يرى أن الوباء ينتشر بسبب فساد في الهواء، وكان يُفسِّر العدوى بأنها انتقال الهواء الفاسد من الشخص المطعون إلى الشخص السليم، في الوقت نفسه الذي كان الطبيب البابوي غي دي شوياك (ت 1368م) يتبنّى رأي طبيب مجهول من مونبوليي الفرنسية يقول إن المرض ينتشر عبر ما يسمى "بالنظرة القاتلة" التي ينظر بها المحتضر للشخص المريض(12).
لكن كل هذه المجهودات المعرفية الطبية التي بذلها الأطباء المسلمون لم تشفع لهم في إيجاد دواء للطاعون، والسبب ليس سرا، ففي ظل الإمكانيات المتاحة في القرن 14، لم يكن الإنسان ليتمكّن من اكتشاف "البكتيريا" التي تُسبِّب الطاعون التي اكتُشفت لاحقا سنة 1894م عن طريق عالم الجراثيم الفرنسي السويسري ألكسندر يرسن.
ولم تكن العلاجات التي كان يصفها الأطباء المسلمون قادرة على شفاء المرض ولا التخفيف منه، وبذلك اعتبر بعض العلماء كالسيوطي (ت 911هـ) حسب ما ذكره عنه مرعي الكرمي الحنبلي (ت 1033هـ) في كتابه "تحقيق الظنون بأخبار الطاعون" أن الذهاب إلى الأطباء أمر لا فائدة منه أبدا لعلاج الطاعون، لأنهم قرروا أن انتشاره ناشئ عن فساد الهواء، وقد تبين بالدليل فساد ما قالوا" -على حد وصفه-، بعض العلماء كان أكثر شدة في الرد على الأطباء مثل ما فعل أبو المظفر السرمري (ت 776هـ) في كتابه "ذكر الوباء والطاعون"، حيث وصف أهل الطب بالجهال المنتسبين للعلم الذين ليسوا من أهله، ونقل عن فقهاء المغرب وضعهم أهل الطب في الخانة نفسها وعلى مذهب أهل الجاهلية نفسه.
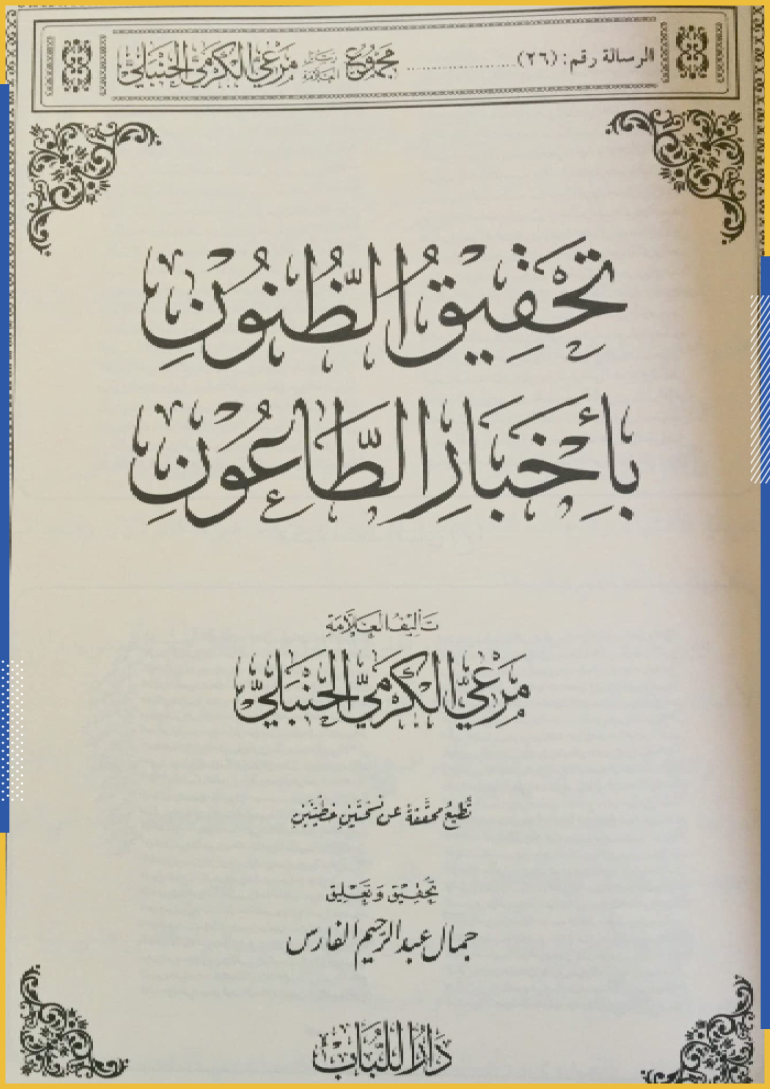
نقطة الخلاف الأخرى الثانية بين أهل الشريعة وأهل الطب كانت هي نقطة انتشار المرض عن طريق العدوى، وطريقة تفسير الحديث النبوي الشريف: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول"، بعض الفقهاء أخذوا بظاهر الحديث وأنكروا العدوى، في حين بعض الأطباء، ومعهم فقهاء آخرون، أقرّوا وجود العدوى وانتشار الطاعون بهذه الطريقة.
ومن أشهر مَن تبنّى هذا المذهب الظاهري وإنكار وقوع العدوى تماما الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ)، صاحب الكتاب الشهير "فتح الباري في شرح صحيح البخاري". عرّف العسقلاني في فتح الباري العدوى بأنها ما كانت الجاهلية تعتقده من "تعدي داء ذي الداء إلى مَن يجاريه ويلاصقه"، وبيّن في كتابه أن قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- "لا عدوى" يحتمل النهي عن قول ذلك واعتقاده أو النفي لحقيقة ذلك، واعتبر أن القول الثاني أظهر. ومما زاد اعتقاد ابن حجر العسقلاني بعدم انتقال المرض عبر العدوى ما عاشه هو شخصيا بعد وفاة ابنتيه فاطمة وعالية بالطاعون الذي حدث في مصر سنة 819 للهجرة، وابنته خاتون في طاعون 833 للهجرة، ورغم أنه كان يسهر على رعايتهن لم يصبه الطاعون، معارضا بذلك قول السبكي الذي قال إنه في حالة شهادة طبيبين أن مخالطة الصحيح للمريض قد تُسبِّب نقل المرض، فإن الامتناع عن المخالطة جائز أو أبلغ من ذلك(13).
في الأندلس، كان التقدُّم الطبي مساعدا على التعاطي مع هذه القضايا الطبية والفقهية الشائكة بطريقة أفضل، حيث نجد أن لسان الدين ابن الخطيب (ت 778هـ) هاجم بشدة منكري العدوى في رسالته "مقنعة السائل عن المرض الهائل" قائلا: "قد ثبت وجود العدوى بالتجربة والاستقراء والحس والمشاهدة والأخبار المتواترة، وهذه مواد البرهان. ووقوع المرض في الدار والمحلة والثوب والآنية، حتى القرط أتلف مَن علق بأذنه وأباد البيت بأسره…، وارتكاب اللجاج فيه ألحم في الناس سيف الطاعون، وسلط الله عليهم من بعض المفتين مَن اعترضهم بالفتيا اعتراض الأزارقة من الخوارج للناس بالسيوف، فسالت على شبا أقلامهم من النفوس والمُهَج ما لا يعلمه إلا مَن كَتَبَ الفناءَ عليهم…؛ وبالجملة فالتصامُمُ عن مثل هذا الاستدلال زعارة وتصافر (= جرأة) على الله، واسترخاص لنفوس المسلمين".
هل الدين أقل أهمية من اللقاح؟

"أصبح العالم منفصلا عن القيمة، بمعنى أنه لا يوجد معايير إنسانية أو أخلاقية أو دينية. وحتى لو وجدت مثل هذه المعايير فهي ستتغير لا محالة، كما أنها غير مادية، وبالتالي لا يمكن أن تؤخذ في الحسبان، ومع غياب المعايير غابت المرجعية الإنسانية، وظهرت العنصرية والفلسفة الداروينية التي جعلت من القوة المعيار الوحيد للحكم والآلية الوحيدة لحسم الخلافات".
(عبد الوهاب المسيري)
عاشت الولايات المتحدة الأميركية سنة 2005 أحد أعنف الإعصارات التي عرفتها في تاريخها، إعصار كاترينا الشهير الذي خلّف 1833 قتيلا وكبّد خسائر اقتصادية قُدِّرت بأكثر من 100 مليار دولار. كغيره من الكوارث الطبيعية لم يكن لإعصار كاترينا أي مواقف سياسية أو عِرقية أو أيديولوجية، لم يكن يُفضِّل الفقراء على الأغنياء ولا العكس، لكن هناك فئات بعينها هي التي دفعت الفاتورة الأعلى أثناء هذه الكارثة الطبيعية وبعدها، مَن هي هذه الفئة؟ يجيبنا باتس الثالث راعي الكنيسة المعمدانية الحبشية في مدينة هارلم آنذاك الذي قال في تصريح له بعد الإعصار: "الناس الأكثر تضررا في الغالب من الإعصار كانوا من الفقراء، من الفقراء السود تحديدا"، هذا الأمر يؤكد شيئا مهما جدا هو أن العنصر البشري لا يتحكم في حجم الكوارث الطبيعية ولا توقيتها، لكنه يتدخل بشكل مباشر في تبعاتها وكل ما يترتب عليها. هذا الأمر يشرحه ديفيد غونزاليز المراسل الخاص لصحيفة نيويورك تايمز بشكل أكثر وضوحا إذ يقول: "منذ أن محت الرياح والمياه الأحياء والمدن على ساحل الخليج، كان هناك شعور بأن العِرق والطبقة هما علامتان ضمنيتان تُميّزان الناجين والضحايا، حيث يتضح الفشل الذريع في سياسات التطوير الريفي في أوقات الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والجفاف، حينها قال كثيرون من القادة القوميين إن بعض أفقر مدن الولايات المتحدة الأميركية تُركت عاجزة أمام الخطر بفعل السياسات الفيدرالية"(14).
وبالانتقال لعصرنا الحالي، فإننا نعيش في عالم "حداثي" يتبنّى نظاما رأسماليا يضع الاقتصاد على رأس أولوياته، عالم علماني بصورة شاملة، أي ليس فقط على المستوى السياسي، بل على المستوى الاجتماعي والثقافي أيضا، تماما كما يصف ذلك الدكتور عبد الوهاب المسيري إذ يقول: "العلمنة (الشاملة) ليست مجرد فصل الدين عن الدولة وبعض مجالات الحياة العامة، وإنما هي عملية فصل كل القيم والثوابت والمطلقات عن العالم والطبيعة وحياة الإنسان العامة ثم الخاصة، إذ يتحول العالم بأسره إلى مادة استعمالية لا قداسة لها ولا خصوصية ولا مرجعية لها سوى المرجعية الكامنة فى المادة"(15).
في الغرب، كان الاعتقاد السائد خلال العصور الوسطى أن الشر مرتبط بالإثم، وأن العقاب لا يتولّد إلا بعد الوقوع في الإثم، وبذلك، فإن الشر الموجود في الطبيعة ما هو إلا ردة فعل على اقتراف الإنسان للخطيئة ووجود مشكلة أخلاقية، ويكون رد الفعل إما بمصائب فردية يعانيها المقترف لهذا الذنب، أو بمصائب جماعية، وبذلك تكون المعادلة لحل هذا المشكلة هي: الندم، والكفارة في مقابل الخطيئة والعقاب (16).
لكن بعد اكتشاف الغربيين أن هذه المعادلة ليست حقيقية دائما، وأن الابتلاء بالكوارث يحدث رغم عدم ارتكاب أي ذنب كما هو واضح في العقيدة الإسلامية ومعروف بمفهوم "الابتلاء"، تغير تفكير الغرب في الكوارث الطبيعية، ليرى كوارث الطبيعة كأفعال لا عقلانية ليس لها تفسير ديني، وبالتالي يجب التفكير فيها عقلانيا فقط وإدارتها بالعلم دون أي تفكير أخلاقي. بالتالي، عندما ظهرت "الشرور الاجتماعية" منذ الحرب العالمية الأولى مرورا بمعسكرات الإبادة النازية وحتى إلقاء القنابل النووية على اليابان المنهزمة أصلا، تحوَّل الشر إلى بيروقراطية ناعمة مُتمثِّلة في مجرد إجراءات صغيرة تُسبِّب شرورا عظيمة مثلما وضّحت حنة أردنت في كتابها "تفاهة الشر"، فقد الضمير الإنساني في الحضارة الغربية بوصلته بالكامل، فقد حلَّ العلم والعقل محل الضمير والاخلاق.
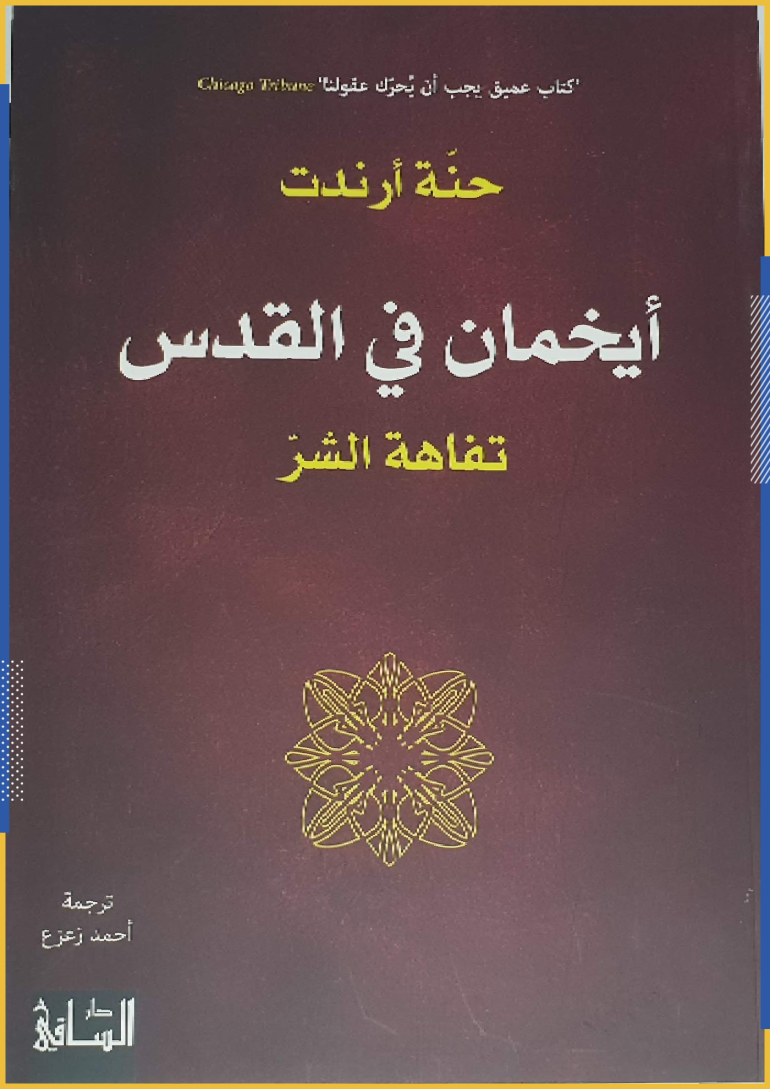
في هذا السياق، يقول زيجمونت باومان في كتابه "الخوف السائل" إن هذا التحوُّل في التفكير الغربي خلّف قاعدتين أساسيتين:
- "فأما القاعدة الأولى فهي الاتجاه نحو تحييد الفعل الاجتماعي وإخراجه من القانون الأخلاقي، وذلك بالتهوين من أهمية المعايير الأخلاقية، أو كلما أمكن استئصال تلك المعايير تماما مع تقويم استحباب أفعال البشر (أو جوازها) بحيث ينتهي المطاف بتجريد النفس البشرية الفردية الفاعلة من حسها الأخلاقي وقمع باعثها الأخلاقي.
- وأما القاعدة الثانية فهي تجريد النفس البشرية من المسؤولية الأخلاقية عن تبعات أفعالها، كما لو أنها تُترجم بلغة علمانية قاعدة مارتن لوثر التي يستشهد بها ماكس فيبر مرارا وتكرارا في تأمل طبيعة الأزمة الحديثة حيث يقول: "المسيحي يفعل الصواب ويترك النتيجة في يد الله".
فكلما حل بلاء ما في العالم الذي نعيش فيه، تصاعدت أصوات الأشخاص المطالبين بإبعاد الدين عن القضايا الشائكة التي تواجهها البشرية، وتساءل الناس عن دور علماء الدين في إيجاد حل لمشكلة كالوباء، فإن كان لا دور لهم، فيجب علينا إذن التوجُّه بالإشادة والتقدير للمتخصصين في العلوم التجريبية والطبيعية فقط، لأولئك الذين يعملون الآن في المختبرات وليسوا أولئك الذين ينتظرون الفرج في منازلهم بعد إغلاق دور العبادة.
إلا أن الإشكال الحقيقي المطروح هو أن العلم والعقلانية الغربية لم تستطع توليد أخلاق صالحة للاتّباع وقت الأزمات الكبرى، فشاهدنا في أميركا مثلا توجُّه إدارة ترامب نحو الحفاظ على الاقتصاد على حساب صحة المواطنين والتضحية بالمسنين على سبيل المثال، بل ودعوتهم هم أنفسهم للتضحية بحياتهم في سبيل تجنُّب الكساد، كما تابعنا عمليات القرصنة على الأدوات الطبية في أوروبا بوصفها نتيجة طبيعية لعالم تحكمه العلمانية التي تخلّت عن الدين وما يُقدِّمه من أخلاق، فقد يجد العلم اللقاح المناسب لهذا الوباء، أو الدواء الشافي من ذلك المرض العضال، لكنه لم يستطع الإجابة عن أي سؤال أخلاقي حول ما مدى مشروعية استثناء الفقراء من الدواء والبرامج الصحية، كما أن العلم والعقل لم يتمكنا من حماية الضعيف أو مساعدة الفقير، ففي وقت الأزمة يأكل القوي الضعيف باسم العقلانية والمصلحة، أو يُترك ليموت في الشوارع مثلما فعلت الولايات المتحدة الأميركية مع كبار السن ومصابي متلازمة دون وذوي الإعاقة إذا أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد.
ريتشارد دوكنز أحد المتيمين بالعلم والنابذين للدين نفسه يؤكد الحقيقة ويقول: "العلم الطبيعي ليس لديه طرق للحكم على كل ما هو أخلاقي، إن هذه المسائل متروكة للأفراد والمجتمع"، ويضرب مثالا واضحا جدا على عدم قدرة العلم على تقديم أي طرح أخلاقي فيقول: "ما الذي يمنعنا من القول إن هتلر كان على صواب؟ أعني أن هذا السؤال صعب فعلا"، بل يذهب إلى أبعد من ذلك ويعتبر أن اعتقاد أن الاغتصاب خطأ أمر اعتباطي تماما كتطور الإنسان بخمسة أصابع بدلا من ستة على حد وصفه(17).
ومع ذلك، فالعلم ليس مجبرا على الإجابة عن أي سؤال أخلاقي، كما أن الدين ليس من تخصصه إيجاد الأدوية العضوية واللقاحات التي تهدف إلى الحد من الأوبئة، لكل مجال حدوده وأهدافه وقدراته ومساحة تحركه، وأي مقارنة بين المجالين ستكون ظالمة للمجالين معا، والزج بالدين والعلم كما ظهر من خلال النقاشات التي اشتعلت بها وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع كان في الغالب لأهداف أيديولوجية يقف فيها العلم نِدًّا للدين لا مُكمِّلا لطرحه الأخلاقي.
في أحيان كثيرة يساهم الفهم الديني -الشعبي خصوصا- في زيادة انتشار الوباء، كما حدث في أوروبا العصور الوسطى، وكما يحدث اليوم في إيران مثلا أو في الأحياء التي يستوطنها اليهود الحريديم بالأراضي المحتلة، وذلك عبر التمسك بشعائر معينة أو عدم الالتزام بتعليمات المختصين، إلا أن الدين الصحيح وحده القادر على ممارسة سلطة أخلاقية على البشر المؤمنين به للحد من جشع البشر ورغبتهم في البطش بالآخر المنافس، ودعوتهم للإيثار الأخلاقي وتقديم يد المساعدة للمساكين والفقراء والمعدمين، وذلك عبر آلية الترغيب والترهيب الكامنة وراء عقيدة الحياة الأخرى، الترغيب في الجنة ونعيمها، والترهيب من الجحيم أو النار أو جهنم وعذابها، ليكمل بذلك الدين دور العلم التجريبي الذي يعمل على إيجاد حلول وتفسير للتحديات الطبيعية التي تواجه البشر قصد التغلب عليها والحفاظ على الإنسان ورعايته ووضع التقدم العلمي في خدمته.
—————————————-
المصادر
- سلسلة الحياة اليومية عبر التاريخ: الموت الأسود، جوزيف بيرن / ترجمة عمر سعيد الأيوبي.
- الأوبئة والتاريخ: المرض والقوة والإمبريالية / شلدون واتس / المركز القومي للترجمة.
- المصدر السابق
- سلسلة الحياة اليومية عبر التاريخ: الموت الأسود، جوزيف بيرن / ترجمة عمر سعيد الأيوبي.
- المصدر السابق
- المصدر السابق
- المصدر السابق
- المصدر السابق
- المصدر السابق
- المصدر السابق
- السلوك لمعرفة دول الملوك / ابن حجر العسقلاني
- سلسلة الحياة اليومية عبر التاريخ: الموت الأسود، جوزيف بيرن / ترجمة عمر سعيد الأيوبي.
- سرّع بعضها بفتوح الإسلام وسقوط الدولة الأموية وفتك أحدها بـ19 ألف عروس.. الطواعين والأوبئة في التاريخ الإسلامي
- الخوف السائل: زيجمونت باومان / الشبكة العربية للأبحاث والنشر
- الأمركة والكوكلة والعلمنة
- الخوف السائل: زيجمونت باومان / الشبكة العربية للأبحاث والنشر
- ميليشيا الإلحاد، عبد الله بن صالح العجيري، دار تكوين
- العبادة في زمن الكورونا: لماذا لا يصدّق المؤمنون أنّهم عرضة للعدوى؟
