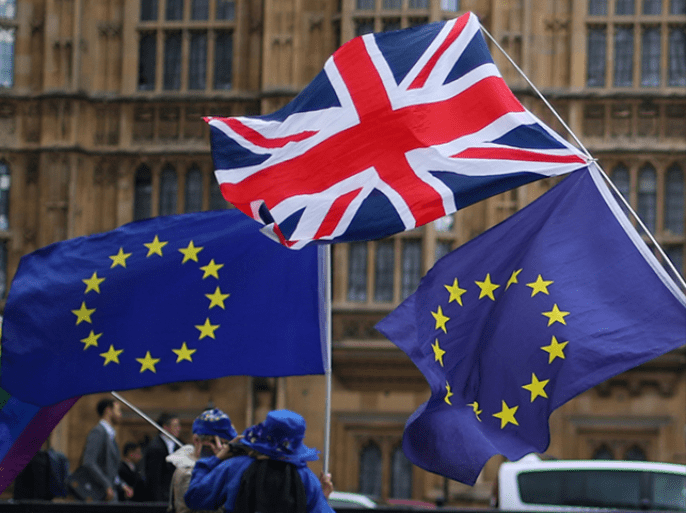أطلقت الحكومة البريطانية الآن خطة لتحويل المملكة المتحدة إلى "قوة تصديرية عظمى"، وهو هدف طموح، إن لم يكن خياليا بالكامل.
فبينما تتسارع دول العالم لتقوية علاقاتها التجارية والحفاظ على سلاسل الإمدادات الموجودة في ظل حرب تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، نجد موقف بريطانيا مغايرا، حيث تخوض حاليا المراحل النهائية من مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ــ وهو تحرك سيقلب علاقتها مع أكبر شريك تجاري لها رأسا على عقب. ولن تقل صادرات بريطانيا قريبا فحسب، وإنما ستصير أقل قوة ونفوذا.
إن أول شيء "يتحتم" على أي قوة تصديرية عظمى فعله هو وضع ترتيبات تجارية واضحة ومستقرة مع الدول الأخرى حتى يتسنى للشركات إنتاج البضائع والخدمات بشكل تعاوني عبر الحدود. وهذا ما تفعله الصين حاليا بما تنفذه من استثمارات هائلة في البنية التحتية، وتكوين روابط جديدة خارج الحدود عبر أوراسيا وما وراءها. وهذا أيضا ما فعلته الدول الأوروبية بإنشاء وتوسيع السوق الموحدة على مر عقود كثيرة.
| يشكل قطاع الخدمات 79% من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا، كما يستأثر بنحو 80% من الوظائف في الاقتصاد البريطاني، مقارنة بنسبة 10% فقط للتصنيع. وقد كانت الخدمات أول القطاعات تعافيا بعد الأزمة المالية عام 2008 |
ويبرر تلك المشروعات حقيقة أن ثلاثة أرباع التجارة الدولية بأكملها تتكون من المدخلات التي تسهم في إخراج المنتجات النهائية في مراحل لاحقة. لذا تتحكم سلاسل القيمة العالمية فيما يمكن للحكومات فعله وما لايمكنها فعله. وعندما تفرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية على الصين، فهي بذلك ترفع تكلفة الواردات التي تحتاجها بشدة الشركات المحلية الصغيرة لاستمرار عملياتها.
بالمثل ستُحدث خطط الحكومة البريطانية الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي اضطرابا في سلاسل الإمدادات التي تعتمد عليها الشركات البريطانية. ولو استعرضنا مثالا واحدا لذلك، سنجد أن عمود المرفق (الكرنك) لأي سيارة بي إم دبليو ميني يستلزم عبور القناة الإنجليزية ثلاث مرات قبل الانتهاء من تصنيع السيارة، مما يعني أن أي تأجيل على الحدود سيدمر ربحية سلسلة الإمدادات هذه.
ولا تقدم خطة التصدير الجديدة التي أعلنتها الحكومة البريطانية أي نوع من الوضوح أو الشفافية للشركات البريطانية، شأنها في ذلك شأن استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي وضعتها تلك الحكومة، فرغم استيراد الاتحاد الأوروبي نصف الصادرات البريطانية بجميع أشكالها، تتساءل شركات بريطانية كثيرة الآن عن ما إذا كانت ستستطيع مواصلة الإنتاج مع شركائها في الاتحاد الأوروبي مستقبلا.
الشيء الثاني الذي "يتحتم" فعله لوضع استراتيجية تصدير ناجحة تناسب القرن الواحد والعشرين هو التركيز على الخدمات، التي تجاهلتها الحكومة بشكل كبير في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، إذ يشكل قطاع الخدمات 79% من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا، كما يستأثر بنحو 80% من الوظائف في الاقتصاد البريطاني، مقارنة بنسبة 10% فقط للتصنيع. وقد كانت الخدمات أول القطاعات تعافيا بعد الأزمة المالية عام 2008، كما بلغت صادرات بريطانيا من الخدمات ضعف وارداتها منها تقريبا منذ أواخر 2017.
وقد يكون لافتقار الحكومة إلى خطة بشأن الخدمات توابع بعيدة المدى، فمن الوارد أن يكون تصدير الخدمات أشد تعقيدا من تصدير البضائع، إذ يتطلب نجاح أي دولة في تصدير خدمات المحامين والأطباء والمهندسين وموظفي التأمينات والمحاسبين والمعلمين، اعترافا وثقة من الدول الأخرى بمؤهلات تلك الدولة المهنية وهيكلها التنظيمي الأوسع. ولهذا تنمو صادرات الخدمات غالبا مع التكامل الإقليمي الاقتصادي والقانوني. ويعد الاتحاد الأوروبي بلا شك أنجح مثال لهذا النوع من التكامل.
بالنسبة للحالة البريطانية، نجد أن نحو 40% من صادرات الخدمات تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، و21% إلى الولايات المتحدة، والبقية إلى آسيا، ودول أوروبا غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وأميركا اللاتينية، وإقليم أسترالاسيا، وجنوب المحيط الهادئ. هذه الحقائق الملموسة لن تجدي معها الخطب الرنانة والكلام الأجوف لمؤيدي الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء رابطة الكومنولث وتأسيس بريطانيا عالمية جديدة. فإذا ما فقدت بريطانيا وجودها في سوق خدمات الاتحاد الأوروبي الموحدة، ستتعرض القدرة التنافسية لأكبر قطاعاتها ــ إضافة إلى 80% من الوظائف في بريطانيا ــ للخطر.
| إذا كانت بريطانيا تريد حقا أن تصبح قوة تصديرية عظمى، فينبغي لها أن ترحب بالمهاجرين وأن تعمل جاهدة لضمان أن تكون عملية الهجرة إليها أكثر سلاسة وانسيابية من الهجرة إلى منافسيها. |
ورغم وجود أسواق لتصدير الخدمات في غير دول الاتحاد الأوروبي، لم تفلح الجهود العالمية في الماضي لفتحها بشكل عام. وبالتالي، ينبغي لاستراتيجية بريطانيا التجارية أن تركز على متطلبات الفوز بنصيب أكبر من تلك الأسواق. وهذا يعني ضرورة التفوق على المنافسين. وبما أن أكبر صادرات الخدمات في بريطانيا تتركز في ما يصفه المتخصصون في التجارة "بالخدمات المهنية والعلمية والتقنية"، فإن هذا يعني الحاجة إلى تدريب وجذب أفضل خبراء العالم والاحتفاظ بهم.
لكن تحقيق ذلك يستوجب أن تكون جامعات ومختبرات البحث في بريطانيا مؤسسات عالمية المستوى قادرة على اصطياد الخبراء من الدول الأخرى، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي. وعلى أية حال، ستكون دول الاتحاد الأوروبي ــ لا سيما فرنسا وألمانيا ــ أكبر منافسي بريطانيا قريبا.كما أن نصيب الاتحاد الأوروبي من صادرات الخدمات العالمية هو الأكبر في العالم إلى حد بعيد، حيث تبلغ قيمتها 2.3 تريليون دولار.
إلا أن استراتيجية الحكومة قاصرة بشدة للأسف في هذا الجانب، حيث تُنفر سياسات الهجرة المتعسفة وشبح الخروج البريطاني الماثل في الأفق المهنيين الأجانب من القدوم إلى بريطانيا. فإذا كانت بريطانيا تريد حقا أن تصبح قوة تصديرية عظمى، فينبغي لها أن ترحب بالمهاجرين وأن تعمل جاهدة لضمان أن تكون عملية الهجرة إليها أكثر سلاسة وانسيابية من الهجرة إلى منافسيها.
وربما أفضت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى انفتاح نسبي من جانب أسواق الخدمات في الصين، مما يؤشر بفرص جديدة لمصدري الخدمات. لكن حدوث مثل هذا الأمر قد يغلق أيضا أسواقا قائمة. ففي الولايات المتحدة مثلا، تنصح مؤسسة جولدمان ساكس المستثمرين بأن يضعوا أموالهم في الشركات ذات الواجهات المحلية كتدبير أسلم للتعامل مع عاصفة الحرب التجارية.
وقد وعد وزير التجارة الدولية ليام فوكس عند إطلاق الاستراتيجية التجارية الجديدة بأن يسهم ارتفاع الصادرات في زيادة مرونة بريطانيا الاقتصادية وجلب الوظائف الأعلى مهارة والأعلى أجرا إلى البلاد. لكن إن كان هناك من تغيير يحدث، فهو اتجاه بريطانيا نحو العكس تماما، إذ أنها قد سلكت طريقا يؤدي لمزيد من الضعف الاقتصادي والوظائف الأقل مهارة والأدنى أجرا، بما أقدمت عليه من تقويض للترتيبات التي كانت تتيح للشركات البريطانية الوصول بسلاسة ويسر إلى أكبر أسواق الخدمات في العالم، وانغلاقها على نفسها أمام الهجرة.
ليست هذه اللحظة المواتية لبريطانيا كي تسعى لاكتساب وضع قوة تصديرية عظمى، فإما أن تغادر الاتحاد الأوروبي، أو تسعى لزيادة صادراتها، لكنها لن تستطيع تحقيق الأمرين معا.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.