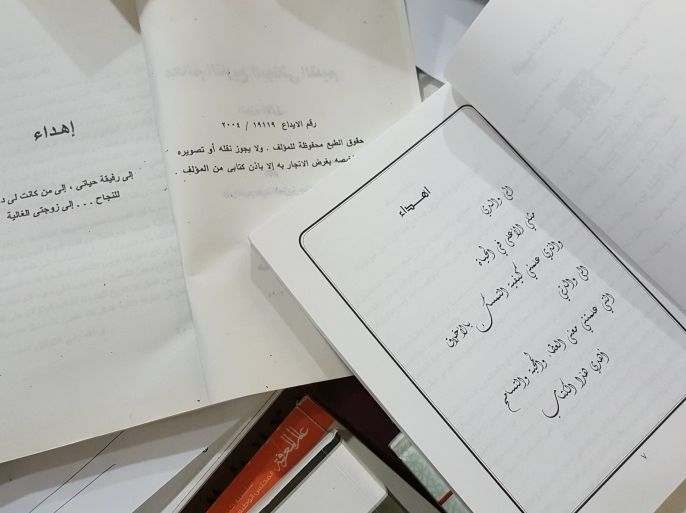سلامٌ عليكَ حيثما كُنتَ، أنت عالمٌ أنّه ليس أولَ إهداءٍ أرسله لك، لكنَّه سيكون الأول على العَلَن. الرقم صِفر سيُميّزك كالعادة، كان مُتعمّداً أن يكون صِفراً فأنت قبل الجميع. 14 عامٍ من الغياب، ومن الحنين لروحك الطاهرة ما تستحقُّ من الرحمة.
أمّا قبل..
فإنّي دائماً ما كُنت مُوَلعاً "شغوفاً" بإهداءات الكتب، وكُنتُ أعتقدُ جازِماً أنّ تلك الأحرف التي خَطّها الكاتَبُ مُسبقاً قبل الخَوضِ في مَكنونات كِتابه قد تُوازي أو تَفوق مُحتويات الكتاب بحدّ ذاتِه في أهمّيتها، ولطالما قامَ اختياري للكتب على نظرةٍ خاطفة سريعة ألقيها على الإهداء، ولاحظتُ في الآونة الأخيرة أنّي لستُ مُنفرداً في هذا، فالإهداءات الموجّهة في مُقدمات الكتب كانت ولا تزال بؤرة جذب عميقة تَشُدّ القارئ للكتاب رغماً عنه. ولا عجبَ مِن أنّ بعض الكتب قد شُهِرَت بإهدائتها، فمن منّا لا يعرف ذلك الإهداء "العظيم" في مُقدمة كتاب "كِش ملك" لكاتبه أدهم الشرقاوي مثلاً، أو إهداء غادة السمّان المميّز في مقدمة رواية "كوابيس" وغيرهما من الإهداءات اللّافتة والمتفرّدة. فلماذا تجذِبُنا إهداءات الكُتب أصلاً؟ سؤالٌ يستحق أن يُطرح وبإلحاح أيضاً، ويَكمُن الجواب هُنا في أنَّنا بارعون، بارعون فِعلاً.
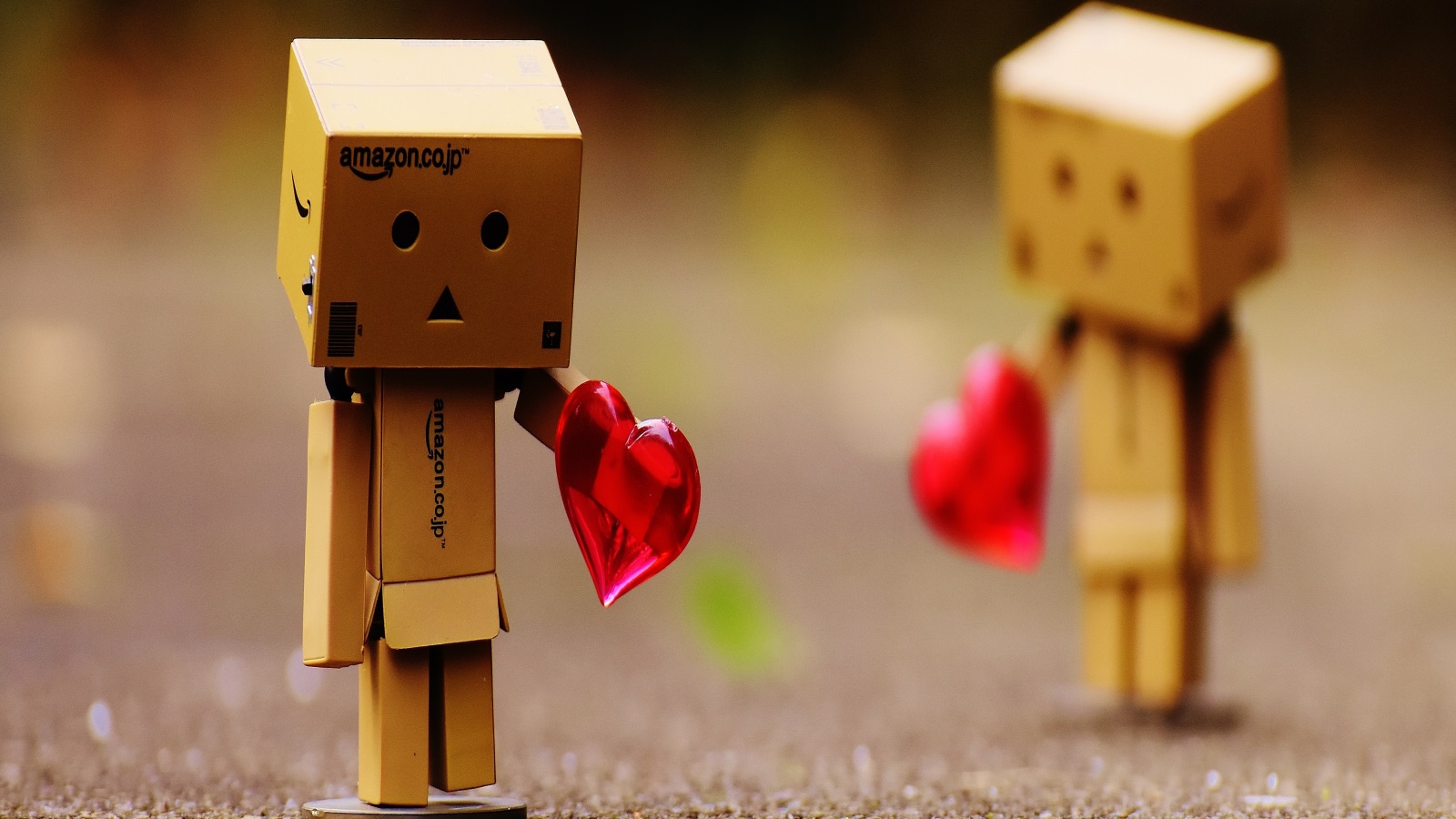
إنَّنا يا صديقي بارِعون في تأجيل كُلِّ شيء في حياتِنا اليوميّة، كُلّ شيء بمعناها الحرفيّ، بدايةً من الأعمال الروتينية البسيطة التي نؤجلها إلى أن تُصبح أطناناً نعجز أن نُنجزها، ولا نكتفي بهذا القدر بَل يطال عَجَزُنا وكسلنا المشاعر البشريّة على تعدُّد جوانِبها، فنبدع في تأجليها أيضاً وإدارجِها أسفل بند "مشاعر مع وقف التنفيذ"، فترانا نؤجّل الشُكر والعِرفان والمديح والاعتذار والاعتراف بالحُب. ولكنَّ تأجلينا يُنسَف عن بكرة أبيه حين نسخط على أحدهم، فنعجل بالذمّ والانتقاد وإبداء البُغض وصَبِّ جَمِّ كراهيّتنا المُتبادلة بإتقان وإبداع، في حين تبقى مشاعرنا الجميلة تَنعُمُ في جُمودِها وجمودِنا، حتى إذا ما مات فينا شخصٌ غَدا بطلاً قوميّاً جميلَ الخِصالِ والمكارم، محبوباً من الجميع لا يُذكر إلا بكلّ الخير، فكما يقول أحدهم: "لو عاد ميِّتُنا إلى الحياة ورأى عَظيم حُبِّ النّاس له بعد وفاته لمات مرّة أخرى من فَرطِ فرحته".
ولهذا وجدنا إهداءات الكتب تُلامس في دواخلنا "إهداءات لن تَصِلَ يوماً" لأشخاص نُحبّهم "بصدق وبقوة"، لكنَّنا لم نعتد على مُكاشفتهم بتلك المشاعر الجميلة إلا بعد ترجُّلِهم من قِطار حياتنا برحيلٍ مؤقت أو مؤبّد. ولعلّ الإهداء الذي بدأت به مُدونتي كعيّنة عشوائيّة مُقتبسة من واقع حياتي يكون أنموذجاً يُحتذى به في العلاقات الشخصيّة، فكم من كثيرٍ مثلي لم يحصل على ذلك الوقت الكافي لإيصال "إهداءاته" فكان مُرغماً على طيّها وكِتمانها، أمّا بعضكم فلديه من ذلك مُتَّسع، فلا تنتظروا، رُبَّما لن يُسعِفَكم الوقتُ لاحقاً.
| إلى تلك "الإهداءات التي لن تصل يوماً"، وإلى تلك الحروف التي ماتت في حلق صاحبها قبل أن تُلفظ، لو تعلمين كم كان وجودك سيغدو مهما، مهماً جداً. |
وعلى ذِكر الوقت، فإنّ الموت، السفر، المرض، كُلّها أمورٌ كفيلة بفكّ "شيفرات" مشاعرنا لشعورنا باقتراب انتهاء الوقت المُتاح لنا بقرب من نُحِبّ، وعامل الوقت في المشاعر الإنسانيّة هو قنبلة موقوتة ستنفجر قسراً ذات يوم، ناسفةً معها خيطَ أملٍ غليظ يُغلّف علاقاتنا التي نظنّها لوهلة "أبديّة" ومُخططات لم تكتمل – تم تأجيلها أيضاً كعادتنا -، لينحسر مَدُّ علاقاتِنا ويتضاءل زمنها وكأنها كانت بضع سويعات في "يوم أو بعض يوم"، وعندها تُصبِحُ الذكريات الجميلة بلَمح البصر ناقوساً يدقُّ باب القلب فيرتجف لها إجلالاً، ويُثبِتُ القلب ضعفه حينها مُنتَفِضاً مراراً وتكراراً نافضاً بذلك عنه ألما لن يستطيع له صبراً.
ولن نصل إلى مرحلة متقدمة من هذا الأمر سِوى بتلك "المشاعر مع وقف التنفيذ"، التي نُبدع فيها في وأد ذواتنا ونبالغ في استخدام "عقولنا" دون أن نُتيح لأنفسنا فرصةً لكي تُفصِحَ عما فيها، لنصل في نهاية المَطاف الى عجز تامّ ليس عن طَرح إهداءاتنا وحَسب، بل عن مُجرّد الردِّ على جميل القول والمديح والثناء. وتمضي أيامنا دون أن نُدرك أنَّ تلك الإهداءات البسيطة التي غادرنا أصحابها وما زالت في دواخلنا لن تُغادرنا أبداً، وستظهر حتماً لا محالة، رُبَّما في ثنايا تفاصيل صغيرة لا يأبه لها أحد، فتجدها في لمعات العيون، خفقان القلوب، الابتسامات العابرة والمفاجئة، الشرود التام، شعور الشوق المفاجئ، وفي صور الحنين المختلفة كتصفّح الصور الفوتوغرافية المشتركة والمحادثات القديمة واسترجاع الذكريات السابقة واستِذكارها.
وأمّا بعد..
فقد أصاب مصطفى محمود في مقتل حين قال: "اللهمَّ قِني شرَّ الحِرص والحذر والحيطة.. وأحيِني طِفلاً شُجاعاً وأمِتني طِفلاً شُجاعاً.. اللهمَّ إنّي لا أريد أن أكون محنّكاً أبداً.. أريد لقلبي أن ينفجر وهو يقول ما فيه ولا أريده أن يموت مطويّاً على سِرّه.. هذه حياتي ولست أملكُ حياةً غيرها، عاوِنّي لأمنحها كُلَّها، وأنفقها، وأبذُرها، وأهتك سِرَّها..".
تأمّلوها مرّة أُخرى.. "لا أريده أن يموت مطويّاً على سِرّه، هذه حياتي ولست أملكُ حياةً غيرها"، اسمحوا لفيض حروفكم بالتدفّق، واحرصوا على مَوت قلبكم ناطقاً بما فيه، لا تُميتوا ذواتكم وتُبدعوا في وأد مشاعركم، لا تخنقوا حروفكم مرّة تِلو الأخرى فتخونكم حين تكونون في أمسِّ الحاجة إليها، لا تنتظروا لحظات الوداع الأخيرة، أكررها مرة أخرى ربَّما لن يسعفكم الوقت حينها وربَّما لن تُسعفكم ذواتكم، فاحرصوا على "هَتكِ سِرَّها" بذكاء.
الإهداء الأخير:
إلى تلك "الإهداءات التي لن تصل يوماً"، وإلى تلك الحروف التي ماتت في حلق صاحبها قبل أن تُلفظ، لو تعلمين كم كان وجودك سيغدو مهما، مهماً جداً.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.