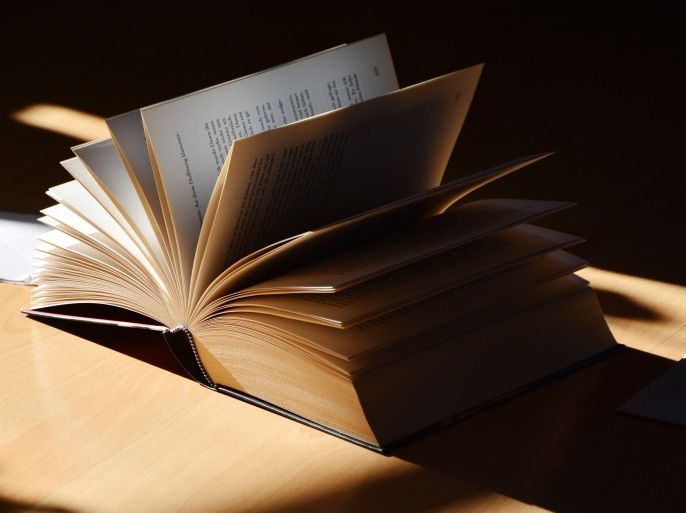وسرعان ما أصيب العقل المبدع المستنبط بحالة من الجمود حوّلته من قارئ منتج إلى متلق مكرّر، بينما انفتحت أشكال جديدة من القراءة ذات خلفية فلسفية على تراث الأمم الأخرى، فحاولت إيجاد نقاط الالتقاء بينها وبين الإسلام عبر آلية: "التوفيق والتلفيق"، ودخلت القراءات المتعددة في صراع طويل بسبب جمود بعضها وعدم تفريق البعض الآخر بين الميراث الإنساني المشترك الذي يبدعه العقل في تجرده، وبين مقولات الديانات والفلسفات القديمة ذات الخلفيات الماورائية والمنطلقات العقدية، لينتج لنا هذا الجدل صفحات طويلة من التجهيل والتكفير، ثم ألقى ليل التخلف ستاره على الجميع، ولم يستفيقوا إلا والغرب يطرق أبوابهم مستعمرا ناهبا قاتلا مهددا لوجود الأمة ذاته، دون أن يفرق بين أصحاب النص والرأي والكشف والذوق والعقل.
| إن المتأمل في العناوين الفلسفية التي تناقش في الجامعات أو تصدرها دور النشر في عالمنا العربي، يدرك مباشرة حالة التيه والضياع والتخبط التي تعانيها الفلسفة، فهذه العناوين لا تعدو كونها مسايرة "متأخرة" لما يكتبه فلاسفة الغرب. |
في الحباولات التي قامت بها الأمة لتجاوز تخلفها، كان يمكن للدرس الفلسفي العربي المعاصر أن يسهم إسهاما كبيرا في معالجة جوانب الخلل التي طرأت على الفكر الإسلامي منذ عقود طويلة، وهو الخلل الذي ألقى به في حالة من الجمود والتكرار والاجترار لمجموعة من المعارف بقيت تتداولها الكتابات دون نظر إلى اختلاف السياقات وتغير الظروف، وذلك بسبب العجز الكبير عن التفريق بين الدين والتديّن، وبين النص والتطبيق التاريخي له، وبين المقاصد الدينية الكبرى والمطلقة والمقاصد الفقهية الزمكانية، ما جعل هذا الفكر يصاب بحالة من الفصام بين مستويي التنظير والتطبيق، ورغم المحاولات الكثيرة التي رغبت في تجاوز حالة الجمود من خلال الدعوة لفتح باب الاجتهاد، والإصرار على تفعيل النظرة المقاصدية، وتعميق المراجعة لكثير من المسائل التي كانت خارج مجال إعادة القراءة، فإن النتائج لا تزال متواضعة جدا بسبب ضغط الموروث التراثي الذي تحوّل من موروث بشري مرتبط بسياقاته إلى موروث مقدس؛ نتيجة طرحه باعتباره يمثل دلالات النص الديني، وسرّ التشريع، وغاية الإسلام ذاته.
لا تهدف هذه المقالة المختصرة إلى متابعة أسباب الجمود والتفصيل فيها، ولكن إلى التنبيه لأحد أسباب العجز عن الإقلاع وتجاوز المعوقات، والمتمثل في محاولة علاج الخلل الفكري الذي تعيشه الأمة عبر القيام بإصلاحه انطلاقا من تصورات أخرى ترتبط بمنظومات معرفية مخالفة له تماما، وهو ما أسميه بحالة الضياع والتيه التي انخرطت فيها مختلف الجهود ذات الطابع الفلسفي، والتي تفسر أحد أهم الأسباب في عجز الفلسفة عن التحول من درس أكاديمي متعالي على المجتمع إلى درس واقعي تطبيقي ينخرط في إصلاح داخلي للمقولات الخاطئة من خلال إبراز الفوارق الهامة بين الدلالات اليقينية والظنية، وبين المطلق والمؤقت، وينتج مفاتيح جديدة في فهم النصوص واستيعاب الأحكام وتفعيل المقاصد وضبط الغايات.
يتجاوز الكثير من المشتغلين بالدرس الفلسفي من العرب سياق تشكل المدارس الفلسفية الكبرى في الغرب، ويغمضون أعينهم عندما يستلهمون من هذا الفكر ويوظفونه عن الملابسات والخلفيات المرتبطة بالمقولات والآراء والتوجهات، ويصرون على الفصل بين النظرية وصاحبها معتبرين الفلسفة تمثل منتوج العقل الإنساني المشترك الذي لا يقبل التقسيم العرقي أو الديني أو الجغرافي، مع أنهم يدرسون ويدرّسون لطلبتهم مرجعيات كل توجه فلسفي نشأ في الغرب، ويشكلون منها سلاسل عن الروابط الموجودة بين المدارس، وعن التأثير والتأثر.
لكنهم عندما ينتقلون لمستوى التوظيف لا يستحضرون قضية بالغة الوضوح، هي أن كل هذا المنتوج الضخم إنما ساير أزمات المجتمع الأوروبي، وترجم صراعاته الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبأنه تجلّ للمساعي الإصلاحية للفكر الغربي عبر العمل على إعادته للتاريخ وإخراجه من الصراعات القديمة المتجاوزة، أو عملية تحطيم وتهديم وتجاوز لبعض أشكال الموروث، خصوصا في لونه الديني للعودة إلى العقل زمن اليونان قبل أن تلبسه المسيحية، وهكذا يغفل المفكر العربي أن كل مدارس الفلسفة العربية اليوم تحمل في تقعيداتها وتأصيلاتها ومنطلقاتها تلك الصراعات والجدالات التي أنتجتها، لأن هذا سيوضح في الأخير أن ما يكتب باسم الفلسفة العربية/الفكر العربي إنما هو انخراط في سجالات تحدث خارج المجال العربي، ومجرد تكرار لتلك الآراء أو تفسيرها وتبسيطها لتقديمها للقارئ الجاهل باللغات الأجنبية، وليست شكلا من أشكال الإصلاح الداخلي، وما أقوله هنا ليس ادعاء لجهل هؤلاء بهذه القضية البسيطة بل بتجاوزهم لها.
| الدرس الفلسفي العربي لا بد أن يفهم دوره إذا أراد أن يترك بصمته في مسيرة الإصلاح الفكري، وذلك باستيعاب الحاجة الملحة للاشتغال على مشكلاتنا وليس على مشكلات غيرنا، والبحث عن تصورات ونظريات تجيب عن الأسئلة الملحة في منظومتنا المعرفية. |
إن المتأمل في العناوين الفلسفية التي تناقش في الجامعات أو تصدرها دور النشر في عالمنا العربي، يدرك مباشرة حالة التيه والضياع والتخبط التي تعانيها الفلسفة، فهذه العناوين لا تعدو كونها مسايرة "متأخرة" لما يكتبه فلاسفة الغرب، والمميز فيها هو ذلك القادر على مواكبة آخر النظريات والمقولات، فإذا تجاوزنا العناوين التي تقدم الفلسفة الغربية للقارئ العربي، وركزنا على العناوين التي تحاول تقديم قراءة نقدية في الفكر الإسلامي وجدناها تستنسخ المقاربات الأوروبية وتعيد إنتاجها بحذافيرها، وقد تجد بعضهم يكرر – بشكل بعيد كل البعد عن الوعي بما يكتب- مقولات تنطلق من إنكار الأديان ومن اعتبار فكرة الله والعالم الغيبي المفارق منتوجا إنسانيا خالصا يعبر عن جهل الإنسان بالطبيعة وقواها وأسرارها، ويظن أنه يعمل من خلالها على إعادة قراءة النص الديني واستنطاق مكنونه.
وهو ما يدل على حالة من العجز عن تلمس دور الفلسفة النقدي، وفهم للمنظومة المعرفية التي أنتجت الآراء المراد تقويمها، وعن حالة فصام غريبة بين عالمي الأفكار والوقائع، وهو ما يفسر عجز الفلسفة عن التموضع داخل منظومتنا المعرفية، بل إن بعض هؤلاء التائهين يضيفون لعجزهم إصرارا غريبا على تقزيم الجهود الجادة لتقديم فلسفة عربية إسلامية أصيلة من المفكرين المستقلين في رؤيتهم والواعين بمسؤوليتهم؛ أمثال: إسماعيل الفاروقي وطه عبد الرحمن وأبو يعرب المرزوقي.
إن الدرس الفلسفي العربي لا بد أن يفهم دوره إذا أراد أن يترك بصمته في مسيرة الإصلاح الفكري، وذلك عبر استيعاب الحاجة الملحة للاشتغال على مشكلاتنا وليس على مشكلات غيرنا، والبحث عن تصورات وآراء ونظريات تجيب على الأسئلة الملحة في منظومتنا المعرفية عبر أدوات يتم إبداعها لهذه المهمة بالذات، ويتم توظيفها في إصلاح الخلل والتنبيه لمكامن الغلط، ولا بد أن يتوجه نحو تقعيد قواعد وإنشاء مدارس ومناهج تستوعب المنظومة المعرفية للأمة، وتتعمق في فهم سياقات التراجع والتخلف لتحقق تراكما يمثل منطلقا نحو القراءة الجديدة الصحيحة التي تحفظ كيان الأمة وتصحح مسيرتها الفكرية.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.