كيف يفسر تأثير داننغ-كروغر أزمة كرة القدم الأزلية؟

"حازم إمام يقرر اعتزال كرة القدم، ونادي الزمالك يقرر تعيينه في قطاع الناشئين بالنادي"(1)
كان الخبر السابق عجيبا في صياغته. المقصود هنا طبعا هو حازم إمام الصغير، ظهير أيمن نادي الزمالك. هذا بديهي إن كنت تتابع الكرة المصرية، خاصة أن حازم إمام الكبير قد اعتزل منذ زمن، وخلال هذا الزمن شغل منصب: مدير الكرة، والمدير الرياضي، وأمين الصندوق، والإعلامي، والمحلل التلفزيوني، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس هيئة الفلك المصرية، وشيخ الأزهر، ورئيس مباحث الإنترنت. نحن نمزح طبعا، ولكننا لن نخبرك أيّا من تلك المناصب لم يشغلها، عليك أن تخمن ذلك بنفسك.

من البديهي أيضا أن يتم تعيينه في قطاع الناشئين بالنادي، نقصد حازم إمام الصغير طبعا، لأن حازم إمام الكبير منشغل بوظيفته الجديدة رئيسا لجامعة الأقصر. بالتأكيد نحن نمزح مجددا، المهم أنه لا داعي للاستغراب هنا، ولا داعي للشرح أو التفسير أيضا، حازم إمام الصغير اعتزل كرة القدم، ونادي الزمالك قرر تعيينه في قطاع الناشئين بالنادي. هذه أشياء تحدث كل يوم، ما العجيب إذن؟ العجيب أن اعتزاله بديهي فعلا، لكنه تعيينه "في قطاع الناشئين" ليس كذلك.
صيغة الخبر توحي كأن الأمر الثاني هو نتيجة للأول، حازم إمام اعتزل، ومن ثم عُيّن في قطاع الناشئين بالنادي، والسبب بديهي بدوره، إذ أين سيذهب حازم إمام بعد اعتزاله؟ هل سيعود إلى منزله مثلا؟ أين يذهب الناس بعد تقاعدهم؟ هل يتقاعدون فعلا، أم أن هذا ما تحاول المخابرات الأميركية إقناعك به؟
أنا مُميز.. أنت مميز
في حال كنت تتساءل عن المنصب، فهو نائب مدير قطاع الناشئين. أنت لم تكن تتساءل على الأغلب لأن درجة المنصب ذاتها ليست مهمة، في الواقع هي لم تكن يوما مهمة، هل سيشكل فارقا أن يكون حازم قد حصل على وظيفة مدرب فريق تحت 13 عاما أو 15 عاما؟ هل هو منصب إداري أم تقني أم تعليمي؟ هل سيخوض فترة معايشة أو -حاشا لله- دراسة قبل أن يبدأ العمل؟ لماذا لا يترك التدريب ويذهب للإعداد البدني أو الذهني أو النفسي؟ هذه أسئلة لا تُطرح عادة في كرة القدم.
قبل هذا الخبر بحوالي 23 عاما، كان عالما النفس، "ديفيد داننغ" و"جاستن كروغر"، يجريان تجربة فريدة من نوعها بهذا الزمن، وهذه التجربة كانت مبنية على سؤال وجودي بالغ الصعوبة: هل ندرك حقيقتنا فعلا؟ وكيف نفعل؟ هل تعلم من أنت؟(2)
داننغ وكروغر كانا يشكان أن الناس عادة ما تبالغ في تقييم خبراتها، كان الثنائي يحتاج إلى تصميم اختبار يمكّنهما من تأكيد شكوكهما أو نفيها، وبأي اختبار لا بد من نقطة مرجعية، قانون أو حقيقة مطلقة يمكن القياس عليها، ومن ثم تقييم النتائج. قرر داننغ وكروغر المزج بين المرجعيات النسبية والمطلقة في تجربتهما، فأعدا اختبارا يقيم الناس من حيث 3 معايير رئيسة: القدرة النحوية، وحس الفكاهة، والتفكير المنطقي. ثم طلبوا من المشاركين -وهذه أهم خطوة على الإطلاق- أن يقيموا مهاراتهم على المعايير الثلاثة(3).
بالطبع كانت هناك نتائج موازية للاختبار، هي تلك التي أعدها داننغ وكروغر بأنفسهما، وبمقارنة هذا وذاك، اتضح أن المجموعة التي احتلت مؤخرة الترتيب كانت، في الوقت ذاته، المجموعة التي شهدت تقييماتها لنفسها أكبر مبالغة ممكنة. على مقياس مئوي، لاحظ عالِمَا النفس أن هؤلاء الذين أتوا في الـ15% الأدنى، قيّموا مهاراتهم في المعايير الثلاثة بما يقارب الـ65%، وبفارق يعادل نصف الدرجات الممنوحة على الاختبار ككل.
لم تتوقف الإثارة هنا طبعا وإلا ما كانت الحكاية جديرة بأن تُروى، فما لاحظه داننغ وكروغر كذلك كان مبالغة طفيفة من أصحاب الدرجات المتوسطة، والأهم أن أصحاب أعلى الدرجات منحوا أنفسهم تقييما أقل من الحقيقي.
سحر المعرفة

بعد هذه التجارب، صُك المصطلح العلمي الشهير "تأثير داننغ-كروغر" للتدليل على تلك الحالة من ضعف إدراك الشخص لمقدار خبرته. باختصار، كلما زاد جهلك عن أمر ما، استدرجك عقلك للظن بسهولته، لأن هذا أسهل من تجربته وخوض صعوباته، وبالطبع أسهل من التفكير فيه ومحاولة تخيله.
فالمخ البشري، على عكس ما قد تتخيل، يعمل طوال الوقت وبأقصى سرعته للوصول إلى هدف واحد ثابت لا يتغير أبدا، وهو أن يتوقف عن العمل كلما أمكن، لذا كثيرا ما يخبرك أن كل شيء على ما يرام، إلا إذا أجبرته -مكرها- على العكس، وهذا ما يفسر أن أصحاب أعلى الدرجات تملكهم الشك في قدراتهم، لأنه بالمثل، كلما زاد ما تعرفه عن أمر ما، اعتقدت بأن هناك المزيد مما لا تعرفه.
نعم، كانت هذه مفاجأة صاعقة، نحن لسنا منطقيين، ولا موضوعيين، ولا تقودنا عقولنا كما نعتقد. يبدو هذا بديهيا جدا الآن، ولكنه لم يكن كذلك في 1999، ولا في 2023 في نادي الزمالك كما اتضح(4).
في أوائل القرن العشرين قرر الفيلسوف وعالم الرياضيات البريطاني "برتراند راسل" وأستاذه عالم الرياضيات "ألفريد نورث وايتهيد"، تحت إشراف حازم إمام، أن يُثبت أن 1+1=2. هذه العملية البدائية البسيطة أنتجت ورقة بحثية مكونة من 360 صفحة تقريبا، وللوهلة الأولى يبدو أن هذا هو ما فعله داننغ وكروغر هنا، تكبّدا الكثير من العناء لإثبات حقيقة معلومة بالفعل(5)(6).

هذا هو ما دفعهما نحو الجزء الثاني من التجربة، استدعيا المجموعتين اللتين حصلتا على أقل التقييمات وأعلاها، ثم طالباهما بتقييم بعضهما بعضا بالتبادل، ثم طلبا منهما أن يعودا مجددا لتقييم اختباراتهما الخاصة، على أمل أن يدرك المتفوقون أنهم متفوقون، وأن يدرك المتأخرون أنهم كذلك. طبعا لا بد أنك قد خمّنت ما حدث.
المتأخرون فاجؤوا الثنائي بالإصرار على منح أنفسهم درجات عالية مجددا لا تتناسب مع إجاباتهم في الاختبار، ومن هنا وصل داننغ وكروغر للخلاصة الثانية المهمة: أنت تحتاج للكفاءة لكي تدرك الكفاءة (It takes competence to perceive competence). ضعفاء الكفاءة لا يعانون من ضعف الكفاءة فحسب، بل إن ضعف كفاءتهم يعطلهم عن إدراك أوجه قصورهم(3).
إذا كنت تحتاج إلى الكفاءة لكي تدرك الكفاءة، فكيف ستكتسب الكفاءة إذن وأنت عاجز عن إدراكها؟ مرة أخرى، بدا الأمر أشبه بالدائرة المفرغة التي تبتلع الخريجين الجدد، لا أحد يعينهم لأنهم لا يملكون الخبرة، ومن ثم هم لا يكتسبون الخبرة أبدا لأن لا أحد يعينهم.
الحقيقة أن الأمر كان أبسط من ذلك بكثير، داننغ وكروغر لم يجدا بُدّا من تدريس قواعد النحو والتفكير المنطقي للمجموعة المتأخرة، وبعد كل درس كانوا يطالبونهم بإعادة تقييم اختباراتهم، ومع الوقت بدأت درجاتهم تتحسن، والأهم أنهم لم يعودوا يبالغون في تقييمها. مع كل حصة جديدة من داننغ وكروغر بدأ تأثير داننغ-كروغر يتراجع، ودخل في المعادلة تأثير من نوع آخر، تأثير المعرفة(3).
بيرلو ولامبارد وآخرون

لست ساحرا، ولكنني أؤكد لك أن حازم إمام -الكبير أو الصغير- لم يتلقَّ أي قدر من الدراسة أو المعرفة في المجالات التي اضطلع بها منذ اعتزاله، لأن الأمر ببساطة لا يحتاج إلى سحر، فقط يحتاج إلى عملية حسابية بدائية، أبسط حتى من 1+1=2، الرجل أعلن اعتزاله في اللحظة ذاتها التي أوكلت له فيها وظيفة نائب مدير قطاع الناشئين. هذا يشبه أن تنهي آخر اختبار في الشهادة الثانوية صباحا، ثم تبدأ في التدريس لطلبة الشهادة الثانوية مساء.
هذا ما فعله فرانك لامبارد أيضا. في الواقع، لامبارد ترك فريقه الأخير، نيويورك سيتي، في منتصف موسم كرة القدم الأميركي، الذي يبدأ في فبراير/شباط وينتهي في ديسمبر/كانون الأول، لينضم إلى أكاديمية تشيلسي مُدرّبا مطلع يوليو/تموز 2018. بمعنى آخر، لامبارد خرج في منتصف آخر اختبار في الشهادة الثانوية ليبدأ التدريس مباشرة(7)(8).
هذا التسلسل الزمني يؤكد لك أن الاتفاق والتعاقد على الوظيفة كان يجري على قدم وساق وهو لا يزال يمارس كرة القدم بوصفه لاعبا. السبب هنا بديهي أيضا، لأن أندية كرة القدم لا ترى أن هناك عملية تعليمية ضرورية قبل تولي مسؤولية تدريب مجموعة من الأطفال والمراهقين عاثري الحظ.
السبب لهذا السبب بديهي بدوره، لأن أغلب من يتولون المناصب الإدارية في هذه الأندية هم لاعبون سابقون أيضا، وجرى معهم الأمر بالطريقة ذاتها، وبما أنك تحتاج إلى الكفاءة لتدرك الكفاءة، فنحن نتحدث هنا عن مجموعة من منعدمي الكفاءة يرشحون ويعينون بعضهم بعضا، ولا يدركون الكفاءة لأنهم لا يمتلكونها ابتداء. هذا مشهد يشبه لقطة عبور الشارع الشهيرة في فيلم الكيت كات.
بعد تلك التجربة، لم يحتج لامبارد إلا لموسم واحد فقط مع داربي كاونتي بالدرجة الثانية الإنجليزية، التشامبيونشيب، امتطى فيه اسمه ومهارات لاعبيه ليحقق نتائج غير منطقية، أظهرت إحصائيات الأهداف المتوقعة أن أفكاره لم تكن السبب الرئيس فيها، ليتولى مسؤولية المدير الفني لنادي تشيلسي لكرة القدم، ثم توضع في يده مئات الملايين في الصيف التالي، لا يزال تشيلسي يحاول استعادة بعضها الآن بعد موسم تعاقدات هزلي أبرمه الرجل، ضم فيه الكثير من العناصر الجيدة، ولكنه لم يكن يملك أدنى فكرة عن كيفية دمجها في فريق واحد.
هذا الانحياز الصارخ لمنعدمي الكفاءة مع سبق الإصرار والترصد يتجلى بوضوح في تجربة بيرلو التدريبية المضحكة، الرجل لم يكتفِ بالتقاعس عن جمع المعرفة، ولم يكتفِ بالقفز فوق مراحل التجربة والخبرة ممتطيا اسمه الكبير بوصفه لاعبا، بل إنه -بمنتهى الاستخفاف والاستحقاقية- استخدم رسالة تخرج مساعده، إيغور تيودور، للحصول على الرخصة(9)(10)

إيغور كان مدافعا سابقا في يوفنتوس أيضا، ولكنه لم يكن بنجومية بيرلو طبعا، ومن ثم لم يكن يملك اسما يقفز به عبر الحواجز التقليدية. تلك كانت الرواية المتداولة عن هذه القصة، ولكن حتى هذه الرواية اصطنعها هؤلاء الذين تعاطفوا معه باعتباره الرجل الثاني المسكين الذي يحمل كل المفاتيح ولا يظهر في الصورة. الحقيقة كانت غير ذلك.

تيودور نفسه مر بالتسلسل ذاته، فبعد اعتزاله بعام واحد كان يدرب الناشئين في أكاديمية ناديه الأول الذي نشأ به، ثم بعد 3 سنوات فقط لا غير كان يشغل وظيفة مساعد مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، والمدير الفني للنادي ذاته في الوقت ذاته(11)(12). الفارق الوحيد هنا أنه فعلها في نادٍ مغمور في كرواتيا اسمه "هايدوك سبليت"، ومن ثم استغرق وقتا أطول في الوصول إلى وظيفة يوفنتوس. الفارق الوحيد هنا أن تيودور لم يكن إيطاليّا أنهى مسيرته في أحد أكبر أندية بلده، بل كرواتيّا نشأ في نادٍ لا يتأهل حتى لدوري الأبطال. باختصار، تيودور أُجبر على التعلم والاحتكاك قبل أن يصل لوظيفة يوفنتوس، ببساطة لأن طريقه كان أطول من طريق بيرلو بحكم الجنسية. الآن سَلْ نفسك: كم إيغور تيودور آخر كانوا ضحايا لإيغور تيودور الأصلي خلال رحلته؟ لا نعلم، وغالبا لن نعلم.
عنصرية الفقراء
الكثير من الأفكار تلتقي في تلك النقطة لتفسر الكثير من الظواهر العصيّة. في كتابهما المرجعي "Soccernomics"، حاول "سايمون كوبر" و"شتيفان زيمانسكي" -تحت إشراف حازم إمام- دراسة الأسباب المنطقية لفشل منتخب إنجلترا التاريخي في البطولات الدولية، وأحد الأسباب التي توصّلا إليها كان حقيقة أن كرة القدم الإنجليزية ظلت -لعقود طويلة- مجالا مقصورا على أبناء الطبقة العاملة(13).
يظهر ذلك جليا من الخلفيات الاجتماعية والفئوية لأغلب لاعبي المنتخب عبر السنوات، إذ اقتصرت وظائف آبائهم على طبقة محددة من المجتمع الإنجليزي، حرمته من التعدد والتنوع والاحتكاك بثقافات وتجارب مختلفة والاستفادة منها، لأن، وكما يقول "دانيل هارغريفز"، أحد المسؤولين بأكاديمية إيفرتون الذين حاورهم كوبر، الكرة الإنجليزية لا تبحث عن المواهب إلا في هذه الطبقة إيمانا بأنها تملك الدوافع الأكبر للنجاح وإثبات الذات.
ربما يكون ذلك صحيحا، وربما لا، ولكننا لن نتأكد أبدا حتى تتاح الفرصة للجميع بقدر متكافئ، وهذا ما لم يكن يحدث في إنجلترا قط حتى وقت قريب. في الواقع، كانت أي أمارات على الانتساب لطبقة اجتماعية أو ثقافية مختلفة كفيلة بنبذ صاحبها، واستخدام اختلافه عن التيار السائد سببا لإقصائه، بل وإهانته في بعض الأحيان.

هذا ما تحكيه قصص أمثال باتريك بامفورد وغرايم لوسو وغيرهم من هؤلاء الذين تمكنوا من اختراق فقاعة كرة القدم الإنجليزية رغم قدومهم من عائلات ميسورة الحال وحصولهم على قدر من التعليم غير معتاد في هذه الأوساط. الأول مثلا عانى من القوالب النمطية طيلة مسيرته تقريبا لأنه مثقف يعزف الموسيقى ويجيد 3 لغات. في "ميدلزبره" مثلا كان مهمشا لدرجة أن مدربه "آلان بارديو" ومساعده لم يكونا يعلما إن كان أعسر القدم أم أيمنها. قف للحظة لتدرك أن هذا المستوى من الإقصاء يعني أنهم لم يتخيلوه يلعب أبدا، ولا حتى في أحلامهم(14)(15).
الثاني بدوره كان يتعرض للتنمر باستمرار في تشيلسي والمنتخب الإنجليزي، لدرجة أن بيكام وصفه بـ"الشاذ" ذات مرة لمجرد أن لكنته مختلفة، وفي مرة أخرى فرشوا طبقة من مرهم العضلات بداخل حذائه، فتحول إلى فرن يشوي قدميه أثناء المباراة(13).

هذا نوع مختلف من العنصرية الفئوية غير ذلك الذي اعتدت السماع عنه، ولكنه، مثل أي نوع من أنواع العنصرية، يوجِد مجالا مغلقا، مكدسا بالأشباه والمتماثلين المنتمين لنفس اللون من الطيف، وهذا يعني أن مميزاتهم تتضاعف، ولكنه يعني كذلك أن عيوبهم تتضاعف.
تشمل قائمة المميزات تلك الكثير من الجَلَد والإصرار، والكثير من القوة الشخصية والقدرة على تجاوز الصعوبات، كما لك أن تتوقع ممن "صنعوا أنفسهم بأنفسهم" دون أن يولدوا بحظوة اجتماعية أو ثقافية أو مادية، ولكن في الوقت ذاته هناك الكثير من العداء للثقافة والمعرفة والعلم، والكثير من العداء لخريجي الجامعات والميسورين، والكثير من العداء لمن لم يخوضوا الرحلة ذاتها بالمصاعب ذاتها.
هذا يجعل تلك المجتمعات أشبه بغرف صدى الصوت، حيث الجميع يتحدث اللغة نفسها، ويقدس القيم نفسها، ويتبع المبادئ نفسها. وفي تلك الأجواء، يستغرق الناس في تجاربهم الذاتية، ولا يرون العالم إلا من خلالها، ويصبحون عاجزين عن تقدير أي مختلف أو جديد، بل ربما يستنفرهم ويشعرهم بالتهديد.
هذا يُنتج أناسا يشعرون أن هناك نوعا واحدا قيّما من الخبرة، هو الخبرات الحياتية العملية، ونوعا واحدا قيّما من المعرفة، هو المعرفة الدارجة المتداولة، ونوعا واحدا قيّما من التجربة، هو تلك التي جرت على العشب. عندما تضيف لكل ما سبق شعورا كاسحا بالاستحقاق بعد مسيرة ناجحة كلاعب تكون النتيجة كابوسا حقيقيا، شخصا ضعيف الكفاءة لدرجة أنه لا يدرك مدى ضعف كفاءته، شخصا يملك نفس معلومات "رضا عبد العال" الكروية وضِعف ما يملكه غوارديولا وكلوب -مجتمعَين- من ثقة.
رجل القش
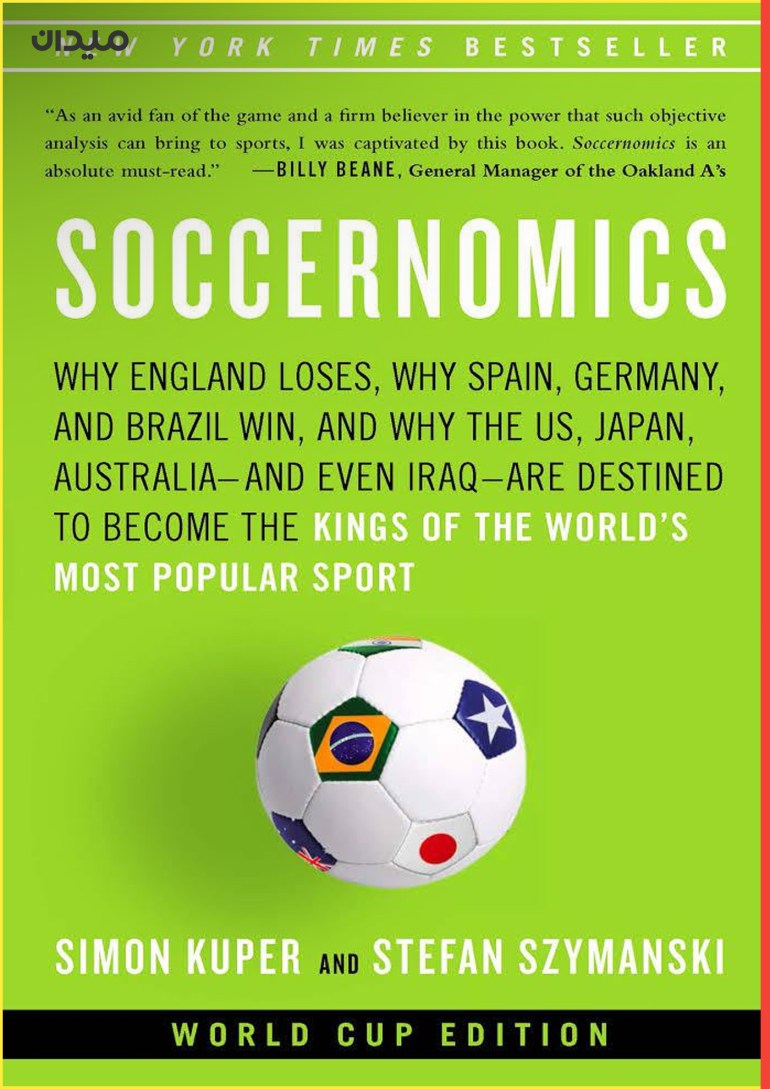
هذا ينتج أيضا أناسا يخلطون بسهولة بين الموهبة التقنية والقدرات البدنية التي يحتاج إليها اللاعب لكي يصبح مميزا، وبين المعرفة التي يحتاج إليها المدرب لكي يجيد استغلال اللاعب ذاته، بين الطريقة التي يتعامل بها أحدهم مع أزماته النفسية والذهنية بصفته لاعبا، وبين الدعم الذي يجب أن يقدمه الطاقم التدريبي، وهو، في ظاهره، خلط شديد السذاجة، وبلا أساس منطقي، وكأنك تفترض أن سرعة قدميك تجعلك معلما جيدا للأطفال، أو أن خفة حركتك تؤهلك لوضع خطة تكتيكية مفصلة.
الميزة الحقيقية الوحيدة التي تمنحها مسيرة في كرة القدم لمدرب جديد هي الألفة والعلاقات الشخصية المستمرة، أنه سيمتلك أفضلية على مدرب آخر لم يكن لاعبا في النادي ذاته، ولا يعلم خباياه وتفضيلات مسؤوليه ومواطن ضعفهم وقوتهم، ومن ثم سيستغرق وقتا أطول في التعرف على كل ذلك إن لم يساعده أحد أو يرشده.
هنا يقع الخلط الأبله المتعمد بين الألفة والمعرفة، وهذه هي المشكلة بالضبط: الألفة، لأن الألفة لا تُغير ولا تعالج الأخطاء ولا تطور الأنظمة ولا تثوّر ما يحتاج إلى تثوير، بل العكس تماما، الألفة تعيد إنتاج الواقع مرة أخرى، بالعيوب والمميزات ذاتها، ولكن ببصمة شخصية، وهذه البصمة تكرس الانحياز المطلق للتجارب الذاتية، وتضعها فوق كل المعاملات الإنسانية، بما فيها العلم والدراسة وتحصيل المعرفة.
صحيح أن التجارب الذاتية مهمة ويمكن استخلاص الكثير من الدروس عبرها، ولكنها تُعامل في هذه الأجواء نفس معاملة اختبار داننغ-كروغر، فيُترك تقييمها لأصحابها الذين يبالغون في تقديرها، وكل منهم متيقن أن لا أحد قد مر بما مر به، ومن ثم فلا أحد يملك ما يُعلمه إياه. لذا كثيرا ما تسمع عن "حس اللاعبين"، و"فلان الذي لم يَرتَدِ السروال والقميص"، و"الأشياء التي لن يدركها من لم يلعب كرة القدم"، وبرغم حقيقة أن تجربة لاعب كرة القدم لها خصوصيتها فعلا، فإن تلك الخصوصية تحولت مع الزمن إلى ما يشبه الكهنوت، محراب مقدس لا يدخله إلا من ارتدى السروال والقميص، ولغة مشفرة لا يفهمها البشر العاديون.
النتيجة هي أنه في غياب أي كفاءة أو قدرة على الإدراك يصبح المرجع الوحيد هو الأشخاص أنفسهم وما مروا به، الأمر يشبه صديقك السخيف السمج الذي كلما حاولت إخباره بأمر جرى معك قاطعك ليحدثك عن مغامراته وصولاته وجولاته، ومؤكدا أن الأمر نفسه حدث له ولكنه تجاوزه بالنصيحة التي سيخبرك بها حالا، والتي كثيرا ما تكون عبارة بلهاء مختصرة تتظاهر بالعمق والخطورة، ولكنها غالبا لا تنطبق إلا عليه.
النتيجة لكل ذلك مجتمع غارق في ذاته، لا يرى أبعد من أنفه، ولا يفسر العالم إلا من خلال تجربته، معتقدا أنها قد جمعت الدنيا وما فيها، ولعجزه عن تخيل ما يتجاوزها، يموت رعبا من كل ما يجهله، وأقصى ما يمكنه فعله هو إعادة تدوير ما سبق، دون قدرة حقيقية على الابتكار أو التفكير النقدي أو مراجعة الذات.
في الكتاب السابق ذاته، يثبت الثنائي "كوبر" و"زيمانسكي"، عبر دراسة إحصائية طويلة على عقود طويلة من نتائج كرة القدم الإنجليزية، أنه لا يوجد أي ارتباط حقيقي بين نجاح المدرب وكونه لاعبا سابقا، والاستنتاج الأهم من ذلك هو أن الحظوة والأفضلية المسبقة التي يتمتع بها كثير من اللاعبين السابقين عند دخولهم مجال التدريب لا تدفعهم فعليا سوى للتكاسل والتمسك بقناعاتهم، بينما من يقبعون خارج هذه المنظومة يحركهم الشغف الدائم والرغبة في التعلم والإحساس بالنقص لأنهم لم يمارسوا اللعبة بصفتهم محترفين.
1% إيمان.. 99% حظوة

كل ما سبق يتم في أجواء تكريمية مصطنعة وبالغة الافتعال يمكنك استشعارها بسهولة من صيغة خبر حازم إمام، هذا خبر لم تكن تنقصه سوى فاء السببية: "حازم إمام يقرر اعتزال كرة القدم، فيقرر نادي الزمالك تعيينه في قطاع الناشئين".
هذا هو ما لا يقال ولكن يمكنك قراءته بسهولة بين السطور، وكأن الوظيفة المنتظرة عقب الاعتزال، سواء كانت في الأكاديمية أو في ستوديو التحليل أو في الإدارة العليا للنادي، هي تكريم احتفالي بنهاية مسيرته، ومكافأة على ما أنجزه خلالها.
الآن دعنا نخبرك بالمشكلات في ذلك: أولا، هذه المكافأة ليست مالية أو عينية، لكنها تأتي على حساب صورة أطفال ومراهقين يحلمون بالتحول للاعبي كرة قدم محترفين، وبدلا من أن يقودهم متخصص متعلم، حتى لو كان لاعبا سابقا، سيقودهم رجل يؤمن بأن نصف هذه المؤهلات كافٍ وحده، والأهم أنه يعتقد أن نصف هذه المؤهلات هو كل هذه المؤهلات. أحد هؤلاء ظهر في أحد البرامج ذائعة الصيت وهو يعنّف طفلا ويسخر منه ليضحك كل زملائه ثم يطرده من التدريب، معتقدا أن هذا دليل على قوة الشخصية والجدية في العمل.
الكارثة هنا ليست مقصورة على أنه لا يملك ما يعلمه للولد، بل في حقيقة أنه قد يشوهه نفسيا إلى الأبد، ببساطة لأنه لم يحصّل حرفا من التعليم حول كيفية التعامل مع الأطفال قبل أن يتولى الوظيفة.
ثانيا، لماذا يحتاج أي لاعب كرة قدم سابق إلى مكافأة في نهاية مسيرته أصلا سواء كانت عينية أو مالية أو في صورة قرابين بشرية؟ نحن نتحدث عن فئة تنتمي للـ1% الأغنى في أي بلد مهما كان فقيرا.
قف للحظة وحاول إدراك مدى سخافة الفكرة، هناك شعور عام أبله تم تكريسه مع الزمن بأن مجتمع كرة القدم والجمهور والأطفال والناشئون مدينون للاعبي كرة القدم السابقين لسبب ما.
ثالثا، يجسد خبر تعيين حازم إمام مدى التدهور الذي تقودك إليه إعادة إنتاج الواقع بحذافيره، فبعد فترة من تقديس النجوم السابقين، باعتبارهم مصدر إلهام للناشئين الجدد، تنخفض المعايير تلقائيا لتعيين أي لاعب سابق، حتى لو لم يكن نجما، وحتى لو لم يكن كفئا، وحتى لو لم يكفِهِ عقد كامل ليعي أساسيات مركزه.

فقط حاول تخيل الوظيفة التي ستسند إلى شيكابالا مثلا بالقياس، لن نندهش إن أصبح مدير الأكاديمية حتى قبل اعتزاله.
رابعا، الأمر -للمصيبة- لا يتوقف أبدا عند تولي وظيفة تدريبية أو إدارية بالنادي، بل بعد فترة، يبدأ اللاعب السابق في البحث عن أضواء الكاميرات مجددا بنهم مَرَضي. خلال الأسبوع الماضي مثلا، أنهى أحمد حسام ميدو صباحه بصفته مدربا لفريق الإسماعيلي، ثم تحول لإعلامي في برنامجه المسائي ليناقش أداءه بصفته مدربا للإسماعيلي، ثم خرج إلى فاصل ليستضيفه إعلامي آخر عبر مداخلة بصفته مدربا للإسماعيلي. بالطبع لا مانع من ظهور عابر في عدد من الأكاديميات لكي يطمئن آباء هؤلاء الأطفال أن النجم الكبير يشرف على تدريب أبنائهم، تحت إشراف حازم إمام طبعا.
وأخيرا، بعد أن نتجاوز كل ما سبق، تبقى بعض التفاصيل البسيطة التي لا تهم أحدا، مثل حقيقة أن تجارب هؤلاء اللاعبين الذاتية وخبراتهم السابقة في الملاعب ينقصها الكثير من البديهيات بدورها.
تخيل مثلا حازم إمام مديرا لكرة القدم وهو يحاول إقناع اللاعبين بالالتزام بالتعليمات بينما هم يعلمون جيدا أن مشكلته الرئيسة طوال مسيرته كانت في الحفاظ على لياقته والاجتهاد في التدريبات البدنية، فكر في أحمد حسام ميدو والوزن الزائد والتدخين ونهاية مسيرته المبكرة في حازم إمام الصغير والمعارك الموسمية مع الزملاء، في الحضري وفضيحة تسريب اللقاءات الصحفية في فندق المنتخب بمونديال 2018، في حسام غالي ووقائع الاعتداء على الزملاء والخصوم أكثر من مرة. القائمة طويلة فعلا.
هل يتوقف الأمر عند ذلك؟ بالطبع لا، لأن -كما أسلفنا- تكريس الواقع وإعادة إنتاجه مع كل جيل جديد معتزل من اللاعبين يُخفض المعايير درجة أو درجتين، لدرجة أن المجال تكدس بمجموعة من أصحاب الحظوة الجشعين الذين يراكمون الأموال والوظائف دون أدنى فكرة حقيقية عن كيفية أدائها، ثم للإمعان في البلادة، لا يحاولون حتى تطوير أنفسهم أو اكتساب المعرفة التي قد تساعدهم على أداء أفضل لهذه الوظائف. هذه هي درجة الأمان الوظيفي والمادي المرعبة التي تعيشها فئة من اللاعبين السابقين شديدي الكفاءة في كرة القدم، منعدمي الكفاءة في كل ما يتعلق بها.
الحل؟ في الواقع، هذا هو الأكثر استفزازا في القصة كلها، لأنه الحل ذاته الذي أنتجته تجربة داننغ-كروغر ببساطة: دروس مكثفة في النحو والتفكير المنطقي وحس الفكاهة، تحت إشراف حازم إمام طبعا.
____________________________________
المصادر:
- حازم إمام يعتزل كرة القدم ويواصل العمل في الزمالك – Filgoal
- تأثير داننغ-كروغر – Psychology Today
- تأثير داننغ-كروغر؛ لماذا يولد انعدام الكفاءة الثقة؟ – The New York Times
- الجميع متحيزون بما فيهم أنت؛ المسرحية التي أعدها علماء الأعصاب! – The Guardian
- 10 أشياء معقدة بشكل خادع – List Verse
- برتراند راسل وألفريد نورث وايتهِد؛ برينشيبيا ماتيماتيكا – The Story of Mathematics
- مسيرة فرانك لامبارد كلاعب – Transfermarkt
- مسيرة فرانك لامبارد كمدرب – Transfermarkt
- مسيرة أندريا بيرلو كلاعب – Transfermarkt
- مسيرة أندريا بيرلو كمدرب – Transfermarkt
- مسيرة إيغور تيودور كلاعب – Transfermarkt
- مسيرة إيغور تيودور كمدرب – Transfermarkt
- كتاب سايمون كوبر وشتيفان زيمانسكي Soccernomics – Amazon
- لا يوجد شيء اسمه لاعب كرة قدم سييء! – The New York Times
- بامفورد تحت قيادة بييلسا هو دليل على قوة الحب! – The Athletic

