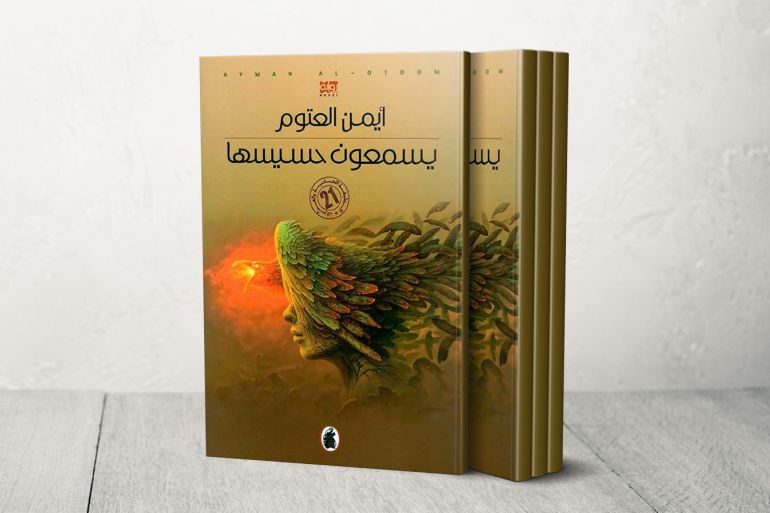أولا وقبل كل شيء إن كنت من ضعاف القلوب أو سريعي البكاء والانهيار فلا أنصحك بقراءة الرواية إلا بعد أن تهيء نفسك لما هو آت، فتُحصّن قلبك جيدا، وتنبّه على عينيك أن تتماسك قليلا وتدّخر الدموع إلى أواخر الرواية، لأنك إذا هممتَ بالبكاء مبكرا فلن تجد دموعا لتبكي متأخرا، وإذا أرهقت قلبك في السطور الأولى فلن يتحمل أن يكمل باقي السطور، لذلك فاستعد جيدا قبل أن تُمسك بغلاف الرواية وتقلبه لتُبحر في بحر من الآلام والمعاناة لن تقوى ليس فقط على تصوّره، لا بل لن تستطيع حتى إجبار عقلك بشتّى الطرق على تصوّره، لن يستوعب ذلك العقل البشري الموجود في رأسك كإنسان مقدار ما في تلك الأحداث من طغيان لا إنساني، وجبروت شيطاني، يجعلك تشكّ أن تلك الأحداث حدثت على كوكب الأرض أو حتى في مجرّة درب التبّانة!.
الرواية تُصنف من روايات أدب السجون، للكاتب الأردني أيمن العتوم، وتحكي قصة وأحداث حقيقية حصلت للشخصية الرئيسية في الرواية (الطبيب السوري إياد أسعد) خلال 17 عاما من عام 1980 إلى 1997م، ومكانها سجن تدمر في مدينة تدمر السورية، رغم أنه سينتابك الشك عند قراءة سطور الرواية بأن تدمر السجن ليست تدمر سوريا في كوكب الأرض، بل هي تدمر الجحيم في الأرض السابعة أو تحتها، حيث سُجن بطلنا الطبيب السوري إياد أسعد في سجن تدمر بعد توقيفه لمدة من الزمن في فرع الخطيب الأمني بتهمة الانتماء الى جماعة محظورة.
لفت انتباهي بالرواية أمور كثيرة، أبدأها بالمدة الزمنية التي قضاها الطبيب إياد أسعد في المعتقل، فهي ليست شهورا ولا بضعة سنوات، وإن كان اليوم هناك يُعدّ بآلاف الأعوام بما فيه من عذاب، لكنها 17 عاما كاملة
يسرد الطبيب إياد أسعد بقلم الروائي أيمن العتوم ذكرياته المؤلمة في سجن تدمر، وإن كان وصف الألم لتلك الذكريات لا يوفيها حقها ابدا، ذلك أن مجرد الألم في تدمر السجن يُعتبر لمسة حانية مقارنةً بما يعانيه القابعون هناك، هناك في جحيم الظلمات تحت أيدي الظالمين، هناك حيث رائحة الموت تُستنشق مع الهواء كل لحظة، هناك حيث الخروج من عالمك إلى عالم الظلم والقهر وسحق الكرامة، هناك حيث فقدان الأحبة كل يوم، هناك في جبروت اللاإنسانية بلا نهاية، هناك سُجناء آدميون وسجّانون لم يصل ماء أبينا آدم إليهم أبدا، هناك في تدمر يتمنى المرء أن يخرج من بين أيديهم حتى لو تلقفته أيدي يأجوج ومأجوج، يتمنى لو يُسجن في قبضة الأعور الدجال لا في قبضة (أبو نذير) مدير السجن، لأن الأعور الدجال كافر ودجال أما أبو نذير فهو كافر ودجال ولص وظالم ومفترس، يتلذذ برائحة الدماء، يستمتع بسحق الكرامة وإذلال البشر، يعشق رؤية الشهداء معلقين على أعواد المشانق، يروي صحراء تدمر بدمائهم حتى أظن الصحراء بكت دفائنها، هذا إن شفق على تلك الجثث، وإلا فكانت تُرمى بدون دفن حتى شبعت بطون حيوانات الصحراء المفترسة بلحوم الأبرياء.
يروي العتوم بلغته التي عهدناها بما فيها من بلاغة وصور أدبية رائعة ذكريات الطبيب إياد أسعد، تلك الذكريات بتفاصيلها الدقيقة، كيف ينامون، كيف يفكرون، كيف يأكلون، كيف يُعذبون وكيف يموتون، والأصعب من الموت هو انتظاره كل لحظة، فلا أنت حي ولا ميت، ولا أنت في الدنيا ولا في البرزخ، ضيق في المكان، وضيق في الصدر، وضيق في التفكير، سنين سنين والرؤوس منحنية بإذلال حتى أصاب الرقاب تقوس، أما الأجساد فباتت لوحات من الفن التشكيلي تُرسم بالسياط كل يوم، حتى إذا ما أشفق الزمان على تلك الخطوط بالبراء عاجلها الرسامون المجرمون بغيرها، الرؤوس لا تتلقى سوى أحذية العساكر وضرب المواسير الحديدية، الوجوه لا تتلقى سوى اللكمات القاتلة، فهذا يعود للزنزانة يحمل عينه بيده، وذاك مهشم الفك، والآخر تتساقط أسنانه ويتمزق فمه، ناهيك عن حفلات التعذيب الجماعي من سحل وركل وضرب يؤدي إلى موت بعض السجناء في كثير من الأحيان، ولكن من يأبه بالموت من الظالمين.؟! هم يعشقون رؤية الناس تموت، فذاك هو زادهم وسر بقائهم، يا للعجب..!! كيف يكون موت الناس حياة لغيرهم؟!
لفت انتباهي بالرواية أمور كثيرة، أبدأها بالمدة الزمنية التي قضاها الطبيب إياد أسعد في المعتقل، فهي ليست شهورا ولا بضعة سنوات، وإن كان اليوم هناك يُعدّ بآلاف الأعوام بما فيه من عذاب، لكنها 17 عاما كاملة، ولك أن تتخيل أخي القارئ كل تلك المدة بأيامها وكل يوم يحمل ما يحمل من الاضطهاد والعذاب والموت، والأمر الآخر هو تفاصيل حياة الطبيب إياد أسعد الشخصية، فهو رجل متعلم يعمل بالطب، متزوج كان يعيش حياة هانئة هادئة، له أب وأم وابنته لمياء بربيعها الأول، وزوجة كانت تحمل في أحشائها طفله الثاني أحمد حين تم اعتقاله، أحمد الذي سُمي على اسم شقيق الطبيب إياد المهندس أحمد، الذي شاءت الأقدار أن يعتقل بعده في نفس السجن ويتم إعدامه أمام ناظري شقيقه، 17 عاما لم ير الطبيب أحد من أهله إلا شقيقه وهو يموت..!! وهنا نستشعر المعاناة والألم التي شعر بها الدكتور إياد؛ فرغم ألم فقدان الأخ وموته إلا أن مشهد أخذ جثة أخيه إلى الصحراء بدون أن يعلم مصيره -أيدفن أم يُرمى طعاما لوحوش الصحراء- كان الأكثر إيلاما.
أما لمياء الصغيرة، فتلك الحكاية الأشد وجعا وقهرا في الرواية، فكل ما سبق -على فظاعته- كان في صخب الواقع وفوضى الحياة، لأن الدكتور إياد كان يعيش يومياته مسجونا في أشد أنواع العذاب الجسدي والألم النفسي مع باقي النزلاء، يتألمون ويبكون ويصرخون، ويموتون، ثم تبرأ بعض الجراح وتندمل قبل أن يعاود السجّانون نبش لحمهم حتى العظم من جديد، ولكن لمياء جرح من نوع آخر، ألم ليس كسابق الآلام، هو طعنة بالروح وكي للوجدان كل يوم وكل لحظة، وأكثر ما يؤلم في ذلك الجرح أن الطبيب إياد كان يشعر به منفردا، في سكون الليل ووحشة الظلام، طفلته الجميلة تركها بعمر العام، بملامحها تلك وابتسامتها تلك، وتفاصيلها التي تغيرت مع مرور الوقت، ذلك الفصل من الرواية أبدع به العتوم إبداعا كبيرا في وصف الحالة التي كان يمر بها الطبيب إياد أسعد، وأقتبسُ هنا "يا ابنتي.. ليس في الحياة أسوأ من غياب أبٍ حانٍ على أبنائه، غير أن الأفدح أن تكوني موجودة في حياتي ولا أكون موجودا في حياتك!! أن أعدّ كل ثانية تمرّ عليّ هنا من ملايين الثواني على أمل الخلاص.. الخلاص الذي سيجعلني أرى وجهك من جديد، ثم لا يكون لي في قلبك أيّ قبول.. وأنتهي أمام قدميكِ كورقة يابسة".
"استيقظتُ فجرا، بدت السماء من شق الباب كأنها تتخلى عن سوادها لأزرقها الفاتح، كانت ليلة أمس قد قدمتني إلى الموت الذي رفضني؛ هل يكون الموت متواطئا مع الجلادين؟!!".
في الفصول الأخيرة من الرواية حتى وإن كان بها شيء من الفرح بخروج الطبيب إياد أسعد من المعتقل بعد قرابة العقدين من الزمان، ويتجلى ذلك في التفاصيل الدقيقة التي أسردها العتوم خصوصا في رحلة الطبيب في أسواق تدمر ورؤيته للناس والمحلات التجارية؛ إلا أن مشاعر مختلطة بين الفرح والحزن والشفقة تنتاب القارئ في السطور الأخيرة من الرواية، نرى ذلك عندما وصل الطبيب إلى الحي وعلم بوفاة والدته، ثم انتظاره على باب بيته وسماع صوت ابنته لأول مرة منذ سنوات طويلة، ثم اللقاء أخيرا بزوجته وابنته وسماع الأذان بصوت ابنه أحمد، كل تلك المشاعر التي أبدع العتوم في وصفها تجعل القارئ يُنهي الرواية منهكا وكأنه انتهى من حرب دامية.
اقتباسات من الرواية:
- "اختلط الليل بالنهار، تداخلا ربما، سبق أحدهما الآخر.. ماذا يعني الليل والنهار لسجين صارت كل خليةٍ فيه مرتهنة للدولة، وهو لا يملك حتى أن يسحب هواء الزنزانة الخانق إلى صدره..؟! كان عليه أن يسترق ذلك، لأنه إن ضُبط بالجرم المشهود فسيحرّمون عليه هذا النفس من أن يدخل إلى جوارحه ولو بالإكراه فيما بعد..!!".
- "استيقظتُ فجرا، بدت السماء من شق الباب كأنها تتخلى عن سوادها لأزرقها الفاتح، كانت ليلة أمس قد قدمتني إلى الموت الذي رفضني؛ هل يكون الموت متواطئا مع الجلادين؟!!".
- "تختار الطيور أحيانا أعشاشها بغريزتها التي تقودها إلى الأمان النفسي والغذائي، وقد تغيرها بحثا عن الحياة والحب والسلام، فتهاجر جهة الجنوب.. أما نحن فقد كانت هجرتنا قسريةً جهة الشرق.. ولم يكن لنا من حق في الحياة ولا في الحب ولا في السلام.. وضعونا في أقفاص ذات جدران مصفحة وقادونا إلى حيث الموت والرعب والجنون والجحيم..!!".
- "راقبته.. مشى إلى المشنقة مقيد اليدين، واثقا هازئا.. أعرفه تماما، كان يمشي ساخرا من كل ما يحدث، غير عابئ بكل ما يجري من ترهيب وترعيب، غير مكترث لكل صيحات الجلادين التي تتوعد كل شيء تقع عينها عليه.. خطواته كانت واسعة كأنما يركل في طريقه كل خوف أو ذعر أو استجداء".
- "كم صار عمرك يا ابنتي؛ ست أو سبع سنين؟! نحن هنا لا نتقن عدّ الأعوام، هي تعدّنا، هي تأكلنا، هي تجترّنا بين أسنانها بهدوء، هي تحطم آمالنا، وهي تيبس ما اخضرّ منها".
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.